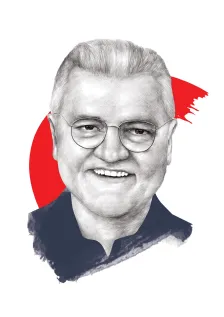قدر الترجمة السقوط في هاوية مفارقة اللغة، فاللغة هي السمة التي تجمع البشر وتفرّقهم في آن واحد. في نهاية القرن السابع عشر تساءل عالم اللغة الألماني"هومبلدت": لماذا كل هذه اللغات؟ لماذا كل هذا التشتت؟ وردّ على هذا السؤال موضحا أنّ كل لغة تمثل جزءا من لغة كونية، وأضاف إلى ذلك فكرة سيتبناها "والتر بنجامين" لاحقا، وهي أننا قد نتخيل مجموع اللغات كأنه موشور متعدّد الوجوه، يُظهِر كل وجه منه العالم بلون مختلف. كيف نجمعإذن بين اختلاف اللغة وكونيتها؟ يقول "هومبلدت" من خلال الترجمة تلك المهمة المكتوب عليها بالفشل، لكنها رغم ذلك"المهمة الأكثر ضرورية، لأنها تنقل لمن لا يعرف اللغة الأجنبية تلك الأشكال من الفن والإنسانية التي قد تظل مجهولة لولا فعل الترجمة، والتي دائما تأتي في مصلحة كل الأمم لأنها تعزز القدرة التعبيرية وتزيد من أهمية كل اللغات معا".
أظن أن هذا ما تفعله الترجمة: إنها تبدع المفاهيم، فاللقاء بين عوامل كثيرة وأكوان معرفية كثيرة يؤدي إلى إبداع أشياء جديدة غير متوقعة. الترجمة إذن تفكير في اللغة وفلسفة متجسّدة تنير أجزاء من العالم لا حياة ولا تاريخ لها ولا شعور بها إلا بفعل الترجمة. فالترجمة تعيد إبداع الثقافات وتشكيل الهويات. وتاريخ الترجمة هو تاريخ تلك التحولات والتغيرات التي تؤدي دائما إلى إعادة التفكير في العالم حولنا.
تتعلق مسألة الترجمة إذن بهويتنا وبوجودنا في العالم، لأنها آلية الدخول في علاقة مع الواقع. تناقض الترجمة عنف أيّ فكرة تحاول أن تخضع العلاقة مع الآخر للشمولية التي تسعى إلى فرض التشابه التام أو الإنكار التام للاختلاف بين الكائن والكينونة،والترجمة آلية مقاومة الرغبة المغرية في محو التناقضات بدلا من إبرازها، كما قال الفيلسوف الألماني "أدورنو".
الترجمة تفكير في اللغة وفلسفة متجسّدة تنير أجزاء من العالم لا حياة ولا تاريخ لها ولا شعور بها إلا بفعل الترجمة. فالترجمة تعيد إبداع الثقافات وتشكيل الهويات. وتاريخ الترجمة هو تاريخ تلك التحولات والتغيرات التي تؤدي دائما إلى إعادة التفكير في العالم حولنا
الترجمة نموذج للمعرفة يتعارض مع كل تلك الفلسفات التي ترى أنّ الواقع مشتق من مبدأ ما. هي المجال الذي يقف فيه المرء مع أو ضد الأفكار الشمولية عن الواقع، تلك التي تحاول أن تختزل الآخر إلى الحدود التي نضعها له. اللقاء مع الآخر في سياق الترجمة يتمثل في اللقاء بين اللغة المصدر واللغة الهدف، وبذلك هو مثل اللقاء بين الأنا والآخر. ولكن، في فعل الترجمة تشك الأنا في ذاتها أمام الآخر وتستجيب لندائه.
كان الفيلسوف الفرنسي "ليفيناس" أول من طرح موضوع اللقاء مع الآخر خارج أي منطق ثنائي، من خلال ما سماه " اللقاء وجها لوجه"، حيث أصبح اللقاء شيئا ملموسا وأخذ شكل الوجه؛ وجه يأتي من خارج أفقي المعرفي ويقتحم عالمي بهذه الصيغة الإنسانية المألوفة. وجه يدعوني إلى أن أكون مسؤولا ويحدثني عن عمق معنى الغيرية وعلاقتي بها. فالآخر يتجلّى في صورة ذلك الوجه الإنساني المألوف تماما لي والمختلف تماما عني، وبهذا يتجاوز لقائي مع وجه الآخر كل الأيديولوجيات والأفكار المجردة التي تعتبر وجود المشترك الإنساني أمرا بديهيا. وجود الوجه يشهد بأن وجود الآخر غير ثابت، غير عائد إلى فكرتي عن الآخر، لذلك يضع هويتي موضع الشك.
هذه المفارقة التي تحكم على العلاقة بيت غريبين وتضعهما أحدهما أمام الآخر بكل تشابههما واختلافهما، هذه العلاقة هي ما يحدث في كل ترجمة وفي كل لقاء. "ليفيناس" يعبر عن هذه الفكرة بوضوح عندما يكتب أن الآخر ليس غائبا ولا مستوعبا، بل قريبا جارا. أرى أن هذا تعريف جيد لفعل الترجمة: إنها علاقة جيرة رغم المسافة الفاصلة. يتجه الآخر نحوي من خلال المسافة التي تفصلنا ويقف أمامي، وجهه في وجهي، ووجهه هو برهان اختلافنا القائم رغما عن قربنا.