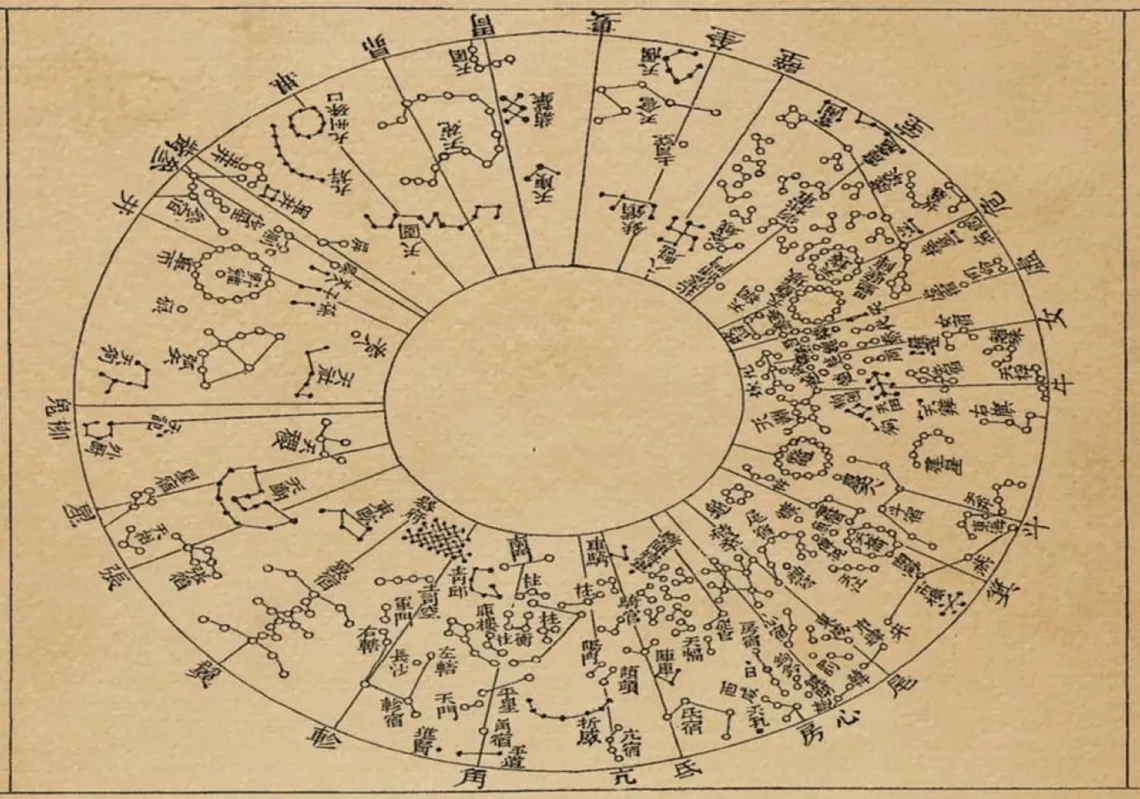قبل آلاف السنين، وفي أرض تضاء بشمس صعيد مصر القاسية، عاش رجل مصري في قلب وادي النيل، في زمن لم يكن فيه شيء مألوف بعد. لا أهرامات، ولا مجد إمبراطوري وُلد، بل كانت مصر لا تزال تشق طريقها نحو الفراعنة العظام.
كان ذلك الرجل يعيش على ضفاف النهر العظيم في المدينة التي تُعرف اليوم باسم النويرات وتقع بالقرب من موقع بني حسن الأثري المصري، حيث الأرض خصبة، والناس يحرثونها بأيد خشنة وبإيمان لا يتزعزع بأن الحياة هنا تستحق العناء.
كان رجلا بالغا، قوي البنية، يعمل بجسده حتى تآكلت مفاصله، وانهكت عظامه، وتآكلت أسنانه من قسوة الطعام والعمل. عاش حياة طويلة نسبيا لزمنه — ربما بلغ الستين — وهو إنجاز في حد ذاته. كان على الأرجح حرفيا، يعمل في صناعة الفخار أو ربما في تصميم المقابر، يكد من شروق الشمس إلى غروبها، في مجتمع بدأ يتشكل فيه معنى التنظيم المركزي والدولة.
ربما حمل جسده علامات شقاء يومي مستمر، لكنها لم تمنعه من نيل مكانة اجتماعية تحترم، إذ دفن في جرة فخارية ضخمة داخل قبر منحوت في الصخر، دفنا لا يُمنح إلا لمن لهم شأن.
لم يكن يعلم أن جسده، بعد موته، سيبقى محفوظا لآلاف الأعوام، ولم يكن يتخيل أن علماء من عالم مستقبلي سيعودون إلى عظامه، يستخرجون من نخاع أسنانه شفرته الوراثية، ويقرأون منها قصة لا صوت لها. فقد كان الرجل إنسانا بسيطا في عصر مليء بالبدايات؛ عاش ومات على هامش التاريخ المكتوب، لكنه الآن في صميم دراسة ستعيد رسم خريطة أصول المصريين القدماء.
فللمرة الأولى، تمكن فريق علمي دولي من إجراء تسلسل جينومي كامل لبقايا إنسان مصري عاش في فترة مبكرة من تاريخ مصر الفرعونية، وتحديدا بين عامي 2855 و2570 قبل الميلاد، أي في زمن يربط بين عصر التوحيد السياسي لمصر وبداية الدولة القديمة.

ووفقا للدراسة المنشورة في دورية "نيتشر" فإن النتائج تكشف عن مزيج غير متوقع من الأصول الجينية. فمعظم التركيب الوراثي لهذا الفرد ينتمي إلى شمال أفريقيا في العصر الحجري الحديث، ولكن ما يقرب من 20% منه يعود إلى أصول من الهلال الخصيب الشرقي، بما في ذلك بلاد ما بين النهرين (العراق الحديث) ومناطق قريبة منها.
التسلسل الجينومي
التسلسل الجينومي عملية تحليلية دقيقة تهدف إلى فك الشيفرة الوراثية الكاملة لأي كائن حي، وذلك من خلال تحديد الترتيب المتسلسل للوحدات الكيميائية التي تشكل الحمض النووي الذي يعد بمثابة "كتاب التعليمات" الذي يحدد ملامح الكائن، وصفاته الوراثية، وأصوله البيولوجية.
تسمح هذه العملية بقراءة الجينوم – أي مجموعة الجينات الكاملة – وفهم كيفية عمله، مما يتيح الكشف عن السمات الجسدية المحتملة، والأمراض الوراثية، وأنماط التكيف البيئي، وكذلك العلاقات الجينية بين الأفراد والمجموعات السكانية المختلفة.