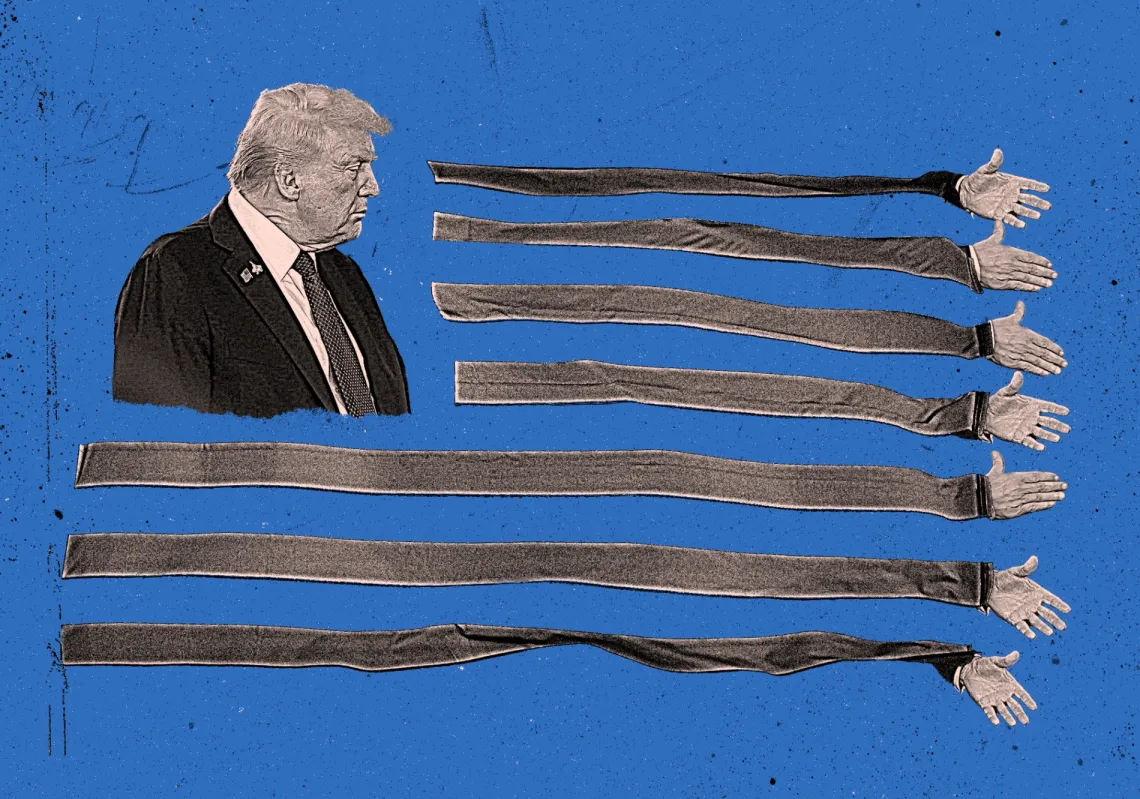* اقترح الشيخ أبو الحسن الغنيمي اختصار اسم الحركة المصرية للتحرر الوطني إلى (ح.م), وسعد بذلك هنري كورييل, وقال: هذا مدعاة لجذب المسلمين إلى تنظيمنا الشيوعي
* مدارس الليسية الفرنسية كانت مركزاً للعناصر المعادية للفاشية، وبين هؤلاء وجد مدرسون شيوعيون, لهذا اعتنق بعض أبناء الجاليات الأجنبية وبعض أبناء الأرستقراطية المصرية, الشيوعية.
* لا يعد في المنتصف الأول وجود أزهريين في التنظيمات الشيوعية أمراً مستنكراً إلا عند من يحكم على روح تلك الفترة بمقاييس عقود تالية.
* لم تكن في مصر ولا بقية البلاد العربية إذا استثنينا السعودية, فوبيا الشيوعية. فهذا الفوبيا انتقلت إلى العالم العربي من أمريكا في أواخر السبعينيات، وتضخمت في سنوات الثمانينيات.
الرياض: شهدت الحركة الشيوعية في العالم العربي في المنتصف الأخير من القرن الماضي تجارب في الخروج عليها من بعض قادتها ومثقفيها وكوادرها, وكان أول كتاب قدم شهادة عليها – وكانت شهادة مؤذية – هو كتاب قدري قلعجي الشهير ( تجربة عربي في الحزب الشيوعي) , وقد لقي هذا الكتاب منذ طبعته الأولى إقبالاً كبيراً ورواجاً عظيماً, فتعددت طبعاته.
ومع هذا الإقبال عليه والرواج له لا أعرف كتاباً ردَّ على هذا الكتاب أو تضمن تعليقاً على ما جاء فيه سوى تعليق تضمنه مقال (مشكلات الحزبين الشيوعيين في سوريا ومصر) للمستشرق الفرنسي الماركسي مكسيم رودنسون المنشور ضمن مقالات أخرى له في كتابه: (الماركسية والعالم العربي).
هذا التعليق أبداه في ذلك المقال حين حديثه عن شخصية خالد بكداش, الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني السوري. تعليقه هو عبارة عن مرافعة عاطفية حميمة مفعمة بود شخصي وإعجاب كبير في قيادة مبنية على الطراز الستاليني, كقيادة خالد بكداش. وهي إلى ذلك كانت مرافعة حذقة, فهو قد انطلق فيها من الإقرار بصحة ما قاله قدري قلعجي عن خالد بكداش في المجمل, لكن مع التنبيه إلى أن سلسلة النوادر التي رواها عنه, تؤدي مراكمتها بأسلوب أحادي الجانب إلى إعطاء فكرة خاطئة عن الرجل.
ولأنه كان يرى أن قلعجي قد فعل هذا, فلقد قدم صورة أخرى عن بكداش, كان يعتقد أنها تعطي فكرة صحيحة عنه, لاعتمادها – كما ظن - على أسلوب غير أحادي الجانب، واتكائها على تفسيرات مغايرة لبعض وقائع عددها قلعجي, تدين بكداش, رأى أنها تبرئه أو على الأقل تقف بنا على تفهم دوافعها وأسبابها.
وفي واقع الأمر أن الصورة التي جهد رودنسون أن يحسنها لا تعطي فكرة صحيحة عن بكداش, وأن الأسلوب الذي اعتمده لم يكن أفقه متعدداً وواسعاً, وتفسيراته لم تكن مقنعة, وإنما كان الأسلوب وكانت التفسيرات مثقلة بالتسويغ. ولا عجب في ذلك فمكسيم رودنسون في تلك الفترة كان ستاليني الهوى.
ولنفوذ الشيوعيين واليساريين في حقل الأدب والثقافة تأثر بنظرتهم التحقيرية إلى الأعمال التي يحكي أصحابها عن تجربتهم الشيوعية السابقة أو التي ينقدون فيها الشيوعية أو اليسار بعد تحولهم عنها –سواء أكانت هذه الأعمال كتباً أم مقالات– مثقفون هم غير شيوعيين وغير يساريين.
تستند تلك النظرة التحقيرية إلى اتهامين أساسيين: الأول, هو أن صاحب التجربة وصاحب النقد يبيع نفسه للأنظمة السياسية اليمينية الرجعية المعادية للتقدم. والآخر أنه يتاجر بتجربته وبنقده عند القارئ. وكان هذان الاتهامان يكتسبان قيمة في وقت كان الصراع فيه بين اليمين واليسار في السياسة والثقافة على أشده وفي ذروته.
كان الشيخ الأزهري صفوان أبو الفتح من زعماء الحزب الشيوعي المصري القديم وقد حكم عليه وزعماء آخرين في عهد حكومة سعد زغلول سنة 1974م, بالسجن ثلاث سنوات.
قد يكون هذان الاتهامان صحيحين من حيث الحدوث والإمكان, فأي تجربة عقدية مذهبية أو سياسية هي قابلة للشراء والبيع ولكل ضروب الاتجار والمتاجرة, لكن سوأتهما أنهما كان ينطويان على تعميم جارف وإطلاق ظالم, فليس كل من روى تجربته مع الشيوعية ونقدها ونقد اليسار ينطبق عليه - بالضرورة – هذان الاتهامان أو أحدهما.
[caption id="attachment_55260034" align="alignleft" width="262"]
 محمد البهي[/caption]
محمد البهي[/caption]
إن ما وراء هذين الاتهامين الأخلاقويين كان إرهاب المثقفين المتحولين عن الشيوعية وعن اليسار؛ كي لا يسجلوا تجربتهم مع الشيوعية، أو يتجهوا في بعض أعمالهم إلى نقد الشيوعية ونقد اليسار.
ولقد أصابت الشيوعية واليسار –والحديث هو عن العالم العربي - بعض النجاح في إرهابها هذا, فظل سيف هذين الاتهامين مصلتاً على رقاب المتحولين عن الشيوعية وعن اليسار. وهذا سبب امتناع بعض هؤلاء في فترة ماضية عن نقد الشيوعية واليسار, إذ كانوا يرهبون أن يطال سيف ذلك الاتهامين عنق شرفهم الأخلاقي!
ولأنهم تورعوا عن الوقوع في ما هو (منهي عنه) وما هو (آثم) ومحظور و(محرم) عند رفاقهم السابقين, كان لا ينالهم منهم هجوم أو غمز أو لمز, والاختلاف معهم إن حصل, يعبر عنه بطريقة مهذبة محوطة بالتقدير والاحترام لأشخاصهم.
والأهم من ذلك أنهم نجوا من قذفهم بتهمة شنيعة عندهم, ذات وقع ديني مرعب ألا وهي – أجارنا الله – الردة! وللفائدة الفقهية (أو الشرعية أو القانونية) أشير إلى أنه عند الطائفتين الكريمتين – الطائفة الكريمة تعبير لبناني (خاص) , يستخدمه المتحدث إزاء الطائفة التي لا ينتمي إليها, وأرى أنه لا حرج علمانياً من (تعميمه) بلدانياً وفي المجال غير الديني- الشيوعية واليسار ردتان: ردة مستورة مستوعبة وهي التي تمالئ الرفاق السابقين, وردة فاضحة وفاجرة, وهي التي لا تمالئهم, بل تجابههم.
الشيوعي الذي اهتدى
مع نهايات القرن الماضي, وعلى وجه التحديد سنة 1983 صدر كتاب في السودان عنوانه ( ومشيناها خطى: صفحات من مذكرات شيوعي اهتدى) لأحمد سليمان عن دار الفكر, ثم أتبعه بجزء ثان صدر سنة 1986 عن دار القلم بالكويت، وعن دار الفكر بالسودان.
أحمد سليمان كانت مهنته المحاماة, وكان من مؤسسي الحزب الشيوعي السوداني تولى منصب وزير في أربع وزارات هي: الزراعة والاقتصاد والصناعة والعدل, ابتداء من سنة 1964, ثم تولى العمل سفيراً للسودان في موسكو ولندن ونيجيريا وواشنطن . عمل بعدها مندوباً للسودان في هيئة الأمم المتحدة، وكان قد فصل من عضوية الحزب الشيوعي هو وأحد عشر عضواً سنة 1970.
في تجربة قدري قلعجي التي رواها كان قد تحول من الشيوعية إلى القومية العربية, أما أحمد سليمان في الوقت الذي روى تجربته كان قد تحول من الشيوعية إلى اتجاه إسلامي.
لم ينل كتاب أحمد سليمان بجزأيه ذيوعاً في العالم العربي, رغم أن الكتاب بجزأيه حفل بمعلومات طريفة، وتضمن إضاءات مهمة حول تاريخ الحركة الشيوعية في مصر والسودان. فالمعرفة به اقتصرت على المثقفين السودانيين والمعنيين بالشأن الحزبي وتاريخه في السودان.
إنك إن تذكر عنوان الكتاب (ومشيناها خطى) لأحد المثقفين فسينصرف ذهنه فوراً إلى كتاب صدر منذ سنوات قريبة, هو (مشيناها خطى – سيرة ذاتية ) للمؤرخ والأكاديمي اليساري رؤوف عباس.
هذا العنوان منتزع من فاتحة بيتين شعريين شهيرين, يترددان على الألسنة كثيراً, هما:
مشيناها خطى كتبت علينا
ومن كتبت عليه خطى مشاها
ومن كتبت منيته بأرض
فليس يموت في أرض سواها
وقد استهوت هذه الفاتحة المنتزعة أحمد سليمان, ومن بعده رؤوف عباس, ليتخذانها عنوانا لسيرتهما الذاتية. واستهوت من بعدهما حامد عمار شيخ التربويين العرب, ليجعلها عنواناً لسيرته الذاتية – مع بعض التحوير –, الموسومة بـ (خطى اجتزناها...) وقبلهم جميعاً راقت للأديب والصحافي المصري عباس خضر ليضعها عنواناً لكتاب له يدنو من السيرة الذاتية, هذا الكتاب هو: (خطى مشيناها).
من المعلومات الطريفة التي حفل بها كتاب أحمد سليمان معلومة غير معروفة وكانت مفاجئة, وهي أن المفكر الإسلامي محمد البهي كان من ضمن الأزهريين الذين يحضرون مدرسة الكادر الشيوعية!
أورد أحمد سليمان هذه المعلومة في الجزء الثاني من كتابه على لسان عبده دهب, وعبده دهب هو اسم الشهرة، أما اسمه الكامل فهو عبد اللطيف دهب حسنين. هو سوداني نوبي مقيم في مصر, كان كادراً شيوعياً نشطاً، وهو مرجع شفاهي لتاريخ الحركة الشيوعية في مصر والسودان. رحّلته السلطة المصرية إلى بلده سنة 1950م.
[caption id="attachment_55260032" align="alignleft" width="297"]
 هنري كورييل[/caption]
هنري كورييل[/caption]
عبده دهب كان مقرباً من هنري كورييل ولصيقاً به. وهنري كورييل كان أبرز قيادي في التنظيمات الشيوعية في مصر. وهو مؤسس إحدى تنظيماتها: الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح. م أو حمتو) سنة 1943 وكان له إسهام في تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو) التي تغير اسمها فيما بعد إلى الحزب الشيوعي السوداني. وتولى منصب سكرتير عام الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) عند تأسيسها سنة 1947, وهي اندماج بين الحركة المصرية للتحرر الوطني التي أسسها هو وتولى قيادتها وبين تنظيم ايسكرا (الشرارة) التي أسسها وقادها هيلل (يرسم المصريون اسمه بهذه الطريقة: (هليل). وهيلل اسم يهودي توراتي) شوارتز ابتداء من سنة 1943. ولقد ظل كورييل قائداً لهذه الحركة الموحدة (حدتو) إلى أن طرد من مصر سنة 1950. ومع إنشاء (مجموعة روما) في باريس التي تكونت من هنري كورييل وثلة من الشيوعيين المصريين الذين بعد أن خرجوا من السجن سنة 1949م, ذهبوا إلى إسرائيل ثم غادروها بعد فترة إلى الاستقرار في باريس, استأنف هنري كورييل نشاطه في حدتو عبر هذه المجموعة من موقع الموجه لحدتو وللحزب الشيوعي السوداني أيضاً. اغتيل هنري كورييل وهو يهم بمغادرة مصعد العمارة التي يسكن فيها في 4 مايو سنة 1978م. لمزيد من المعلومات عن (مجموعة روما), راجع تقديم رؤوف عباس لكتاب (أوراق هنري كورييل والحركة الشيوعية المصرية).
حاولت مذ عرفت تلك المعلومة عن محمد البهي أن أتتبع أثرها في كتابات الإسلاميين وفي كتابات الشيوعيين المصريين وفي كتابات المصريين عامة, فلم أعثر على أية إشارة لها.
لنقف عند الفقرة التي وردت فيها تلك المعلومة المهملة . يقول أحمد سليمان: " كان كورييل يعتز كثيراً بوجود الشيخ أبو الحسن بين ظهراني تنظيمهم, ويدفعه إلى محاولة تطويع دين الله لأغراضهم الدنيوية. وكان أن ألف الشيخ كتاباً عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري وصفه بأنه أول ثائر في الإسلام. ولم يكن الشيخ الغنيمي هو الوحيد بين الأزهريين الذين حضروا مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية, فقد كان هناك عالم أزهري آخر يقول عبده دهب أنه صار في سنين لاحقة شيخاً للأزهر هو الإمام الأكبر البهي، وكان يسكن في شقة تقع مباشرة تحت مجلة الجماهير بشارع الجامع الإسماعيلي بالقرب من لاظوغلي".
تحتاج هذه الفقرة –ونحن نحاول التحقق من صحة تلك المعلومة– إلى تصحيح وإلى إيضاحات.
تصحيحات وإيضاحات
التصحيح هو أن محمد البهي لم يكن شيخاً للأزهر، ولا كان هو الإمام الأكبر, وإنما كان مديراً لجامعة الأزهر مرتين، وما بينهما كان وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر. وقد اختلط هذا الأمر على عبده دهب ومعه ناقل روايته أحمد سليمان, للأسباب التالية:
أولها: أن البهي تولى هذه المناصب في سنوات متصلة قصيرة, هي مطلع الستينيات. ثانيها: أن منصب مدير جامعة الأزهر الذي تولاه للمرة الأولى سنة 1961 كان منصباً مستحدثاً. ثالثها: أن هذا المنصب المستحدث ضمن القانون الخاص بتطوير الأزهر, استحدث فيه لقب الإمام الأكبر ليطلق على شيخ جامع الأزهر .
إنه من الواضح أن عبده دهب ومعه أحمد سليمان كان يخلطان ما بين منصب مدير جامعة الأزهر الجديد ومنصب شيخ جامع الأزهر العتيق. ونذكر هنا أن لقب "شيخ جامع الأزهر" مع صدور قانون تطوير الأزهر سنة 1961 اختصر ليصبح "شيخ الأزهر".
أما الإيضاحات, فهي على النحو التالي:
-الشيخ أبو الحسن هو محمد أبو الحسن جاد الله الغنيمي حاصل على شهادة العالمية من كلية أصول الدين، ودرس في قسم التخصص بكلية اللغة العربية الذي يؤهل الطالب للتدريس. بعد إنهائه الدراسة في قسم التخصص الذي مدته ثلاث سنوات عمل مدرساً للغة العربية في مدارس الليسيه الفرنسية.
كان الشيخ أبو الحسن الغنيمي عضواً في الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح.م) واختصار اسم الحركة المصرية للتحرر الوطني بـ (ح .م) وليس بـ (حمتو) كما يقتضي ذلك أوائل حروف اسمها, جاء – بحسب ما قال أحمد سليمان نقلاً عن عبده دهب – بناءً على اقتراحه. فـ "الشيخ أبو الحسن الغنيمي قال إن هذا الرمز (ح . م) لفظ قرآني, وكان يشير بذلك إلى بعض سور القرآن الكريم. وقد سعد كورييل بقول الشيخ الأزهري وقال إن ذلك ربما كان ذلك مدعاة لجذب المسلمين إلى التنظيم الذي ورد ذكره في القرآن"!
عند توحد الحركة المصرية للتحرر الوطني مع تنظيم ايسكرا في حركة واحدة, هي (حدتو) كان في الأولى اثنان وعشرون شيخاً, وفي الأخرى شيخان فقط!
كما أن الشيخ أبو الحسن الغنيمي كان من ضمن مائة شيوعي اعتقلتهم الشرطة, ومن ضمن العشرين الذين أبقتهم النيابة العامة للتحقيق في الحملة التي شنها رئيس الوزراء إسماعيل صدقي باشا باسم " قضية الشيوعية الكبرى" سنة 1946, ثم حكم ببراءتهم بعد فترة قصيرة.
استند اتهام الشيخ أبو الحسن الغنيمي بالشيوعية في هذه القضية إلى كتابين صدرا أو وزعا بطريقة سرية خلال ذلك العام, وهما: (الشيوعية في الإسلام) و(دورنا في الكفاح الوطني). ففي الكتاب الأول اتهم أنه حبذ الشيوعية، ودعا إلى إلغاء الملكية الفردية زاعماً أن هذا نظام أقره الإسلام. وفي الكتاب الثاني اتهم أنه أظهر فيه إعجابه بالماركسية وحبذ الشيوعية والكفاح في سبيلها. (راجع حيثيات الحكم عليه وعلى تسعة عشر آخرين ودفوعاته ودفوعاتهم في كتاب رفعت السعيد: تاريخ المنظمات اليسارية المصرية 1940 – 1950).
وللشيخ كتاب ثالث وهو الذي أشار إليه أحمد سليمان, وعنوانه (أبو ذر أول ثائر في الإسلام), وهذا الكتاب كتاب مجهول. فالمعروف هو كتاب قدري قلعجي الذي ألفه بالعنوان نفسه حينما كان شيوعياً, وصدرت طبعته الأولى سنة 1947, من دون إشارة لتاريخ صدوره.
إن تدريس الشيخ أبو الحسن في مدارس الليسية لم يأت اعتباطاً, فهو ذو مغزى. يفسر هذا المغزى مناضل شيوعي من أعضاء تنظيم ايسكر (الشرارة) وتنظيمات شيوعية لاحقة, هو الكاتب والمفكر السياسي محمد سيد أحمد في إجابة له عن سؤال موضوعه هو: لماذا بدأ نشاط ايسكرا في مدارس الليسية الفرنسية التي يدرس فيها أبناء الجاليات الأجنبية، وبعض أبناء الأرستقراطية المصرية الذي هو أحدهم؟
يقول محمد سيد أحمد (سليل أسرة اقطاعية أرستقراطية وممن درسوا في مدارس الليسية الفرنسية ومن المفارقات أنه يمت إلى إسماعيل صدقي باشا عدو الشيوعيين المصريين الأول بصلة قرابة من جهتين: الأولى, أن عدو الشيوعيين المصريين الأول هو ابن عم أبيه الباشا. والأخرى, أنه زوج عمته!) في إجابته: "كانت مدارس الليسية مصدراً للثقافة الماركسية, فقد كانت مركزاً للعناصر المعادية للفاشية، وبين هؤلاء وجد مدرسون شيوعيون من أعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي. وكان هناك أيضاً ناد لخريجي الليسية علني. وقد تواجدت ايسكرا في إطار ذلك كله". محضر نقاش أجرته الباحثة الأمريكية سيلما بوتمان معه باللغة الإنكليزية في 13/12/1979. وترجم إجابته إلى العربية وأثبتها رفعت السعيد في كتابه: (تاريخ المنظمات اليسارية المصرية 1940 – 1950).
-مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية: دانييل كورييل والد هنري, ثري يهودي كفيف يحمل الجنسية الإيطالية. وكان يملك ويدير مصرفاً. وكانت له أملاك زراعية كبرى، ومن هذه الأملاك عزبة في المنصورية, والمنصورية ضاحية بالجيزة.
وكان دانييل كورييل كلف ابنه هنري بإدارة شؤون هذه العزبة. ولقد استغل الابن هذا التكليف للتردد بحرية على العزبة ولتكون مكاناً آمناً بعيداً عن عيون الأمن لتأهيل وتثقيف عشرين متدرجاً بمبادئ الماركسية بإلقاء محاضرات عليهم.
وكان من ضمن المتدرجين الشيخ الغنيمي وعبده دهب. وقام بإلقاء محاضرات عليهم كل من: هنري كورييل جو ماتلون وداود ناحوم ومحمد زكي هاشم وأحمد الدمرداش التوني وطاهر المصري وموسى عبدالحفيظ وتحسين المصري. وشارك فيها من لبنان فرج الله الحلو، ومن العراق الدكتور هيبه.
ومدرسة الكادر الشيوعية التي أنشأها هنري كورييل مرحلة سبقت بأشهر صياغته لاسم التنظيم الذي يقوده. وأعني بالاسم, الحركة المصرية للتحرر الوطني.
-مجلة (الجماهير): أسس هذه المجلة تنظيم ايسكرا في شهر أبريل سنة 1947 وكانت هذه المجلة تعبر عن هذا التنظيم في شهري أبريل وشهر مايو- كما يذكر ذلك رفعت السعيد استناداً إلى عبده دهب – لكن بعد توحده مع الحركة المصرية للتحرر الوطني في حركة واحدة هو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) غدت المجلة مملوكة لهذه الحركة الموحدة ولسانها المعبر عنها.
يمكن الآن بعد ذلك التصحيح وهذه الإيضاحات مناقشة المعلومة المجهولة والمفاجئة التي أوردها أحمد سليمان على لسان عبده دهب عن المفكر الإسلامي الدكتور محمد البهي، والتي قالت أنه كان من ضمن الأزهريين الذين يحضرون مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية.
قال عبده دهب – كما نقل عنه أحمد سليمان – عن البهي: أنه كان يسكن في شقة تقع مباشرة تحت مجلة (الجماهير) بشارع الجامع الإسماعيلي بالقرب من لاظوغلي.
نتيجة لتركيز هنري كورييل على استقطاب الأزهريين أنشأ في حركته الشيوعية قسماً اسمه لجنة قسم الأزهر وجمعية اسمها جمعية الدعاية للحج.
أفادته هذا يجب أن نفهمها على أنها تأكيد لمعرفته الشخصية بمحمد البهي, لا إنه يشير بها إلى الخيط الذي وصل الأخير بالتعرف على الشيوعيين.
ذلك أن مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية أنشأها هنري كورييل – بحسب ما قاله لرفعت السعيد – في شهر يناير سنة 1943 واستمرت بضع شهور خلال ذلك العام, ومجلة (الجماهير) التي عمل فيها عبده دهب في قسم التوزيع انتقل مقرها الجديد – كما يذكر رفعت في كتابه : ( الصحافة اليسارية في مصر 1925 -1948 )- إلى 22 شارع الجامع الإسماعيلي, ابتداء من العدد رقم 15 بعيد شهر يونيو سنة 1947.
أي أنها انتقلت إلى مقرها الجديد في 22 شارع الجامع الإسماعيلي في شقة تعلو مباشرة الشقة التي يسكن فيها البهي, بعد اندماج تنظيمي ايسكرا (الشرارة), والحركة المصرية للتحرر الوطني (ح. م أوحمتو) في تنظيم واحد, وبعد مضي ما يقرب من أربع سنوات على انتهاء مهمة مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية. وعبده دهب نفسه نص على أن البهي كان ممن يحضرون مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية, ولم يقل أنه كان معهم في الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح.م) وهي المرحلة التي تلت مرحلة الكادر الشيوعية بالمنصورية مباشرة.
ونستخلص من تلك المعلومات السابقة أن تجاور شقة مجلة (الجماهير) الشيوعية مع شقة محمد البهي لم يكن أكثر من مصادفة, وربما أن هذه المصادفة جعلت عبده دهب يعرف عنوان سكن البهي. هذا إن كان في الأصل لا يعرفه حينما كان البهي – كما قال – يحضر مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية.
هنري كورييل والأزهر والأزاهرة
في شهر يناير/ كانون الثاني سنة 1943, وهو التاريخ الذي بدأ فيه نشاط مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية, كان محمد البهي أستاذاً بكلية أصول الدين يدرس الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإغريقية، ويدرس علم النفس في قسم تخصص التدريس, وكان مضى على عودته إلى مصر من ألمانيا أربع سنوات وخمسة أشهر, فهو قد عاد منها في شهر أغسطس سنة 1939. وكان قد تحصل على الدكتوراه بدرجة امتياز في الفلسفة وعلم النفس من جامعة هامبورج في شهر مايو سنة 1936, كما حصل على دبلوم بدرجة امتياز في اللغة الألمانية وآدابها, وسمح له شيخ الأزهر مصطفى المراغي بالتقدم إلى الحصول على درجة الأستاذية بعد الدكتوراه من جامعة هامبورج. ومع ظهور نذر الحرب العالمية الثانية عاد إلى مصر قبل أن يحصل على درجة الأستاذية من تلك الجامعة الألمانية.
وفي الأربعينيات وقبلها إلى سنة 1961 كان التعليم العالي في الأزهر عبارة عن ثلاث كليات هي: كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية, وقسم التخصص المقسمة الدراسة فيه إلى شعب هي: الفقه والأصول, والتفسير والحديث, والبلاغة والأدب, والنحو والصرف, والتوحيد , والمنطق , والتاريخ, وكانت هذه الكليات الثلاث, وكان هذا القسم يتبع كلية اللغة العربية في الإدارة.
وإضافة إلى القسم العالي كان هناك قسمان: تعليم ابتدائي وتعليم ثانوي.
هنري كورييل بخلاف صنوه هيلل شوارتز ركز على استقطاب الطلبة الأزهريين لإزالة عقبة الدين أمام الاشتراكية وأمام الشيوعية، وليخترق بهم الريف المصري الذي تشكل مساحته المساحة الكبرى في مصر. وكان أغلب طلبة الأزهر قادمين من هذا الريف, وظرفهم الاقتصادي والاجتماعي البائس كان يهيئ بعضهم لقبول الدعوة إلى الاشتراكية والشيوعية.
ونتيجة لهذا التركيز حصل ما يلي:
-في مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية والذي بلغ عدد المنضمين إليها خمسة وعشرين متدرجاً كان من بينهم أزاهرة، وقد توصل رفعت إلى تسعة أسماء من هؤلاء الخمسة وعشرين متدرجاً, وكان من ضمن الأسماء التسعة اسمان لشيخين أزهريين , هما: عبدالرحمن الثقفي وكمال ... الذي لم يتمكن من الوصول إلى اسمه الأخير. ومن الأزاهرة أيضاً الشيخ الغنيمي الذي ذكر أحمد سليمان – كما مر بنا سابقاً – أنه من أعضاء مدرسة الكادر.
ونعرف من هنري كورييل بواسطة رفعت السعيد أن الشيخين عبدالرحمن وكمال كانا من مجموعة طلبة الكادر الذين صعدوا إلى عضوية الحركة المصرية للتحرر الوطني في تشكيلها الجديد.
-إنشاء خلية شيوعية في كلية الشريعة، وفي كلية أصول الدين، وفي كلية اللغة العربية، وفي معهد القاهرة الديني، والتي كان الطالب الأزهري مبارك عبده فضل برغم فصله من الأزهر بتهمة الشيوعية يتسلق السور, ليتواصل مع الطلبة أعضاء تلك الخلايا.
وكان مبارك عبده فضل المصري النوبي قد اعتنق الشيوعية في أثناء انتقاله من الثالثة إلى الرابعة ابتدائي في معهد القاهرة الديني عن طريق زميل له مصري نوبي يسبقه في الدراسة بسنتين, يدرس في المرحلة الثانوية في ذلك المعهد, اسمه محمد عثمان نور.
وقد صار مبارك عبده فضل عضواً في الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح.م ) قبل سنة من انتقاله من الابتدائي إلى الثانوي، وفصل من الأزهر بتهمة الشيوعية, وهو ما يزال طالباً في المرحلة الثانوية.
-عند توحد الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح.م) مع تنظيم ايسكرا (الشرارة) في حركة واحدة هي حدتو سنة 1947, كان في الأولى – كما ذكر ذلك مبارك عبده فضل لرفعت السعيد – اثنان وعشرون عضواً مقسمين على خلايا في كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وفي معهد القاهرة الديني.
كان الشيخ سعاد جلال – وهو من شيوعي الأربعينيات – يلقب بالشيخ الأحمر إلى أن زاحم هذا اللقب لقب آخر, وهو الشيخ "ستلاّ" !.
وهذا ما جعل هنري كورييل قبل التوحد ينشئ في حركته قسماً اسمه لجنة قسم الأزهر، وجمعية اسمها جمعية الدعاية للحج.
في حين أن تنظيم ايسكرا (الشرارة) عند التوحد – كما ذكر المصدر نفسه – كان يضم في عضويته شيخين أزهريين فقط!
ومما يلفت النظر في " قضية الشيوعية الكبرى " أن المتهم الرابع الشيخ أبو الحسن الغنيمي كان من مسوغات تبرئة النيابة له من تهمة الترويج للشيوعية, الاستناد إلى شهادة تقدم بها الدكتور مظهر سعيد الأستاذ بكلية أصول الدين وقسم التخصص بالأزهر لصالحه، إذ قال إنه يعرف المتهم معرفة تامة, وأنه بعيد عن الشيوعية، بل إنه كان يحارب المبادئ الهدامة (المقصود بها الشيوعية).
وقال: إنه اطلع على كتاب الشيوعية في الإسلام, وإنه لمس منه أنه مجرد مقارنة علمية لا أكثر ولا أقل"!
وهذه الشهادة غير الصادقة لصالحه من قبل الدكتور مظهر سعيد أحد أساتذته في كلية أصول الدين وفي قسم التخصص, وزميل الدكتور البهي في هذه الكلية وفي هذا القسم تدل على عمق تغلغل الخلايا الشيوعية التابعة للحركة المصرية للتحرر الوطني في الأزهر.
إنه من المؤكد أن الدكتور محمد البهي يعرف الشيخ الشيوعي أبو الحسن الغنيمي, فلابد أنه قد درّسه في كلية أصول الدين، ودرسه في قسم التخصص.
وإذا صحت معلومة عبده دهب عن البهي, فسيكون البهي عرف طريقه إلى مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية عبر الشيخ الغنيمي أو بواسطة شخص آخر في الأزهر.
في بداية تعرفي على هذه المعلومة فكرت أن البهي ربما حضر إلى مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية من باب الفضول العلمي، وحب الاستطلاع السياسي، أو أنه أراد أن يعرف الشيوعية عن كثب من خلال معتنقيها. لكن هذا الافتراض تعرض لشيء من الشك مع تعرفي على آلية العمل في مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية.
توفر لي هذا التعرف عندما قرأت مؤخراً كتاب جيل بيرو: (هنري كورييل: رجل من طراز فريد) الذي عربه وقدم له كميل داغر. وبالمناسبة فإن هذا الكتاب المعرب صدر في السنة نفسها التي صدر فيها الجزء الثاني من كتاب أحمد سليمان, وهي سنة 1986. وأحمد سليمان يعرب عنوان هذا الكتاب إلى (هنري كورييل: رجلٌ على حِدَه). وتعريب أحمد سليمان لعنوان الكتاب يفوق تعريب كميل داغر بوجازته وأنه صافٍ في عربيته.
وبالمناسبة أيضاً, فإن جيل بيرو يحدد تاريخ إنشاء هنري كورييل لمدرسة الكوادر الشيوعية بالمنصورية بشهر تشرين الأول سنة 1943, ويحدد عدد الدارسين فيها بعشرين شخصاً بينما رفعت السعيد حدد تاريخ الإنشاء بأنه كان في شهر يناير من ذلك العام, وحدد عدد الدارسين بأنهم كانوا خمسة وعشرين شخصاً. ولقد أخذت بما قاله رفعت السعيد لأنه استقى هاتين المعلومتين من هنري كورييل.
يقول جيل بيرو: "جرى اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على سرية المكان. فجيء بالمتدرجين بالسيارة ليلاً وأعينهم معصوبة. ولم يكن المحاضرون يصلون لإعطاء محاضراتهم إلا بعد جولات طويلة عبر الريف من أجل إحباط أي اقتفاءات محتملة للأثر".
ويطلعنا على تفصيل برنامج الكادر, فيقول: " كان المتدرجون يسكنون في البيت الكبير, العزبة, ينامون على عصائر من قصب. وكان الطعام زهيداً. أما الدروس فكانت تبدأ عند بزوغ الشمس وتنتهي عند غروبها، مع توقف واحد لأجل الغداء وبعض الاستراحات المكرسة لأناشيد ثورية. وقد تعلم المتدرجون, الذين لم يكن أحد منهم يعرف لغة أجنبية, المارسيلييز بالفرنسية (نشيد الثورة الفرنسية ونشيد فرنسا الوطني), لكن الحدث الكورسي كان التأدية الأولى للنشيد الأممي باللغة العربية على أرض مصر: كان أحد المحاضرين, طاهر المصري قد نقله إلى العربية. وبعد غروب الشمس كانت الأمسية تكرس لنقاشات حرة بين المتدرجين, ولكتابة تلخيصات للمحاضرات المعطاة منذ الصباح".
ويقول أحمد سليمان: إن المحاضرات وما يعقبها من مناقشات تمتد للعاشرة مساء كل يوم.
وفق هذا التفصيل لهذا البرنامج, كان نظام المدرسة هو بالفعل – كما قال هنري كورييل لرفعت السعيد – نظاماً صارماً والحياة فيه حياة برويتارية حقه.
نشيد الأممية (الانترناسيونال) الذي يبدأ نشاط مدرسة الكادر به, محاضرين وطلبة, أورد رفعت السعيد مطلعه على لسان هنري كورييل:
يا بؤساء الدنيا قوموا
قوموا يا محرومين من الخير
سخطكم بقى رعد ياللا قوموا
ده الانتفاض الأخير
نلحظ في الشطر الأخير من هذا المطلع أن هنري كورييل قاله بعامية خواجات.
أحمد سليمان الذي قال عن هذا النشيد أنه ترجم بأسلوب ركيك – وهو محق في كلامه – أورد المقطوعة الأولى (نشيد الأممية "الانترناسيونال" مكون من ستة مقطوعات) وليس المطلع وحسب.
يا بؤساء الدنيا قوموا
قوموا يا محرومين من الخير
سخطكم بقى رعد قوموا
جاء الانفجار الأخير
انسوا الماضي وامسحوه
كونوا كل شيء كونوا كونوا
ونظام العالم غيروه
واجعلوا آخر الحروب أهلية
تسود الدولية
جميع الجنس الحي
نشيد الأممية أو نشيد الشيوعية يعرفه الشيوعيون العرب وقد رتلوه فيما مضى من زمن بصيغة أخرى, وللمقارنة ما بين ترجمة طاهر المصري له من الفرنسية والترجمة التي استقر عليها, أورد نص المقطوعة الأولى منه:
هبّوا ضحايا الاضطهاد
ضحايا جوع الاضطرار
بركان الفكر في اتقاد
هذا آخر انفجار
هيا نحول كل ما مر
ثوروا حطموا القيود
شيدوا الكون, جديد حر
كونوا أنتم الوجود :
بجموع قوية هبوا, لاح الظفر
غدُ الأممية يوحد البشر
فوبيا الشيوعية والشيخ "ستلاّ"
لا يعد في المنتصف الأول من القرن الماضي وجود أزهريين, مشايخ وطلبة, في صفوف التنظيمات الشيوعية أمراً مستنكراً أو قضية شاذة إلا عند من يحكم على روح تلك الفترة, بمقاييس عقود تالية لها. ففي عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وحتى في منتصفه إلى سنوات السبعينيات لم تكن في مصر ولا بقية البلاد العربية – هذا إذا ما استثنينا السعودية – ما يصطلح على تسميته بالغرب وبخاصة عند اليساريين بـ "فوبيا الشيوعية". فهذه الفوبيا التي أنشأتها وغذتها أمريكا منذ منتصف القرن الماضي انتقلت إلى العالم العربي في أواخر السبعينيات، وتضخمت في سنوات الثمانينيات. ونظراً لغياب الفوبيا أو الرهاب إزاء الشيوعية, فإنه مع تحول الحزب الاشتراكي المصري إلى حزب شيوعي وضمه إلى الدولية الثالثة (الكومنترن) سنة 1923, كان الشيخ الأزهري صفوان أبو الفتح من زعماء الحزب الشيوعي المصري القديم، والذي حكم عليه وزعماء آخرين كمحمود حسني العرابي وأنطون مارون والشحات في عهد حكومة سعد زغلول باشا سنة 1924 بالسجن ثلاث سنوات. وفي سنة 1925 في عهد حكومة زيور باشا قبض على مجموعة شيوعية تسعى إلى إحياء الحزب مجدداً كان من بينها الشيخ شاكر..., وكان طالباً ثلاثينياً في الأزهر.
وقد أدرك هنري كورييل الشيخ العتيق في الشيوعية صفوان أبو الفتوح، وتمكن في ظل إحياء التنظيمات الشيوعية في الأربعينيات من ضمه هو ومجموعة معه من بقايا الحزب الشيوعي المصري القديم إلى الحركة المصرية للتحرر الوطني (ح.م).
وفي هذه الفترة, فترة الأربعينيات, كانت ثمة مجموعة اجتمعت على الفكر الماركسي انضمت إلى حركة التحرر الوطني (ح. م) ,كان من بينها شيخ أزهري وكان وقتها شاباً, وهو الشيخ سعاد جلال. والشيخ سعاد جلال حاصل على العالمية من الأزهر وعلى الدكتوراه من كلية الشريعة, وعمل مدرساً في هذه الكلية وفي جامعة دمشق وفي الجامعة الإسلامية بالسودان.
وهو متخصص في أصول الفقه وله مؤلفات في هذا المجال. وكان شخصية معروفة لها حضور في الصحافة المصرية. وكان كتب عموداً ثابتاً في جريدة (الجمهورية) تحت عنوان "قرآن وسنّة" إلى سنة وفاته في 1983م. وله اجتهادات فقهية "تقدمية" يطرب اليساريون ويضيق بها زملاؤه من المشايخ والفقهاء.
هذا الشيخ ظل طيلة حياته يسارياً، وكان يلقب بالشيخ الأحمر إلى أن زاحم هذا اللقب لقب آخر , وهو" الشيخ ستلاّ" بسبب فتوى له أجاز فيها شرب البيرة لأنه كان يستطعم شربها في خلواته مع أصدقائه من الصحافيين والمثقفين اليساريين. وكانت مصر وقتها لا تصنع سوى بيرة واحدة, وهي "بيرة ستلاّ" , فإن قيل بيرة عند المصريين انصرف الذهن إلى نوعها الوطني الذي يحمل اسم "ستلاّ".
وفي تقرير للسفارة الأمريكية في القاهرة في الأربعينيات أورده رفعت السعيد في كتابه (تاريخ المنظمات اليسارية المصرية) ذكر فيه أن الشيخ عبد الرحمن حسن داعية شيوعي نشط، ومثابر في كلية اللغة العربية بالأزهر.
ويجب علينا أن ننبه أن عدداً من هؤلاء الأزهريين وآخرين غير أزهريين لم تكن شيوعتهم شيوعية محضة, فهم كانوا يؤمنون بالشيوعية في جانبها السياسي وجانبها الاجتماعي – الاقتصادي ويرفضون الإيمان بالفكر المادي فيها. يقول هنري كورييل لرفعت السيد عن أحد هؤلاء وهو غير أزهري مفسراً سبب انشقاقه عن حركة حدتو: إن عبدالفتاح الشرقاوي كان يفهم الشيوعية فهماً إسلامياً صرفاً!
يقول هنري كورييل عن عبد الفتاح الشرقاوي, مفسراً انشقاقه عن "حدتو" بتنظيم شيوعي مستقل: أنه كان يفهم الشيوعية فهماً إسلامياً صرفاً.
إجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان المقال, أقول: لا توجد فيما كتبه جيل بيرو ورفعت السعيد عن مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية إشارة إلى اسم محمد البهي. ففي محضر نقاش رفعت السعيد مع هنري كورييل, لم يذكر الأخير اسمه. لكن هذا لا ينفي أنه ممن تلقوا كورساً في الشيوعية في مدرسة الكادر, فالذين تلقوا فيها كورساً يبلغ عددهم خمسة وعشرين متدرجاً لم يستطع هنري كورييل تذكر سوى أسماء قليلة منهم, مع أنه كان ينبغي له أن يتذكره لتميزه عند بقية زملائه في مدرسة الكادر بأنه حاصل على الدكتوراه ويتحدث اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية.
واللافت للنظر أن عبده دهب الذي ذكر لأحمد سليمان أن البهي كان ممن يحضرون مدرسة الكادر لم يذكر لرفعت هذه المعلومة, رغم أنه كان أحد مصادر الأخير الشفاهية في تاريخ الحركة الشيوعية في مصر.
هذه المعلومة التي انفرد بها أحمد سليمان تحتاج من المعنيين بتاريخ الحركة الشيوعية في مصر – ورفعت السعيد أبرزهم – إلى بحث وتدقيق إما يثبتها وإما ينفيها.
ثمة حكاية في سيرة محمد البهي (حياتي في رحاب الأزهر: طالباً وأستاذاً أو وزيراً) – التي نشرتها مكتبة وهبة بعد وفاته – تحتاج إلى وقفة.
الحكاية هي: أنه في سنة 1944 بعد ولادة ابنته الوحيدة نادية زاره في بيته في العباسية الشرقية (العنوان نفسه الذي ذكره عبده دهب) وكيل نيابة قسم الوايلي.
وكان لا يعرفه فعرفه بنفسه. وذكر له أنه يعرفه من كتاباته في مجلة "الرسالة" والتي ابتدأ الكتابة فيها وهو في جامعة "هامبورج" سنة 1934. ثم أطلعه على شكوى من مجهول ضده يبلغ إدارة الأمن العام: أنه من عملاء ألمانيا عدوة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية, وأنه خطر على الأمن ضد جنود الحلفاء ويطلب اعتقاله.
واستنتج وكيل النيابة أن هذا المجهول ربما يكون طالباً. وأخيراً ذكر: أنه تأكد أن هذه الشكوى كيدية, وأنه من أجل ذلك قرر حفظها, ورأى أن لا يزعجه إذا ما طلبه إلى مكتبه فآثر أن يزوره ويطلعه عليها, تقديراً لكتاباته التي عرفه عن طريقها, فشكر له فضله وانصرف. يختم البهي حكايته هذه بالقول: الغريب أني لم أعرف اسمه, ولم أسأله عنه وقت زيارتي!
هذه الحكاية تتناقض تماماً مع ما رواه عنه عبده دهب. فاتهامه الكيدي بأنه عميل للألمان يبعد عنه الاتهام بالميل للشيوعية أو لليسار. فالشيوعية عدوة للنازية، والنازية عدوة الشيوعية. لكن هذه الحكاية التي رواها يعتورها خللان, هما:
الخلل الأول: هو أن المعجب بكاتب يحرص على أن يعرّف الكاتب باسمه وكذلك الكاتب فهو يحرص على أن يتعرف على اسم المعجب, والبهي يزعم أن وكيل النيابة اكتفى بالتعريف بنفسه من خلال صفته الرسمية, وأنه لم يسأله عن اسمه, مع أن اللقاء تم في منزله!
الخلل الآخر: أنه قبل أن يروي حكايته أومأ إلى الأزمة الاقتصادية التي كانت تعانيها مصر في الأربعينات من حيث "القصور في الغذاء والكساء .. فجنود الحلفاء بلغوا عشرات الآلاف بمصر. وكان على مصر أن تمد هؤلاء الجنود بكل ما يحتاجون حتى ببنات الترفيه اللاتي كن يشحن في القوافل".
هذه الإيماءة التمهيدية لرواية الحكاية تتناسب واتهام كيدي بالشيوعية ولا تتناسب واتهام كيدي بالتأثر بالنازية. فالتأثر بالنازية في مصر لم يكن سببه اجتماعي – اقتصادي وإنما كانت له أسباب ثلاثة هي:
بغضاً في المحتل الإنكليزي, ورفضاً لفساد التجربة السياسية البرلمانية, وتجاوباً مع الأزمة الكبرى التي واجهتها الليبرالية والديمقراطية في أوربا. أي أن الأسباب – في المحل الأول -هي أسباب سياسية وفكرية محضة.
إننا إن افترضنا صحة ما قاله عبده دهب, يكون البهي أجرى على حكايته تعديلات هي:
-غير في تاريخ حصول الحكاية فجعله في سنة 1944 وليس في سنة 1943, سنة تردده على مدرسة الكادر الشيوعية بالمنصورية.
-أن بينه وبين وكيل النيابة معرفة مسبقة أو صلة شخصية, فحذره من التردد عليها, انطلاقاً من تقارير وصلت إليه مذكور فيها اسمه.
-أن الاتهام له كان اتهاماً بالشيوعية, وليس بالعمالة للألمان.
[caption id="attachment_55260033" align="alignleft" width="300"]
 برلنتي عبدالحميد[/caption]
برلنتي عبدالحميد[/caption]
هذه الحكاية وبهذه الصورة المفترضة ربما تعزز ما قاله عبده دهب عن محمد البهي مع إقراري بأنها دليل ضعيف وواه.
محنته مع محمود أمين العالم ومع برلنتي عبدالحميد
تعرض محمد البهي بعد عزله من منصبه الأخير (مدير جامعة الأزهر) في سنة 1964, ووضعه تحت الرقابة في منزله لمحنتين، الأولى سببها الماركسي محمود أمين العالم، والأخرى سببها عبد الحكيم عامر . وكلتا المحنتين وقعتا في سنة واحدة, هي سنة 1966.
المحنة الأولى: تتعلق بكتابه الشهير (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1957 والذي كان إلى سنة المحنة أعيد طبعه مرتين.
المحنة هي – كما رواها في سيرته – " أنه في شهر يناير في سنة 1966, نقل إليه الدكتور توفيق شاهين أنه علم أن كتابه (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) رصت حروفه بمطبعة مصر, ثم جمد. لأن محمود أمين العالم, تولى إدارة هيئة الكتاب التي ضمت فيما ضمته إليها: الدار القومية التي تعاقد معها على طبع الكتاب, وأبلغه رسالة منها شفوية تفيد: أنه على استعداد لزيادة المبلغ المتعاقد عليه من ألف ومئتي جنيه مصري إلى ألفين من الجنيهات, ولكن على شرط أن يحذف من الكتاب الفصول الخاصة بالشيوعية. فرفض هذا العرض. وكان رد العالم أن كلف أحد المشايخ الموظفين في وزارة الثقافة بكتابة تقرير ضد الكتاب. فكتب أن الكتاب تعرض لبعض أفكار "الجمعية المنحلة" وهي جمعية الإخوان المسلمين. وفي مقدمة هذه الأفكار أن الإسلام دين ودولة. وكان على وزارة الثقافة في ذلك الوقت الدكتور سليمان حزيّن, ولم يستطع مع تغلغل الشيوعية في وزارته أن ينصف الكتاب, ولا أن ينفذ العقد. وبقي الكتاب تحت الرقابة إلى أن طبع في بيروت سنة 1969".
المحنة الأخرى: يلخص هذه المحنة التي استمرت إلى سنة وفاته الكاتب الناصري عبد الله إمام بأسطر قليلة في كتابه (حياتي في الصحافة), وهو الذي كان يعرفه عن قرب, حيث كانت تربطه صلة صحافية به. يلخص المحنة بقوله: "كان الدكتور البهي قد انتقل قبل الوزارة من بيته في العباسية في يناير 1963م إلى فيلا بجوار فندق البارون أمبان بمصر الجديدة (خانت عبد الله إمام الذاكرة في هذه المعلومة, فهو قد عين وزيراً في التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1962م, وانتقل في سكناه إلى هذه الفيلا بعد ثلاثة أشهر من تعيينه وزيراً) بإيجار سبعة وأربعين جنيهاً وعرض عليه صاحبها سعيد العطار أن يشتريها تسعة آلاف جنيه, ولكنه لم يتمكن من تدبير المبلغ, وقد بيعت الفيلا بعد ذلك باسم سيدة إسماعيل فراج وهي والدة السيدة نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة ببرلنتي عبد الحميد, وقد أنذرته بإخلاء الفيلا لكي تسكنها ... والحقيقة أن المشير عبد الحكيم عامر كان قد اشترى الفيلا للسيدة برلنتي عبد الحميد لتكون إلى جوار القيادة المشتركة حيث كان مكتبه. وحدثت تداعيات كثيرة بسبب هذه الفيلا, رواها في كتاب منشور كان يوزعه مجاناً كما رواها بالتفصيل في مذكراته. وقد تعرضت إلى جانب منها في كتابي (عامر وبرلنتي)".
تعرض البهي في بداية هذه المحنة لكذب واحتيال كي يجبر بطريقة قانونية على إخلاء الفيلا ثم إلى إغراء بمنصب وزاري من قبل عبد الحكيم عامر وإغراء مالي وتوفير فيلا بالقاهرة, وأخرى بالأسكندرية من شركة التأمين من قبل مدير مكتبه علي شفيق زوج الفنانة مها صبري, ولما رفض إغراءاتهما مقابل تخليه عن الفيلا هدداه بالإيذاء.
يهمنا من هذه المحنة مناقشة حصلت بينه وبين عبد الحكيم عامر, رواها وهو يفصل مجريات هذه المحنة. يقول البهي: "سألني عن الرأي في الشيخ أحمد الباقوري وفي محاكمة الإخوان المسلمين, وفي كتاب (معالم في الطريق) للمرحوم سيد قطب. فعرفت من سؤاله وحديثه: مدى ارتباطه بشخص الشيخ أحمد الباقوري ومدى كراهيته للإخوان وللمرحوم سيد قطب بالخصوص. ولذا عندما أجبته عن تقييمي لكتاب (معالم في الطريق): بأني كنت أتمنى أنا (كذا) الذي كتبته, هاج ووقف من جلوس. وقال: كيف تقول ذلك والصحافة كلها نددت به؟ قلت له: إن ما في هذا الكتاب هو رأي القرآن فيما أرى. وما تقوله الصحافة عنه شيء سياسي لا دخل له إطلاقاً في تقييمه, وانصرفت".
هذه المناقشة وثيقة الصلة بكتابة تقرير عن كتابه (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) الذي كلف محمود أمين العالم أحد المشايخ الموظفين في وزارة الثقافة بإعداده. وما قاله البهي عن مضمون التقرير، وما ذكر أنه قاله في المناقشة هو غير دقيق. ولنبدأ في وقفتنا مع ما قاله عن مضمون التقرير.
الوقفة الأولى: قال عن مضمون التقرير في كتابه: إن كاتبه "كتب أنه الكتاب تعرض لبعض أفكار "الجمعية المنحلة", وهي جمعية الإخوان المسلمين. وفي مقدمة هذه الأفكار أن الإسلام دين ودولة". إن قوله هذا يخفي أكثر مما يظهر. فماذا يقصد بهذه الجملة: "تعرض لبعض أفكار الجمعية المنحلة؟" هل تعرض هنا بمعنى الشرح والإبانة أم بمعنى التصدي والمجابهة؟! ولماذا اقتصر هذا التعرض – بصرف النظر عن غموض هذه الجملة – على "بعض" أفكار الجمعية المنحلة ولم يشملها "كلها", مادام أن التقرير أعد أساساً للانتقام من موقفه المعادي للشيوعية؟! كما أن القول بأن الإسلام دين ودولة معتقد لا يقتصر على الجمعية المنحلة أو الإخوان المسلمين, فهو معتقد عام يقول به كثيرون منذ فجر الإسلام الحديث، ويقول به مشايخ ومفكرون إسلاميون موالون لجمال عبد الناصر, ويقول به آخرون من الفعاليات الحركية الدينية في الاتحاد الاشتراكي الذين بعضهم كانوا من الإخوان المسلمين التائبين. ولو قال البهي بعكس هذا, أي أن الإسلام دين لا دولة, لما كان تولى منصب مدير الثقافة في الأزهر، ولا منصب مدير جامعة الأزهر، ولا منصب وزير الأوقاف وشؤون الأزهر. والبهي بحكم اطلاعه على أدبيات المستشرقين كان يعرف جيداً أن كثرة منهم تقرر أن الإسلام ليس مجرد دين, وإنما هو دين ودولة.
إن ما أخفاه هو أن التقرير الذي أعده شيخ بتكليف من الماركسي محمود أمين العالم بسنة 1966م على أساس أن "العصا من العُصيّة وأن خُشيناً من أخشن" أو بتعبير آخر أن كتاب سيد قطب هو الفرع وكتابه هو الأصل.
هذا التقرير العدواني كتب في وقت حرج وسيئ. فهو قد كتب قبل فترة قصيرة من بدء محاكمة سيد قطب والمجموعة التي قادها في تنظيم 1965م لقلب نظام الحكم في مصر. وكان كتاب محمد البهي (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) من ضمن كتب معدودة وضعها سيد قطب منهجاً دراسياً وتربوياً لأفراد التنظيم في خانة ما أسماه بـ"الدراية والمعرفة بالمخططات الصهيونية والصليبية وأعوانهم لضرب الإسلام ووسائلهم". ولابد أن بعض أعضاء التنظيم حين القبض عليهم اعترف بهذا الأمر, وبخاصة على عشماوي.
وهذا التقرير قد اطلع عليه المشير عبد الحكيم عامر لسبب شخصي, وآخر رسمي.
السبب الشخصي هو لاستخدامه في الضغط على البهي من أجل أن يوافق على إخلاء الفيلا, لتسكن فيها زوجته السرية الفنانة برلنتي عبد الحميد.
والسبب الرسمي أن مضمون التقرير يلحم كتاب (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) بكتاب سيد قطب (معالم في الطريق). وكان الرجل المكلف بمتابعة قضية تنظيم 1965م والتحقيق معهم هو شمس بدران الذي هو من أقرب أتباعه إليه. وقد أفصح هو في رده على رسالة كمال الدين حسين الذي احتج فيها على اعتقال سيد قطب واتهامه في الإعلام بقيادة مؤامرة على الثورة, بأنه تابع التحقيق في قضية التنظيم "خطوة خطوة ... وأن المؤامرة فيها أكثر مما نشر حتى الآن ".
إن جملة البهي الغامضة عن مضمون التقرير التي قال فيها أن كاتب التقرير كتب أن كتابه تعرض لبعض أفكار الجمعية المنحلة, تجعلنا نستنتج أن المقصود ببعض أفكار الجمعية المنحلة, أفكار سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق) الذي كان هو المتن الأساس في عقيدة التنظيم الذي قاده.
ويعزز من هذا الاستنتاج الشهادة التي قدمها رضوان السيد عن تلك الفترة في ذكرياته المصرية. ففي تلك الفترة كان رضوان طالباً في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
يحدثنا رضوان أنه في سنة 1966م, زار هو وزملاء له محمد البهي في بيته, ويقول عن هذه الزيارة: "بدأنا معه بقراءة كتابه المشهور: (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي). وقد قلت له إن ما لفت انتباهي في الكتاب مشابهته لأفكار الإخوان المسلمين في مسألة الأفكار المستوردة رغم غياب فكرتي الحاكمية وضرورة تغيير السلطة بالقوة. فانفعل شأنه في ذلك شأن كل الأزهريين القدامى الذي لا ينسون صراعاتهم مع الإخوان في الأربعينيات, وقال أن سيد قطب أخذ الفكرة عنه, ووصل بها إلى نتائج متطرفة. ثم كرّر على مسامعنا أنثروبلوجيا العقاد لحسن البنا التي تستند إلى شكل جمجمته, ومهنة أسرته المتوارثة (ساعاتية) للوصول إلى أن الرجل يهودي الأصل!!". راجع مقال رضوان السيد: السلفية والهزيمة: ذكريات مصرية, في كتابه (الإسلام المعاصر: نظرات في الحاضر والمستقبل).
الوقفة الثانية: في الحديث الذي جرى بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر عندما سأله الأخير عن رأيه في محاكمة الإخوان المسلمين (المقصود بها محاكمة تنظيم 1965م) أوحى أنه مناصر للإخوان المسلمين، وادعى أنه معجب بكتاب سيد قطب (معالم في الطريق) إلى الحد الذي سجل فيه موقفاً شجاعاً, فتمنى لو أنه هو الذي كتبه! فهاج المشير وماج ووقف من جلوس, مستنكراً ما قاله: فلم يعبأ باستنكاره ورد عليه: بأن هذا الكتاب يصدر عن القرآن!
وما عرفناه من رضوان السيد أنه في تلك الفترة كان له موقف بالغ التطرف من الإخوان المسلمين وزعيمهم الشيخ حسن البنا, وأنه يستنكف أن يوضع سيد قطب في مصافه. فهو لا يشابه سيد قطب, وإنما سيد قطب أخذ بعض أفكاره ودفع بها خلاصات متطرفة!
ثم إن السياق العام (محاكمة سياسية لسيد قطب ورفاقه بتهمة التآمر على الحكم, بتنفيذ اغتيالات سياسية وتخريب منشآت كبرى, إشراف عبد الحكيم عامر على متابعة قضية التنظيم, وكون كتاب (معالم في الطريق) من أدلة الإدانة بأنه مرشد وموجه لتنظيم انقلابي سري), والسياق الخاص (غضب جمال عبد الناصر عليه لسبب غير معروف, ومنازعة عبد الحكيم عامر له على سكنه الخاص, والوشاية والاستعداء الشيوعي على كتابه وعلى شخصه), يمليان علينا ألا أنصدّق دعوى التمنى والمجاهرة بأن رأي سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق) هو رأي القرآن!
الأقرب والأصح – استناداً إلى كل المعطيات التي سردتها – أنه قال في حضرة المشير عبد الحكيم عامر كلاماً غير هذا الكلام المزعوم.
ما الذي دعا البهي أن يوحي بموقف من الإخوان المسلمين هو خلاف موقفه الحقيقي منهم في تلك الفترة؟ وما الذي دعاه أن يدعي أنه تمنى لو كان هو الذي كتب (معالم في الطريق), ويدعي أيضاً أن ما جاء في هذا الكتاب هو رأي القرآن؟
سأبين عن البواعث بالكلام الآتي:
يأخذ الإخوان المسلمون على البهي في فترة الستينات توليه تنفيذ قانون الإصلاح في الأزهر, وتوزره, والدعوة للاشتراكية العربية من منطلق إسلامي حينما اتجه عبد الناصر إلى تطبيق الاشتراكية سنة 1961م.
ويشارك سيد قطب المؤسس الثاني للعقيدة والفكر الإخواني الإخوان المسلمين في مآخذهم الثلاثة عليه, رغم تقديره الكبير لكتابه "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي". لذا نجده في الكتب التي اعتمدها في المنهج الدراسي الخاص بما أسماه بـ"الدراية والمعرفة بالمخططات الصهيونية والصليبية وأعوانهم لضرب الإسلام ووسائلهم" الذي يتلقاه أعضاء التنظيم الذي قاده, خص البهي بملحوظة دون سواه, هي الفصل بينه وبين كتابه, منبهاً إياهم إن العبرة بالكتاب لا بالكاتب.
البهي بعد عزله من منصب مدير جامعة الأزهر, وإحالته للتقاعد, ووضعه تحت الرقابة, وامتحان الشيوعيين ويساريي الاتحاد الاشتراكي له منذ مطلع الستينيات إلى وفاة عبد الناصر, وامتحان عبد الحكيم عامر له في مسكنه الخاص, وقبلها امتحان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (تابع لوزارة الأوقاف لكن سلطة سكرتيرة المساعد, الملازم ثان محمد توفيق عويضة توازي سلطة وزير الأوقاف أو تتفوق عليها لأن هذا المجلس في الأساس جهاز استخباراتي ودعائي, وبالإضافة إلى هذا كان عويضة مسنوداً من سامي شرف وعلي صبري) له حين كان وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر، وحين عاد مجدداً إلى منصبه السابق مدير جامعة الأزهر, أقول بعد هذا كله حنق على جمال عبد الناصر وعلى الثورة وعلى العسكر.
وبما أن الاشتراكية العربية التي دعا لها من منطلق إسلامي لم تكن عن قناعة, وإنما أملى عليه تبنيهما منصبيه الحكوميين. سهل عليه التخلص من هذا الإرث, فحذف – كما تخبرنا بذلك الصحافية المصرية أمل خيري – "الكثير مما كتبه عنها من كثير من كتبه"؟. وفي غمرة إعادته طباعة كتبه في السبعينيات حرص أن يخفى عن أعين قرائه كتابه الدعوي للاشتراكية العربية: (الفرد والمجتمع في الميثاق) الذي هتف في خاتمة أسطره بـ"عاش الرئيس جمال عبد الناصر . . وعاش الأزهر مصدر الدعوة والثورة"!.
ولأن خلاف الإخوان المسلمين معه هو خلاف سياسي وليس خلافاً فقهياً ولا ثقافياً ولا أيديولوجياً, فهم يرجعون إلى كتبه منذ الخمسينيات والستينيات, روجوا لكتبه التي أعاد طباعتها مع انتعاش فكر الإخوان المسلمين في السبعينيات وصعوده في أول الثمانينيات. ففي ظل هذا المناخ الذي راجت فيها كتبه وكتيباته بعد سنوات من التضيق عليها, قال ذلك الكلام المزعوم لرد الجميل للإخوان المسلمين الذين أفادوا كتبه تجارياً واستفادوا منها أكاديمياً ودعوياً واستفادوا من اسمه العلمي الرصين.
العداوة بين السلف والخلف: البهي والباقوري
أشار البهي بمناسبة سؤال المشير عبد الحكيم عامر له عن رأيه في الشيخ أحمد حسن الباقوري, أنه عرف من سؤاله وحديثه, مدى ارتباطه بشخص الباقوري, وكان يريد من هذه الإشارة القول بأن الذي كان وراء تعيين الباقوري خلفاً له في جامعة الأزهر هو عبدالحكيم عامر وليس جمال عبد الناصر، وقد قال ذلك – على نحو مباشر – في موضع آخر في سيرته.
إنه من المعروف أن الباقوري – أول وزير أوقاف في عهد الثورة – كانت له صلة شخصية قوية بعبد الناصر، وأنه أقاله من الوزارة في 13 فبراير سنة 1959م, لسبب يتعلق بشرفه الشخصي.
[caption id="attachment_55260037" align="alignleft" width="300"]
 أحمد حسن الباقوري[/caption]
أحمد حسن الباقوري[/caption]
فالباقوري كان من ضمن الذين يحضرون ندوة العلامة محمود محمد شاكر, وذات يوم في أحد اجتماعات الندوة اتصل الأديب يحيى حقي بمحمود شاكر – وهو صديقه ومن أعضاء الندوة – بالتلفون, وكان يشكو إليه نقله إلى عمل لا يناسبه. فقال محمود محمد شاكر: ما حيلتي يا أخ يحيى في هؤلاء العساكر الذين يحكمون البلد, وعلى رأسهم جمال عبد الناصر ... وشتمه في أمه شتيمة بذيئة. وحينما استنكر يحيى حقي هذا الأسلوب منه, قال له: "جبان وخائف من عبد الناصر ... الشيخ الباقوري جنبي أهو سامع الكلام". تلفون محمود محمد شاكر كان مراقباً, كذلك كان كل ما يدور من أحاديث في الندوة مسجلاً عن طريق أحد رجال المخابرات الذي يسكن في العمارة نفسها التي يسكن فيها محمود محمد شاكر. وكانت الأحاديث لا تخلو من انتقاد للثورة ولرجالاتها. اعتذر الباقوري لعبد الناصر عندما أسمعه تسجيل ما قاله محمود محمد شاكر بحق أمه, أنه كان يصلي, ولمّا فرغ من صلاته أنّبه على ما قاله (روى الباقوري هذه الحكاية مرتين, الأولى في حوار لنعم الباز معه, ضمته إلى حوارات أخرى أجرتها معه أصدرتها فيما بعد في كتابها: ثائر تحت العمامة. والأخرى في سيرته الذاتية: بقايا ذكريات).
لم يكتف عبد الناصر بإقالته من الوزارة, بل حكم عليه بأن يلزم بيته ولا يغادره إلا لضرورة قصوى.
وبعد خمس سنوات وبضع أشهر عينه مديراً لجامعة الأزهر بعد أن زال غضبه عليه. وعزل البهي من منصبه.
ولم يكن البهي راضياً عن عزله من منصبه, فهو يريد أن يكمل مشروع إصلاح الأزهر الذي كان متحمساً له منذ زمن طويل. وقد عارض تعيين الباقوري في هذا المنصب بحجة أكاديمية وإدارية وحجة قانونية, وهو أن الباقوري لم يسبق له أن درّس في كلية من كليات الأزهر, كما ينص على ذلك القانون رقم 103 لسنة 1961م. وقد نشأت خصومة وعداوة بسبب هذا الأمر بين الرجلين استمرت معهما إلى وفاتهما.
نلمس هذا في إشارة البهي غير الصحيحة عمّن كان وراء تولية الباقوري منصب مدير جامعة الأزهر. فالمشير عبد الحكيم عامر ذو سمعة رديئة وقلَّ أن تجد من يدافع عنه وليس كعبد الناصر الزعيم الجماهيري الموهوب الذي يختلف القول فيه.
ونلمسه في سيرة الباقوري الذي قال عن نفسه أنه رد الحقوق إلى الذين ظلمهم سلفه البهي. وشنع بالبهي أنه وصف الشيخ محمود شلتوت – الإمام الأكبر – "بأوصاف نابية لا يرضاها ذو مروءة, فضلاً عن أن يكون ابناً للشيخ وصنيعة من صنائعه". راجع دفاع البهي عن نفسه بشأن خلافه مع شيخه شلتوت في كتابه: (حياتي في الأزهر, طالباً وأستاذاً ووزيراً).
ولكره الباقوري للبهي كان في سيرته لا يسميه باسم الشهرة: محمد البهي, وإنما يسميه باسمه العائلي الكامل المجهول عند كثيرين, وهو محمد البهي قرقر, للسخرية من هذا الاسم الشعبي في مصر (في أوراق الأزهر الرسمية اسمه الكامل محمد محمد عامر البهي).
يذكر الباقوري في سيرته هذه, أن البهي "لم يستطع أن يباشر مهام منصبه بسبب كثرة الحاقدين عليه, والمعادين له من أساتذة الجامعة ومدرسيها وجميع طلابها".
للموافقة على طباعة كتاب (الفكر الإسلامي الحديث ...) طبعة ثالثة طلب محمود أمين العالم من البهي أن يحذف من الكتاب الفصول الخاصة بالشيوعية. ولما رفض كلف شيخاً بكتابة تقرير ضده, فمنع طبعه.
الشطر الأول مما ذكره الباقوري وهو أن البهي "لم يستطع أن يباشر مهام منصبه" فيه نظر.
يسوء الباقوري أمران, هما: أن أول مدير جامعة الأزهر كان البهي وليس هو. وأن قانون إصلاح الأزهر ارتبط باسم البهي وليس باسمه.
ويكشف هذان الأمران اللذان يسوءانه حوار أجراه الصحافي إبراهيم البعثي معه في كتاب له, عنوانه: (شخصيات إسلامية معاصرة) صدر في سنة 1972م, فهو في هذا الحوار تجاهل تماماً أن البهي كان مدير جامعة الأزهر قبله, وكان على نحو غير مباشر يقدم نفسه بوصفه أول مدير لها. وما قدمه على نحو غير مباشر قاله الصحافي الذي حاوره صراحة, إذ قال: إن "تعيين أول مدير للجامعة الأزهرية – وهو الشيخ الباقوري – لم يتم إلا في عام 1964م"!!
أما قانون إصلاح الأزهر, فهو في هذا الحوار أعلن أنه هو صاحبه أو هو الآمر به, فقال: "تقتضي الأمانة لله ثم للتاريخ أن أقرر أن التفكير في هذا التطوير بدأ حوالي عام 1954م بدراسة أعدها برجاء مني أخي الصديق الأستاذ خالد محمد خالد. وهذه الدراسة ظلت تتعثر حتى عام 1961م, فصدر القانون بعد مناقشته في مجلس الأمة الذي كان برئاسة السديد أنور السادات". ثم يقفز في حديثه إلى سنة 1964م, سنة تعيينه في الأزهر, شاطباً فترة البهي في تنفيذ قانون الإصلاح في الأزهر, ومدعياً أن تنفيذ قانون الإصلاح هو الذي بدأه وهو الذي رعاه وتعهده إلى أن "تخرجت في سنة 1969م الدفعات الأولى من الكليات المعملية من جامعة الأزهر ومن كلية البنات, وبهذا يصبح لدينا لأول مرّة مهندسون زراعيون وأطباء أزهريون, وكذلك وكلاء نيابة من كلية الشريعة والقانون, وهو أمر ما كان يحلم به الأزهريون". وسنة 1969م, هي آخر سنة له في إدارة جامعة الأزهر.
إن البهي حينما زاره رضوان السيد وزملاؤه في بيته سنة 1966م في خضم "النقد العلني لقانون إصلاح الأزهر والتأييد العلني له من جانب بعض الأساتذة واتحاد الطلاب", وسألوه عن هذا القانون كان رده أنه "أنكر أن يكون مسؤولاً عن وضعه. وأما حماسته لتطبيقه, فلأنه كان يرى في أكثر مواده خيراً للأزهر, وإنقاذاً له من النسيان وعدم الفاعلية اللذين وقع فيهما منذ ما قبل قيام الثورة".
وقال لهم: "لقد رأيت في القانون الجديد على الأخطاء التي فيه, والناجمة عن جهل لدى واضعية من القانونيين بطبيعة تركيبة البنى العليا بالأزهر, فرصة ذهبية لبث الحياة في أوصال الأزهر, إذ يصبح مؤهلاً لاحتلال موقع محفوظ له في ترشيد التجربة الثورية بمصر بسبب غياب كل المواقع الإسلامية الأخرى تقريباً (الإخوان المسلمون, والشبان المسلمون, والجمعية الشرعية, وأنصار السنة المحمدية). لكن القانون لم يطبق كله بسبب معارضة الشيوعيين التائبين لبعض بنوده من جهة, وبسبب جمود الأزهريين وتقليديتهم من جهة ثانية".
والبهي في سيرته الذاتية: (حياتي في الأزهر: طالباً وأستاذاً ووزيراً) لم يدع أنه واضع القانون ولا أن له دور في خروجه. فهو قد اطلع عليه – كما ذكر – بالصدفة في سنة 1961م, حيث كان في دمشق لحضور ندوة للمجلس الأعلى للفنون والآداب, وكان عضواً فيها بحكم المنصب الذي يشغله, وهو مدير الثقافة بالأزهر. وفي هذه الندوة التقاه محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق, وسأله إن كان اطلع على مشروع القانون الخاص بتطوير الأزهر. فلما أجابه بأنه لم يطلع عليه. ذكر أنه عنده وأنه استلمه من كمال الدين حسين وسيحضره له للاطلاع عليه سراً. وبعد أن اطلع عليه في ذات الليلة أعاده له في صباح اليوم التالي.
ويضيف قائلاً: "لم أسأل بحكم وظيفتي ولا بصفتي الشخصية عن الرأي في تطوير الأزهر. وإنما سألني المرحوم الأستاذ محمد سعيد العريان عن مفهوم الثقافة والبحوث في الإدارة العامة للثقافة. ولم يشر في سؤاله إلى أي شيء يتعلق بقانون تطوير الأزهر".
الأديب محمد سعيد العريان كان وقتها معاراً من وزارة المعارف إلى جامع الأزهر بوظيفة وكيل له, وهو الذي صاغ قانون تطوير الأزهر الذي طرح في مجلس الأمة لمناقشته. واختار شيخ الأزهر محمود شلتوت محمد البهي والشيخ محمد نور الحسن وكيل الأزهر ليمثلانه في شرح قانون تطوير الأزهر. والبهي – كما يذكر ذلك عبد الله إمام – هو الذي تحدث نيابة عن الإمام الأكبر في مجلس الأمة مدافعاً عن قانون تطوير الأزهر. وبعد أيام صدر قرار جمهوري بتعيينه مديراً لجامعة الأزهر.
فالبهي هو الذي قام على تنفيذ قانون تطوير الأزهر من سنة 1961م إلى سنة 1964م, إذ إنه خلال هذه السنوات التي عين فيها في منصب وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر, ظل محتفظاً بوظيفته مديراً لجامعة الأزهر التي عاد إليها مرة أخرى.
أما الشطر الأخير من جملة الباقوري, إذا ما أخذناه بوصفه تقييماً وليس تعليلاً, فهو صحيح. إذ كان هناك – فعلاً – كثرة من الحاقدين على البهي والمعادين له من أساتذة الجامعة ومدرسيها وطلابها.
ويؤكد هذا الأمر رضوان السيد في مذكراته المصرية, فيقول: إن إقالة عبد الناصر له, لقيت ترحيباً من الأزهريين على اختلاف فئاتهم.
ومرد هذا إلى أن الأزهر وقتذاك, يمر بمرحلة انتقال جذرية, وكان الرجل جاداً وحازماً ونظامياً, ومطبوع على المواجهة والمجابهة, وهو إلى ذلك مستقيم ونزيه.
والشاهد على استقامته الأخلاقية ونزاهته المالية أنه خرج من الوزارة دون أن يتملك بيتاً. وأن خصومه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عندما بثوا أقاويل حوله في أوساط الأزهريين لم يكن من بينها ما يمس ذمته المالية, مثلما حصل مع الباقوري حين غضب عليه عبد الناصر. البهي هو من الأزهريين الذين هم مع إصلاح الأزهر وتطويره منذ وقت مبكر, بحكم دراسته في جامعة أوروبية, فهو من خلال هذه الدراسة عرف أن الجامعات الأوروبية هي في أصلها مدارس لاهوتية, ورأى في الغرب كليات ومعاهد لاهوتية تدرس العلوم التطبيقية الحديثة, وهو مع إصلاح الأزهر حين سعى إلى تحقيق شيء منه شيخ الأزهر مصطفى المراغي، وخلفه الشيخ الدكتور مصطفى عبد الرازق، وخلف الأخير الشيخ محمود شلتوت. فهو يصنف نفسه ضمن مدرسة الشيخ محمد عبده الذي هو أول من نادى بإصلاح الأزهر. ومن هنا كان حماسه لتنفيذ قانون تطوير الأزهر.
إننا إن قارنا بين ما قاله البهي في الباقوري وما قاله الباقوري في البهي, سنجد أن الأخير كان الأشد ضغينة وافتئاتاً, والأبعد عن الموضوعية في سرد ما جرى.
يقول عبد الله إمام – وهو يتذكر أيامه مع البهي –: إنه قرأ كتابه (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) الذي أهداه إياه مدير مكتبه الدكتور فتحي عثمان. ويعرف بالكتاب أنه "كتاب هام, وكان في الغالب رداً على الدكتور زكي نجيب محمود".
الكتاب هو – فعلاً – كتاب هام لكنه ليس في أغلبه رد على الدكتور زكي نجيب محمود. فما كتبه عن كتاب زكي نجيب محمود (خرافة الميتافيزيقيا) هو سبع صفحات ونصف الصفحة.
وربما أنه وقع في هذا الخطأ لبعد عهده بقراءة الكتاب, ولأن زكي نجيب محمود هو الكاتب الوحيد الذي رد على ما جاء عنه في الكتاب ضمن مقال كان عنوانه (من معاركنا الفلسفية) جمعه ومقالات أخرى له في سنوات متأخرة في كتابه (من زاوية فلسفية), فعلق في ذهنه حينما قرأ الرد في هذا الكتاب أن كتاب البهي في أغلبه هو رد على زكي نجيب محمود.
إن كتاب البهي لو كان في أغلبه نقد لزكي نجيب محمود لما كان الشيوعيون حاربوه في منصبه وفي كتبه. فأكثر من نقد زكي نجيب محمود هم الماركسيون واليساريون لاختلافهم المنهجي والأيديولوجي معه.
إن الشيوعيين غضبوا على كتاب (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) الذي صدر في سنة 1957م, وعلى صاحبه, ليس لأنه قارن بين طه حسين في كتابه (الشعر الجاهلي) وبين هاملتون جب في كتابه (المحمدية) وانتهى إلى أن طه حسين مثل جب يقول ببشرية القرآن, ولا لأنه نقد على عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم), ولا لأنه – كما أسلفنا – نقد زكي نجيب محمود في كتابه (خرافة الميتافيزيقيا), وإنما غضبوا عليه بسبب نقده للماركسية في باب (الدين مخدر) وبسبب ما كتبه في هذا الباب عن (الماركسية والتجديد في الفكر الإسلامي وعناصر الدعاية الشيوعية في الفكر الإسلامي), فتحت هذا العنوان نقد خالد محمد خالد في كتابه (من هنا نبدأ) ونقد مصطفى محمود في كتابه (الله والإنسان), ونقد أحمد رشدي صالح في كتابه (رجل في القاهرة: ابن خلدون), واعتبر هذه الكتب الثلاثة التي كانت وقتذاك صادرة حديثاً تمثل نشرات للدعاية الشيوعية في مصر.
خالد محمد خالد في تلك المرحلة كان علمانياً دينياً بنكهة ليبرالية اشتراكية, وكان قريباً من اليساريين والشيوعيين, وكان اليساريون والشيوعيون متحمسين لتوجهه العلماني الديني الثوري. ومصطفى محمود في تلك المرحلة كان شيوعياً. وقد احتفى الشيوعيون بكتابه (الله والإنسان) – وكان هو أول كتبه – وكان على راس المحتفين بهذا الكتاب وبالكاتب محمود أمين العالم.
أما أحمد رشدي صالح, فهو شيوعي صميم وعريق منذ منتصف الأربعينيات الميلادية, وعضو أساسي في مجموعة شيوعية اتخذت لها أسماءً متعددة, كالتنظيم والطليعة الشعبية للتحرر وطليعة العمال والطليعة الديمقراطية وحزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري. وكان يشار إليها عند إصدارها مجلة (الفجر الجديد) في سنتي 1945م و1946م, بمجموعة الفجر الجديد. ومجلة الفجر الجديد تعد من الأعمال ذات الشأن في تاريخ الحركة الشيوعية بمصر إبان الأربعينيات. أنشأ هذه المجلة أحمد صادق سعد (اسمه الحقيقي إيزودور سلفادور وهو يهودي مصري وفدت عائلته من تركيا) وريمون دويك (يهودي مصري أصله من حلب) ويوسف درويش (يهودي مصري وهو جد الممثلة بسمة من جهة الأم), وشارك معهم في إنشائها أحمد عباس صالح بعد أن ضموه إلى مجموعتهم. وقد كان هو صاحب الامتياز فيها ورئيساً للتحرير, لسبب عملي أفصح عنه أحمد صادق سعد لرفعت السعيد, فهو – كما قال – "كان أكثرنا قدرة على الحصول على ترخيص لإصدار مجلة, فقد كان والد زوجته على علاقة ما بوزارة الداخلية، وسهّل له الحصول على ترخيص بإصدار مجلة (الفجر الجديد) باسمه" وفي هذه المجلة كانت بداية عمله الصحافي.
ومع إعلان عبد الناصر لسياسة الميثاق واتجاهه الكامل للاتحاد السوفيتي، والإفراج عن الشيوعيين بعد قبولهم لحل الحزب الشيوعي المصري، وانضمام كوادره للاتحاد الاشتراكي أصبح للشيوعيين ولليساريين نفوذ كبير في الاتحاد الاشتراكي والإعلام والثقافة واحتدم الصراع بين اليمين واليسار الموالي لثورة يوليو. وتمكن الشيوعيون من التنفيس عن غضبهم على البهي. فالبهي في جزء مما جرى له كان ضحية استقواء الشيوعيين واليساريين على خصومهم في تلك الآونة الذين ينحون إلى مجابهتهم.