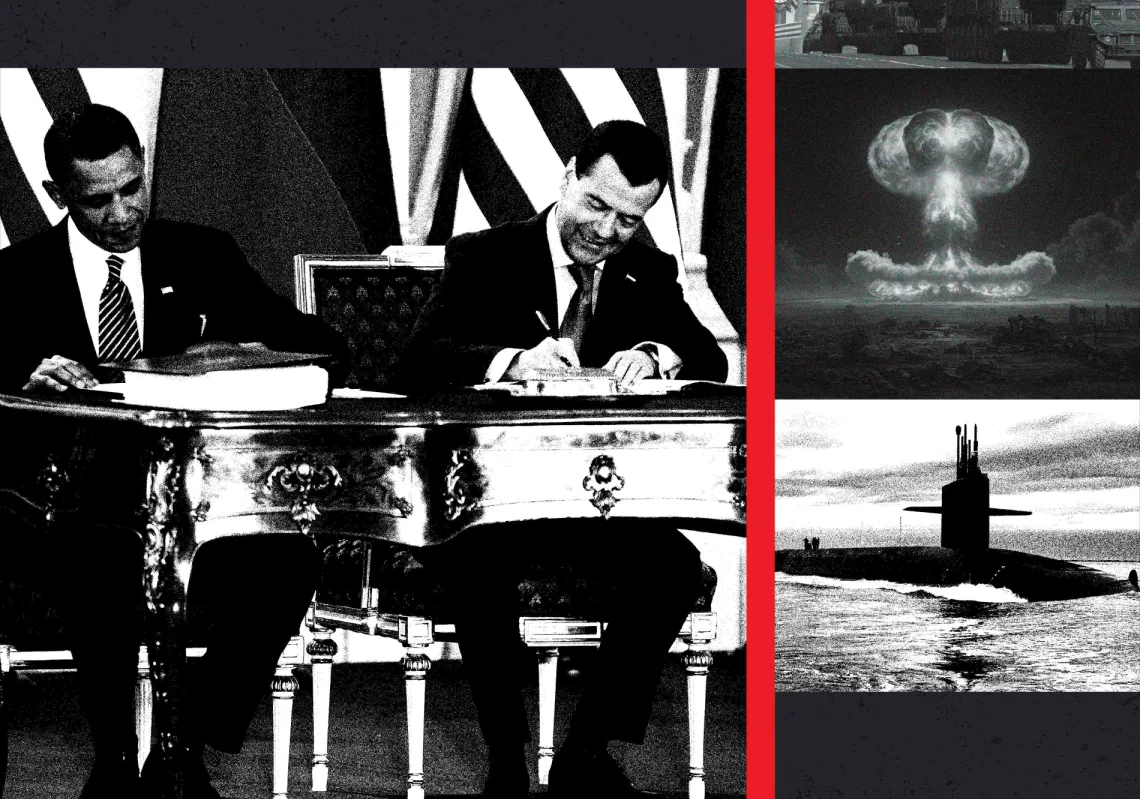هل يمكن اعتبار قرار بريطانيا تصنيفَ "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية غيرُ قابل للتغيير؟
لندن مصممة، كما صرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، ومرد ذلك، هو أفعال طهران "المحلية والدولية"، في إشارة إلى قيام ايران بسحق الاحتجاجات الواسعة النطاق في الأشهر الأخيرة وتدخلّها الذي لا ينقطع في شؤون دول متعددة في أرجاء الشرق الأوسط كافة.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أمس، أن دبلوماسيين في حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن يضغطون على الحكومة البريطانية حتى لا تُدرج بريطانيا "الحرس" في قائمة الجماعات الإرهابية. وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 22 فبراير(شباط)، أن سبب ضغوط واشنطن على حكومة لندن هو الاعتقاد بأن إعلانا كهذا سيضعف العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران، علما ان الخارجية الأميركية قد أدرجت "الحرس" في قائمة الجماعات الإرهابية لسنوات عديدة.
في حال اقدمت لندن على هذا الاجراء، فلن يكون سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأحداث في علاقة عاصفة بين لندن وطهران، تعود إلى بدايات "الثورة الإيرانية" في 1979. وفي السنوات الأخيرة، تعرّضت السفارة البريطانية في طهران للهجوم، واحتُجِزت ناقلات نفط من كلا الدولتين، بينما اعتقل عدد من المواطنين البريطانيين الإيرانيين في إيران، من أبرزهم نازانين زاغري راتكليف. وتفاقمت الأمور أخيرا بإعدام علي رضا أكبري، وهو سياسي إيراني يحمل الجنسية البريطانية، أعدمته طهران في 14 يناير/كانون الثاني، ضاربة عرض الحائط نداءات لندن المتكرّرة للرأفة به.
يمكن، في ضوء ذلك، أن تُعتبر عقوبات بريطانيا جزءا من سلسلة لا تنتهي من التوترات بين البلدين. بل يمكن القول إن لندن تأخّرت إلى حد ما في سلوك هذا النهج، حيث سبقها حلفاؤها الغربيون، الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأوستراليا ونيوزيلندا، إلى تصنيف الحرس "الثوري الإيراني" منظّمة إرهابية. مع ذلك فإن اللافت هو مدى ضآلة التأثير المتوقّع لهذا الإجراء، سواء على الحرس الثوري الإيراني أو على سلوك إيران الإقليمي أو موقفها المحدّد إزاء بريطانيا.
لقد مرّ حين من الدهر كانت بريطانيا فيه قوة دولية رئيسية في الشرق الأوسط، على الصعيدين التجاري والعسكري، لكن قلائل في لندن اليوم يتوقّعون أن تغيّر هذه العقوبة أي سلوك لطهران، ولعلّ غايتها أقرب إلى أن تكون تعبيرا عن الاستياء من أن تكون تهديدا فعليا باتخاذ مزيد من الإجراءات. والحقّ أن قوّة بريطانيا آخذة منذ بعض الوقت في التراجع أكثر منها في الصعود، وقد أسهمت التغييرات الأخيرة في السياق العالمي والإقليمي والبريطاني إلى تسريع هذا الاتجاه الهابط، بحيث باتت لندن في طريقها السريع لتصبح قوة مستنفَدَة في الشرق الأوسط.
من الأمبراطورية إلى مكافحة الإرهاب
كانت بريطانيا في النصف الأول من القرن العشرين أقوى لاعب في الشرق الأوسط، حيث كانت تشرف على بعض أهم القرارات في تاريخ المنطقة الحديث، ولعبت الدور الرئيس في انهيار الأمبراطورية العثمانية، أولا باحتلالها مصر ومنطقة الخليج، ثم من خلال الهزيمة العسكرية التي ألحقتها بالدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
بعد ذاك، قسّمت المنطقة إلى دول قومية على النمط الأوروبي، واستولت لندن وباريس على حصّة الأسد، قبل أن تسهّل قيام دولة إسرائيل من خلال وعدها للقادة الصهاينة بتقديم فلسطين لإقامة وطنهم المنشود على أرضها. قد يجادل المؤرخّون والمعاصرون في سلبيات وايجابيات هذه الإجراءات، التي كان من بينها تمكين كثرة من النخب التي لا تزال تحكم المنطقة إلى يومنا هذا، لكنهم يتّفقون جميعا على أن دور بريطانيا كان بلا جدال دورا كبيرا.
بعد الحرب العالمية الثانية، حلّت الولايات المتحدة محلّ بريطانيا باعتبارها القوة الأبرز في الشرق الأوسط، وساعد على ذلك أولا وقوع أزمة السويس عام 1956 ثم خروج بريطانيا من الخليج في عام 1971، وتحوّل الخصم الخارجي الرئيسي لواشنطن في المنطقة من لندن إلى موسكو. بيد أن ذلك لم يمنع المملكة المتحدة من أن تحتفظ بروابط ثقافية واقتصادية وعسكرية مهمة. وقد تبيّنت أهمية ذلك عندما استعادت المملكة المتحدة شيئا من نهضتها في المنطقة منذ الثمانينات.

مع انتهاء الحرب الباردة، وسّعت الولايات المتحدة وجودها في الشرق الأوسط وأثبتت بريطانيا أنها الحليف الرئيسي لها من خلال تقديم المساعدة العسكرية والدعم الديبلوماسي. ولعبت دورا بارزا في حملة طرد صدام حسين من الكويت عام 1991، وساهمت إثر ذلك في إقامة منطقة الحظر الجوي لحماية أكراد العراق، ثمّ شاركت في غارات عام 1998 على بغداد.
وفي عام 2003 كانت بلا ريب الشريك الرئيس لواشنطن في "تحالف الراغبين" الذي غزا العراق واحتلّه، ما أعاد إلى لندن دورها الفاعل في المنطقة للمرّة الأولى منذ نهاية الأمبراطورية، عندما أنيطت بها إدارة منطقة البصرة. وعلى الرغم من انتهاء وجودها في العراق في عام 2009، عادت إلى المنطقة بعد الانتفاضات العربية عام 2011، أولا للمساعدة في إطاحة معمر القذافي في ليبيا، ثم كجزء من التحالف لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" في العراق وسوريا.