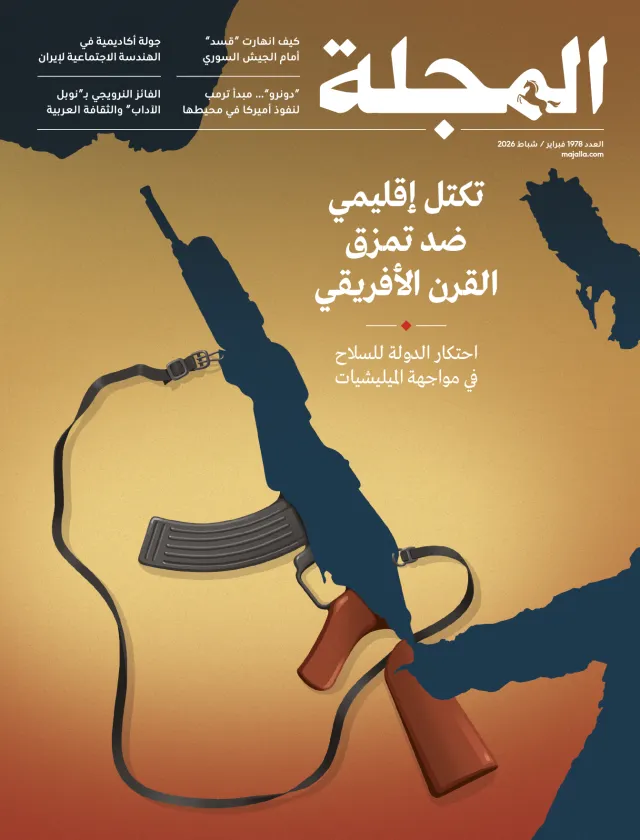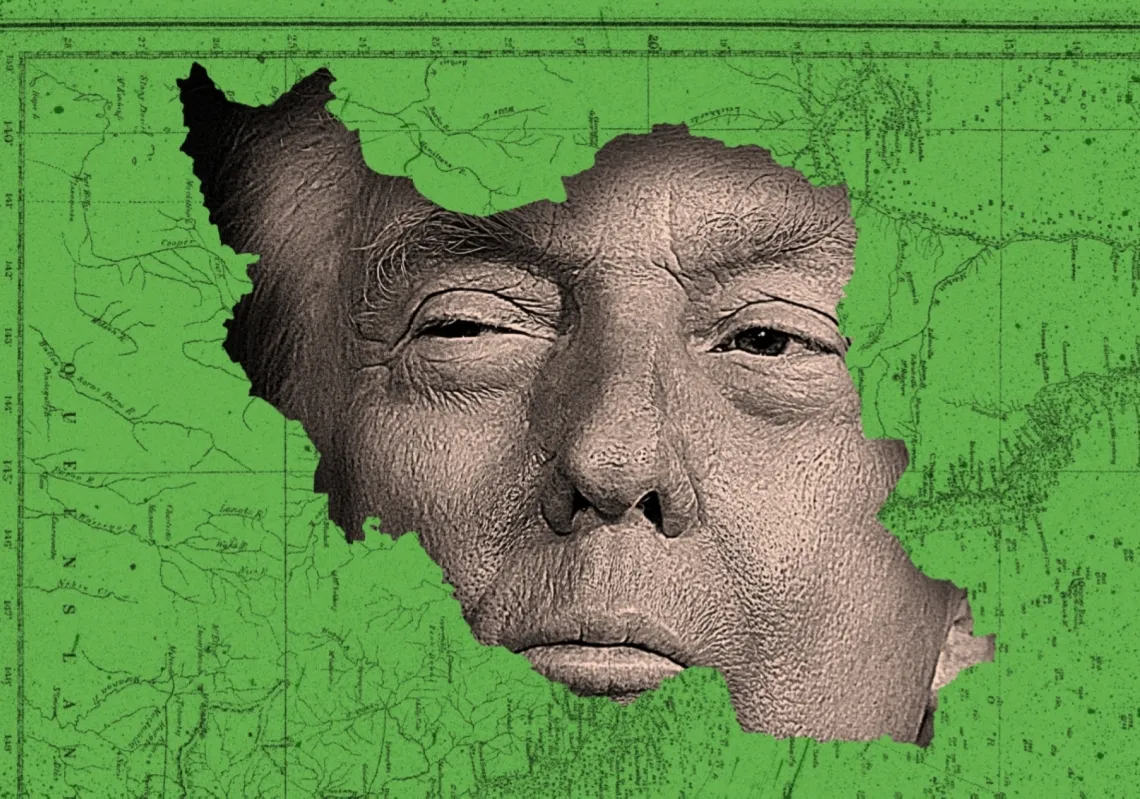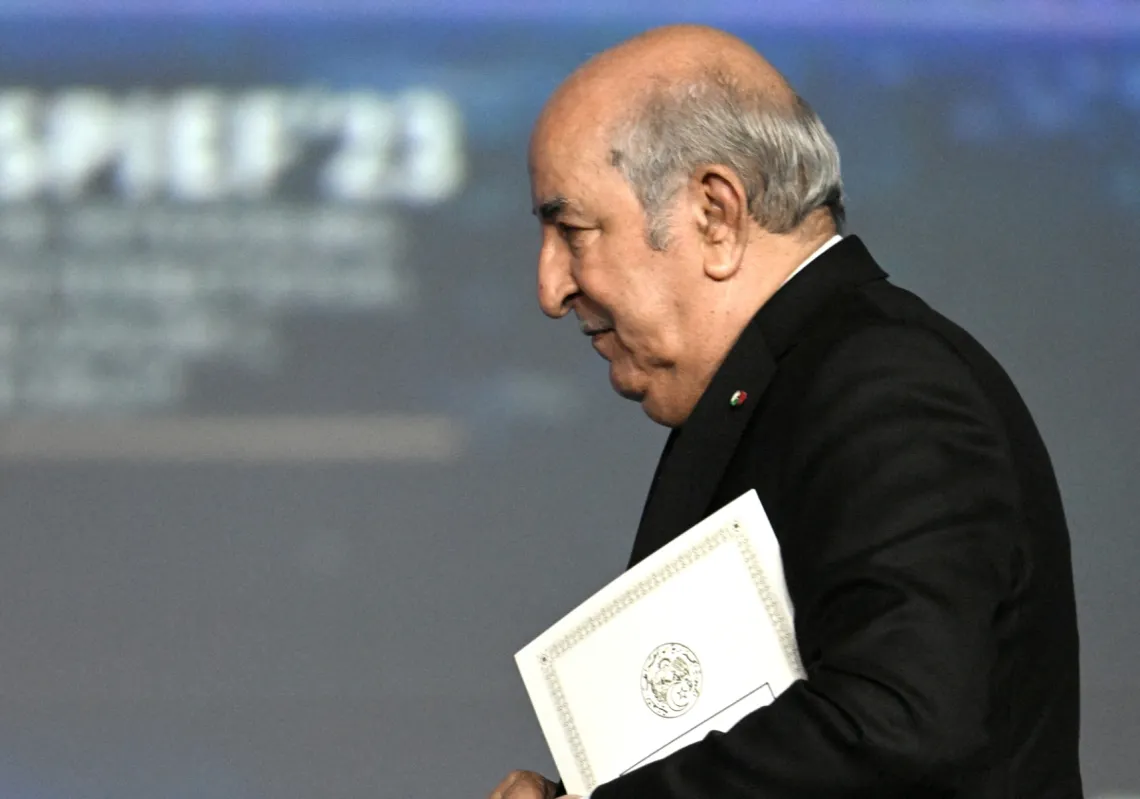لطالما انصب معظم البحث العلمي المتعلق بالتغير المناخي الناتج من الغازات الدفيئة، على طبقة التروبوسفير، وهي الطبقة الأقرب إلى سطح الأرض، لما لها من تأثير مباشر وواسع على الحياة. ولكن ما يجري فوق هذه الطبقة، في الغلاف الجوي العلوي، لم يحظَ بالقدر نفسه من الاهتمام، نظرا لأن آثاره كانت تُعدّ آنذاك هامشية أو غير محسوسة.
غير أن تغيّرا لافتا طرأ أخيرا، مع التوسع السريع في استخدام الأقمار الصناعية ضمن مدار الأرض المنخفض في الاتصالات، والملاحة، والدفاع، والتنبؤات الجوية. فهذا الاعتماد المتزايد، يفرض علينا إعادة النظر في كيفية تأثير التغير المناخي على الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وخصوصا الثرموسفير، وما يعنيه ذلك من ناحية استدامة العمليات الفضائية.
ففي زحمة الحديث العالمي عن تغيّر المناخ وازدحام الفضاء، يكشف بحث علمي جديد عن علاقة غير متوقعة بين القضيتين: انبعاثات الغازات الدفيئة يؤدي إلى تراجع قدرة المدار الأرضي المنخفض على استيعاب الأقمار الصناعية، مما يهدد بتقويض استدامة الفضاء القريب من الأرض.
يعتمد المدار الأرضي المنخفض، الذي يتراوح ارتفاعه من 200 إلى 1000 كيلومتر، على طبقات الغلاف الجوي لتفكيك الحطام الفضائي بشكل طبيعي عبر مقاومة الهواء أو ما يُعرف بـ"السحب الجوي". لكن هذه القدرة تتغير بفعل دورتين، دورة النشاط الشمسي كل 11 عاما، والانبعاثات البشرية لثاني أكسيد الكربون.
فخلال فترات النشاط الشمسي القصوى، تزداد كثافة الغلاف الجوي العلوي، مما يعزز السحب ويقلل عمر الحطام الفضائي. لكن مع انخفاض النشاط الشمسي، تقل كثافة الغلاف الجوي، ويستقر الحطام في المدار لفترات أطول، مما يزيد خطر الاصطدامات.
وهنا تأتي المفارقة. فحتى لو تم ملء المدار بسعة الأقمار المسموح بها خلال "ذروة" النشاط الشمسي، فإن تغير الظروف مستقبلا قد يُدخل المدار في حالة من "الانهيار الفوضوي"، حيث تتكاثر الشظايا والحطام دون توقف.
تناقص الكثافة الجوية
باستخدام نموذج مناخي معقد يُعرف بـ WACCM-X، قاس العلماء كيف تؤثر زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون على الغلاف الجوي العلوي. النتيجة كانت صادمة. ففي حلول عام 2100، سيفقد المدار الأرضي المنخفض جزءا كبيرا من قدرته على استقبال الأقمار الصناعية، خاصة في مستويات الارتفاع الأعلى، بسبب تقلص الغلاف الجوي وتناقص الكثافة الجوية.