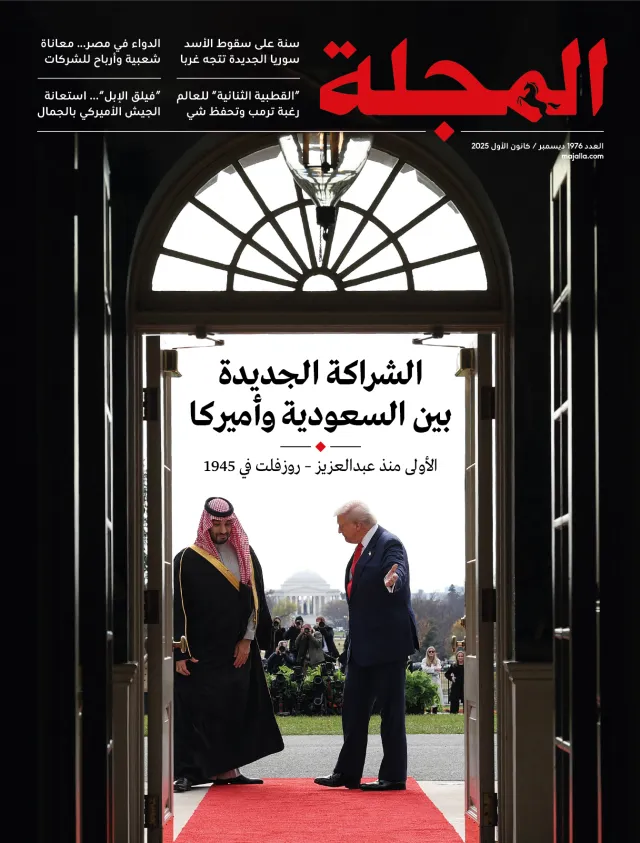بلغت العلاقات الهندية الباكستانية حد الغليان بعد هجوم 22 أبريل/نيسان في باهالغام، البلدة الواقعة في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، وهي منطقة متنازع عليها منقسمة بحكم الأمر الواقع حول ما يُعرف باسم خط السيطرة. وقد خاضت الدولتان سابقا ثلاث حروب في هذه المنطقة.
على أثر الهجوم، انخرط البلدان في قتال هو الأعنف منذ عقود، مع تصاعد الصراع لمدة خمسة أيام وجهت خلالها ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي مميت على جانبي الحدود. وأدى اختبار أسلحة جديدة إلى تصعيد غير مسبوق وامتد الصراع إلى عمق البلدين، ووصل إلى المدن الكبرى لأول مرة.
وأدت سلسلة من الاتصالات والجهود الديبلوماسية إلى هدنة بين الجارتين النوويتين والعدوتين التاريخيتين.
أثارت التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان مخاوف بشأن احتمال نشوب حرب نووية، إذ تمتلك كل منهما نحو 200 رأس نووي. تمتلك الهند نحو 172 رأسا نوويا، بينما تمتلك باكستان نحو 170 رأسا، وفقا لبيانات رابطة الحد من الأسلحة. في عام 1998، اعتمدت الهند سياسة "عدم البدء باستخدام" الأسلحة النووية، ما يعني أنها ستستخدمها للرد فقط، لكنها أعادت النظر في هذه السياسة في السنوات الأخيرة. في حين أن باكستان لا تتبع مثل هذه السياسة.
تشير دراسة أجريت عام 2019، شاركت في إعدادها جامعة "روتجرز"، إلى أن 100 مليون شخص قد يقتلون فورا إذا انخرطت الدولتان في حرب نووية، بل وقد يقتل المزيد بسبب المجاعة الجماعية إذا أدى الصراع إلى شتاء نووي.
في حين أن موازنة الهند وقدراتها العسكرية تفوق موازنة باكستان وقدراتها العسكرية، إلا أن القلق الأكبر كان في شأن الأضرار الجسيمة والخسائر البشرية الفادحة التي كان من الممكن أن يلحقها جيشا البلدين في حال نشوب حرب.
ولا تزال هناك تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق الهش بين الجارتين النوويتين.