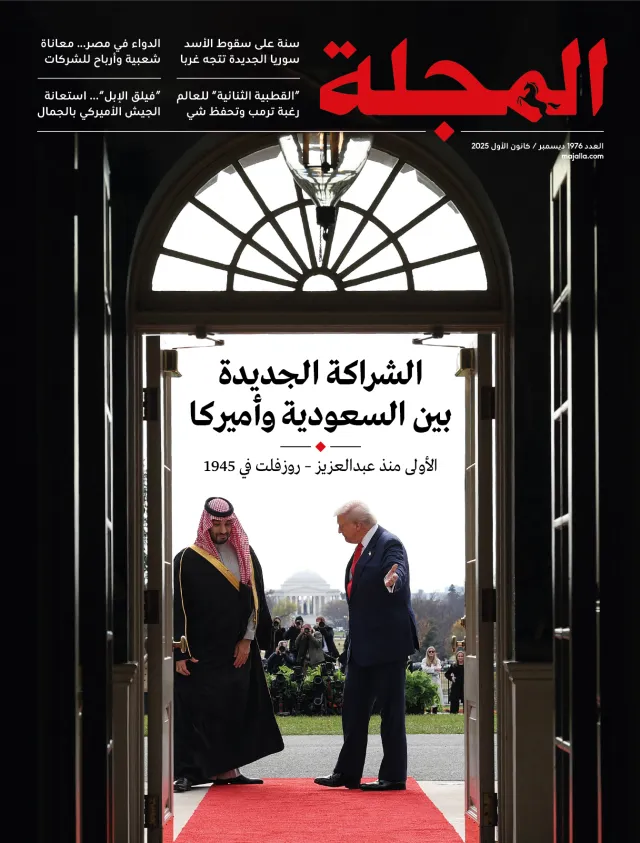لطالما شعرت أن هناك ما يدعو للتوقف والسؤال حين يوصف الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد بأنه من آباء العدمية؟ كيف يُنسب إلى هذا التيار رجل يؤمن بالجنة والنار والحياة في الآخرة؟ نحن أمام فيلسوف هو صاحب نظرية "فارس الإيمان"، فكيف يربط اسمه بهذا الخط الفكري العريض الذي يعرف باسم العدميين إن كان فهمنا للعدمية صحيحا؟
يمثّل كيركغارد لحظة استثنائية في الفكر الفلسفي الغربي، ليس لأنه ينتمي إلى التيار الوجودي فحسب، بل لأنه سعى إلى إعادة تأصيل الإيمان لا بوصفه تسليما عقليا، بل قفزة وجودية تتطلب من الإنسان مواجهة عدميته الخاصة. ففي سياق عيشٍ تغمره المعاني الجاهزة والتكرار الاجتماعي الفارغ، يضع كيركغارد الفرد أمام المرآة القاسية لسؤاله الأكثر رعبا: من أنا حقا؟ هل أعيش على الحقيقة، أم أهرب منها طوال الوقت؟
العدمية تُعدّ تيارا فكريا في الفلسفة، لكنها ليست مذهبا متماسكا أو مدرسة منظمة، بل توجه متشظٍّ ومتعدّد الأوجه، ولهذا يختلف العدميون كثيرا فيما بينهم. بعضهم يرى أن العدمية كارثة روحية مثل دوستويفسكي، ومنهم من يحتضنها كنقطة تحرّر مثل نيتشه، وفيهم من يراها حقيقة معرفية مثل بعض التجريبيين المتطرفين، بينما يستثمرها آخرون في الأدب والسخرية مثل كافكا أو بيكيت.
لكن، العدمية عند كيركغارد تختلف عما تقرر في الفكر الحديث من دعوى انهدام القيم أو انهيار المعايير. إنها عدميّة روحية، تبدأ حين يُدرك الإنسان أنه يعيش على هامش ذاته، مستندا إلى أوهام الجماعة، وسلوك القطيع، وإجابات سريعة تغطي فراغا داخليا هائلا. إن ما يراه كيركغارد خطيرا في الإنسان الحديث ليس جهله، بل وهمه بأنه يعرف. فهو يظن أنه ذات، لكنه في الحقيقة لم يختر ذاته بعد، بل لا يزال يتقمص دورا فرضته عليه الثقافة.
من لا يقلق، هو من لم يبدأ بعد في أن يكون ذاته. ومن يشعر بالأمان التام في عالم خالٍ من الأسئلة، هو شخص لم يواجه بعد غياب الحقيقة الثابتة
في هذا السياق، يُعيد كيركغارد تعريف القلق لا بوصفه مرضا نفسيا، بل بنية وجودية ترافق شرط الإنسان، وتدلّ على أن الذات لم تكتمل بعد. القلق هو ارتعاشة الحرية، لحظة انكشاف الممكن اللامتناهي، حين يدرك الإنسان أنه مسؤول بالكامل عن تشكيل ذاته. أغلب بني الإنسان، بدلا من احتضان هذا القلق، يهربون منه إلى أنماط الحياة السطحية، أو إلى انشغالات أخلاقية أو جمالية، أو حتى إلى أيديولوجيا اجتماعية فارغة من المعاناة الشخصية. ومن هنا تنشأ العدميّة، ليس لأن الحياة بلا معنى موضوعي، بل لأن الإنسان، بكل غفلة وبساطة، رفض أن يعطيها معنى حقيقيا نابعا من قراره الحر.
يميز كيركغارد بين نمطين من التدين، الأول هو تدين تقليدي شكلي، يُمارَس بوصفه جزءا من العادة الاجتماعية، وهو لا ينقذ الذات من عدميتها، بل يغلفها بقشرة من الطمأنينة الزائفة، حيث يظن المرء أن مجرد أداء الشعائر يوصله إلى الخلاص. أما النمط الآخر، فهو التدين الوجودي، حيث لا يكتفي الإنسان بالانتماء إلى طائفة أو اتباع معتقد، بل يدخل في علاقة مباشرة مع الله، علاقة لا يمكن للعقل أن يضبطها ولا للمجتمع أن يتوسط فيها.
في هذا التدين الوجودي، تتجلى العدميّة في أقسى صورها. إنها انعدام الرسوخ أمام اللامتناهي، وشعور المرء بأنه مخلوق متناهٍ أمام كينونة غير قابلة للتمثل أو السيطرة. الإيمان لا ينقذ الذات من هذا الفراغ، بل يجعلها تراه وجها لوجه. ولهذا يقول كيركغارد إن الإيمان ليس راحة، بل عذاب ومخاطرة، وربما ألم لا يزول. فالمؤمن الحق لا يمتلك ضمانا بالخلاص، ولا يستطيع أن يتكئ على نظام عقائدي جامد. بل يخوض كل يوم معركة لكي يُبقي على ذاته، ولكي لا يغيّره المحيط، وسط إغراءات النسيان أو السقوط في تكرار سلوكي خالٍ من الوجود الحقيقي.
ومن هنا نفهم كيف يكون القلق، عند كيركغارد، علامة على الحياة الروحية. إن من لا يقلق، هو من لم يبدأ بعد في أن يكون ذاته. ومن يشعر بالأمان التام في عالم خالٍ من الأسئلة، هو شخص لم يواجه بعد غياب الحقيقة الثابتة، ولم يختبر المأزق الحقيقي للوجود. أن تكون حرّا، لكنك لا تدري كيف تختار. ولهذا، لا يقدّم كيركغارد حلا فلسفيا للعدمية، بل يقدم اقتراحا وجوديا، أن تدخلها بشجاعة، أن تحتمل فراغها، وأن تنتقل من الاستسلام إلى الإيمان.
غير أن هذا الإيمان لا يُبنى على أدلة عقلية، ولا يطلب برهانا. بل هو، كما يقول، "قفزة"، حركة وجودية تتجاوز حدود المنطقي، وتنتقل من اليأس إلى الرجاء، من غياب المعنى إلى تمكين الذات من أن تكون هي نفسها منبعا للمعنى. هذا الإيمان لا يُعطي أجوبة جاهزة، لكنه يمنحك قدرة على الصبر في وجه السؤال، ورغبة في البقاء واقفا أمام العدم.
واللافت أن هذه العدميّة الإيمانية لا تقود إلى النفي، بل إلى نوع من الإثبات السلبي. فالمعنى لا يُمنح من الخارج، ولا ينبع من جوهر ثابت في الذات، بل يتولد من خلال العلاقة المتوترة مع المطلق الذي لا يُمتلك، بل يُطلب دائما من جديد. هكذا يصبح الإيمان دربا دائما، لا محطة للطمأنينة، بل رحلة في دروب التوتر والغموض.
ختاما، فإن كيركغارد لا ينفي أن الإنسان يتمنى الطمأنينة، لكنه يكشف له أن الطمأنينة الحقيقية لا تأتي من اليقين، بل من القدرة على احتمال غياب الأمان. وإن الذات المؤمنة، عنده، ليست تلك التي عثرت على أجوبة، بل التي لم تعد تخاف من الأسئلة. في هذا المعنى، تصبح العدميّة الإيمانية عند كيركغارد فضاء خصبا لتكوين الذات، لا نفيا لها، وتجربة متطرفة في الحرية والمسؤولية، لا مجرد أزمة معنوية عابرة.