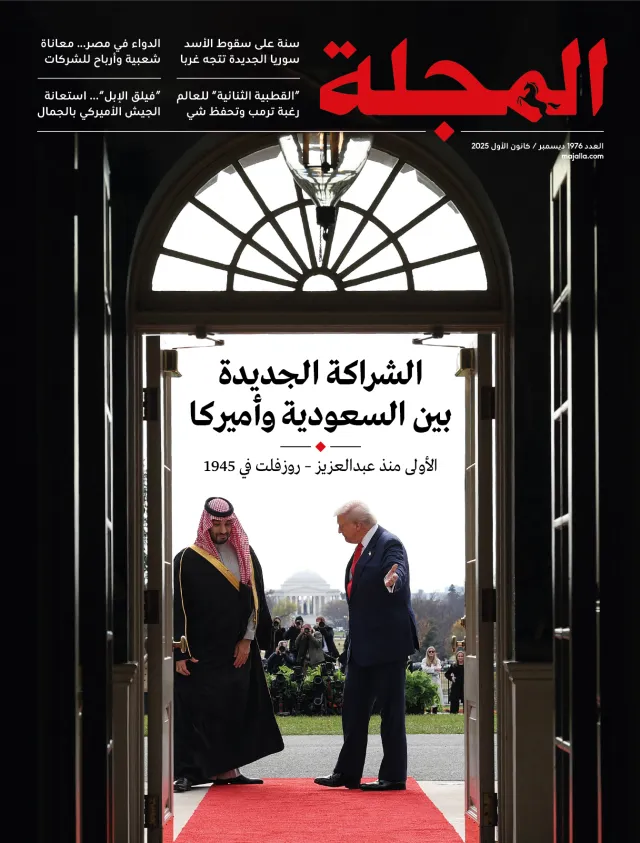لم يتوقف الجدال حول طبيعة العلم وحدوده ومعاييره منذ أن بدأ الإنسان يفكر في موقع المعرفة من الوجود. ولعلّ أبرز ما يثير هذا الجدال هو السؤال: هل للعلم معيار ثابت يقيس صدقيته ويكشف عن حقيقته، أم إن كل ما نُسميه علما ليس سوى بناء نسبي يختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات؟
في قلب هذا السؤال وُجدت أعمال فيلسوف العلم الأميركي لاري لودان، الذي قدّم في كتابه "العلم والنسبوية" نصّا يشبه شكلا "محاورات أفلاطون"، جعل فيه أربعة شخصيات تمثل اتجاهات فلسفية كبرى: الواقعية والوضعية والبرغماتية والنسبية. وكان هدفه إبراز مواطن القوة والضعف في كل اتجاه، مع التركيز على مواجهة الخصم الأكبر وهو النسبية.
يرفض لودان أن تُختزل العقلانية إلى قواعد أبدية ثابتة، كما فعلت بعض التقاليد الوضعية. بل إنه يقترح فهما ديناميا للعقلانية، يقوم على مبدأ القدرة التطورية للنظريات العلمية، فالنظرية الأفضل ليست تلك التي تستوفي قواعد منطقية صارمة، بل تلك التي تحل عددا أكبر من المشكلات بمرور الزمن. من هنا، تصبح العقلانية عنده أداة مفتوحة للتطور، وليست نموذجا جامدا. كما أنه يصر على أن تاريخ العلم لا يتكوّن من قفزات اعتباطية غير مترابطة، بل من سلسلة تراكمية من النظريات المتنافسة التي تُثبت قيمتها من خلال قدرتها التفسيرية والتنبؤية.
غير أن هذه الرؤية لم تمر دون اعتراض. فأصحاب النسبية وجدوا في طرح لودان بقايا من موضوعية متخفية خلف ستار "حل المشكلات". وهم يزعمون أن لودان لم ينجُ من الافتراض القديم بأن ثمة معيارا عقلانيا يتجاوز كل الثقافات، بينما يبرهن الواقع في نظرهم، أن كل معيار مرتبط بسياق تاريخي واجتماعي. بالنسبة إليهم، حتى اعتبار "حل المشكلات" قيمة عليا، ليس إلا انعكاسا لقيمة يتبناها المجتمع العلمي الغربي.
العلم ليس مجرد نشاط ذهني مستقل، بل هو شبكة مؤسسات وسلطات وعلاقات قوة
كذلك، يرون أن لودان يقلّل من شأن البعد الاجتماعي للمعرفة العلمية. فالعلم ليس مجرد نشاط ذهني مستقل، بل هو شبكة مؤسسات وسلطات وعلاقات قوة. وتجاهل هذا الجانب يجعل من النظرية كيانا معزولا، بينما هي في الواقع نتاج صراعات اجتماعية وسياسية وثقافية.
أما حديث لودان عن التقدم العلمي، فأصحاب النسبية يعدّونه "قراءة غير بريئة للتاريخ". إذ لا يوجد تاريخ موضوعي محايد، بل كل قراءة للتاريخ مشروطة بإطارها التفسيري. وبالتالي، ما يراه لودان دليلا على تفوق بعض النظريات، قد يراه نسبي آخر مجرّد إعادة إنتاج لوجهة نظر سائدة تُبرّر انتصار نموذج معين.
من أبرز انتقاداتهم أن لودان، رغم رفضه للنسبية، لم يقدّم أساسا نهائيا صلبا لمعاييره. فمعاييره، مثل القوة التفسيرية أو القدرة على التنبؤ، ليست مطلقة، بل نسبية بدورها، قابلة للتبدّل بمرور الزمن. عندئذ يصبح مشروعه، في نظر بعض النقّاد، نوعا من النسبية المتخفية التي تتلبس بالعقلانية. فالعقلانية عنده آلية إجرائية بلا ضمان نهائي، وهذا يعيدنا إلى دائرة النسبية التي أراد الهروب منها.
يصر لودان على أن هناك فرقا بين نظرية صحيحة وأخرى خاطئة، وإن لم يكن هذا الفرق مطلقا أو أبديا. لكن النسبيين الراديكاليين يرفضون هذه الثنائية من أساسها، ويؤكدون أن ما يُعد خطأ في سياق معرفي قد يكون صوابا في آخر، دون وجود معيار فوقي يحسم المسألة. من هنا يلتقون مع بعض اتجاهات علم اجتماع المعرفة التي ترى أن قبول النظريات أو رفضها نتاج عوامل اجتماعية محضة.
يستشهد لودان بتاريخ العلم ليبرهن أن التغيرات العلمية لم تكن اعتباطية، بل قامت على أساس تقدم حقيقي في الفهم. غير أن أصحاب النسبية يعترضون بأن هذا التاريخ ذاته ليس سوى رواية واحدة ممكنة، تخدم في الغالب إضفاء الشرعية على المسار الذي انتهى إلى سيادة النموذج الغربي المعاصر. فهم يتهمونه بتثبيت "استقرار زائف" للمفاهيم المعيارية كالصدق والتقدم والتفسير الأفضل، حفاظا على موقع المؤسسة العلمية السائدة.
تتضح أهمية الحوار الفلسفي مع النسبيين، فهو لا ينتهي إلى غلبة قاطعة لطرف على آخر، بل يفتح الطريق أمام فهم أكثر تواضعا لطبيعة العلم نفسه
مع كل هذه الاعتراضات، يبقى لودان بعيدا عن الدوغمائية الصلبة. فهو لا يدّعي وجود معيار واحد نهائي يقيس الحقيقة العلمية، لكنه أيضا يرفض التسليم بأن جميع المعايير متساوية القيمة. إنه يبحث عن موقع وسطي، يقر بتعدد المعايير لكنه يخضعها للتقييم العقلاني. بهذا الشكل، يترك الباب مفتوحا أمام النقاش والتفاضل، دون أن ينزلق إلى لامبالاة نسبية تساوي بين جميع المواقف.
يكشف الجدل بين لودان والنسبيين عن عمق مأزق فلسفة العلم المعاصرة، فلا الواقعية الصلبة التي تزعم وجود حقيقة مطلقة مطمئنة، قادرة على إقناع الجميع، ولا النسبية الراديكالية التي تذيب كل المعايير في بحر من التعدد، تستطيع أن تقدّم أساسا للحوار العقلاني. وبين هذين الحدّين يحاول لودان أن يشق طريقا ثالثا، يعترف بنسبية المعايير من حيث الزمان والسياق، لكنه يصر على أن هذه النسبية لا تلغي إمكان المفاضلة ولا تبرر الفوضى.
ولعل قيمة مشروعه تكمن في أنه يذكّرنا بأن العلم ليس لعبة لغوية مغلقة على نفسها، ولا حقيقة سرمدية مفصولة عن التاريخ، بل مسعى إنساني عقلاني يتطور عبر الصراع والنقد، ويتقدم ما دام قادرا على حل مشكلات جديدة وتفسير ظواهر لم تُفسّر من قبل. وهنا، تتضح أهمية الحوار الفلسفي مع النسبيين: فهو لا ينتهي إلى غلبة قاطعة لطرف على آخر، بل يفتح الطريق أمام فهم أكثر تواضعا، وأكثر برغماتية، لطبيعة العلم نفسه.