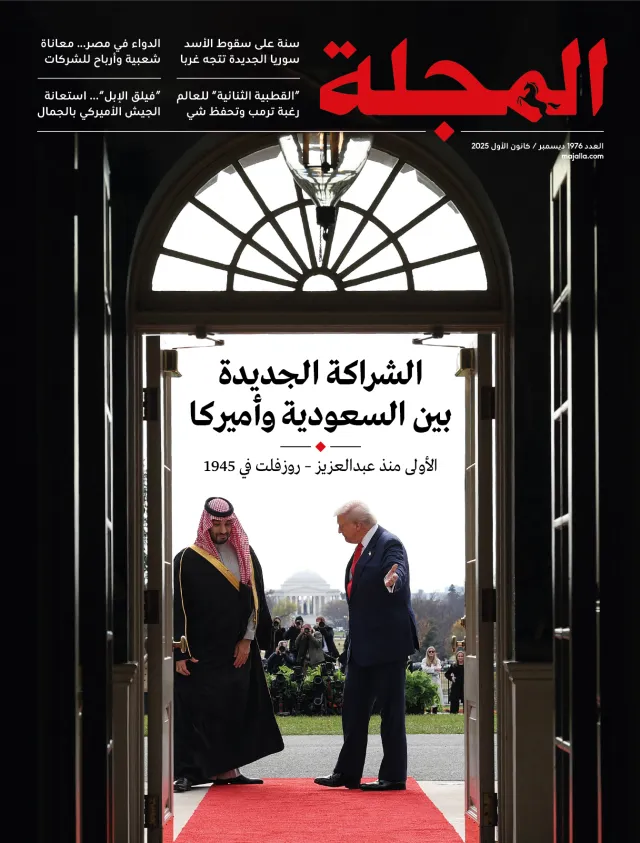لم يكن التصوف حكرا على المتصوفة الصرحاء الذين انتموا إلى المدارس الدينية أو الفلسفية المعروفة، بل تسلل إلى قلب الشعر الإنكليزي، واتخذ لنفسه لغة خاصة، شفافة ومكثفة، تحتفي بالجمال والحدس والانخطاف، وتكشف عن الحضور الإلهي في العالم الطبيعي، أو في النفس العاشقة المتأملة.
كان التصوف في تجربة الشعراء الإنكليز، خاصة في العصر الرومانسي، مزيجا من الإشراق الداخلي والرغبة في الاتحاد بعالم أعلى. وما يميز هذا التصوف الشعري عن التصوف الفلسفي أو اللاهوتي أنه لا يعتمد على منظومة عقائدية دقيقة، بل يتشكل من التجربة الحية، ومن لحظات التجلي التي تنبثق فجأة في قلب الشاعر وهو يتأمل زهرة أو يستمع لصوت الريح أو يستيقظ على فيض من الإلهام الغامض.
في طليعة هؤلاء الشعراء يأتي وليام بليك، الشاعر والرسام والرائي الذي رأى في الخيال قوة إلهية، لا مجرد أداة فنية. كان بليك يعتبر أن "الخيال ليس حالة من الحالات، بل هو الوجود الإنساني نفسه". في قصائده ونقوشه، يظهر التصوف في صور الرؤى والرموز والملائكة والمخلوقات الأسطورية. لم يكن يرى المطلق ككيان خارجي مفارق، بل كان يؤمن بأن الألوهة تنبثق من الداخل، وأن الإنسان يحمل في ذاته شرارة الأبد. قصيدته الشهيرة "أغاني البراءة والتجربة" تكشف عن نظرة مزدوجة للعالم، حيث تختلط البراءة بالمعاناة، ويصبح الشر طريقا للمعرفة، لا لعنة مطلقة. التصوف عند بليك هو احتجاج على النظام العقلاني الميكانيكي للعصر الصناعي، ونداء لاستعادة البصيرة الطفولية، التي ترى في كل شيء تجليا للمقدس.
أما وليام وردزورث، فيمثل الجانب الطبيعي من التصوف الشعري الإنكليزي. في قصيدته الرائعة "خطوط مؤلفة قرب دير تنترن"، يصف كيف أن الطبيعة ليست مجرد مشهد خارجي، بل هي حضور حي، "روح سامية"، تمنح الإنسان الطمأنينة والرؤية. كان وردزورث يرى أن للطبيعة قدرة على تهذيب النفس، وعلى إعادة الإنسان إلى بساطته الأولى. لم يكن يتحدث عن المطلق على أنه لاهوت، بل بوصفه تناغما داخليا مع الكون، وانسجاما بين العقل والعاطفة، بين الإدراك الحسي والتأمل الروحي. ولذلك يمكن القول إن تصوف وردزورث هو تصوف تأملي، هادئ، لا يقوم على الوجد والصراخ، بل على السكينة العميقة والانخطاف الصامت في وجه الجمال الطبيعي.
التصوف عند بليك هو احتجاج على النظام العقلاني الميكانيكي للعصر الصناعي، ونداء لاستعادة البصيرة الطفولية التي ترى في كل شيء تجليا للمقدس
أما صامويل تايلر كولريدج، صديق وردزورث، فمزج التصوف بالفلسفة الألمانية والمثالية الأفلاطونية. في قصيدته "نشيد البحار العتيق"، يظهر البعد الصوفي في تجربة الألم والخطيئة والغفران، حيث يمر البحار برحلة من الغرور إلى التوبة، ومن الانفصال عن العالم إلى إعادة الاندماج فيه من خلال الحب والرحمة. كان كولريدج يعتقد أن الخيال الحقيقي هو "القدرة على إدراك الوحدة في التعدد، واللامتناهي في المحدود". وقد اقترب كثيرا من التصوف المسيحي في أفكاره، لا سيما في فهمه للعلاقة بين الإنسان والمطلق، وبين الزمن والأبد.
أما ألفريد لورد تنيسون، الشاعر الفيكتوري الكبير، فقد قدم نموذجا فريدا للتصوف التأملي، يتميز بالهدوء والعمق والاحتضان العاطفي للحيرة. في مرثيته الطويلة "في ذكرى آرثر هنري هالم"، يرثي صديقه الحميم الذي مات شابا، لكن المرثية لا تكتفي بالتعبير عن الحزن، بل تتحول إلى رحلة وجودية عبر الزمان والروح، باحثة عن المعنى والبعث والحضور الإلهي. يتأمل تنيسون الموت لا كخاتمة، بل كبوابة إلى عالم أرحب، ويكتب بصوت ينوس بين الإيمان والشك، وبين الرجاء والفقد، في محاولة لمصالحة العلم الحديث مع الأمل الروحي. وفي مقاطع عديدة، يصل إلى نوع من الكشف الصوفي، حيث تنفتح النفس على اللامرئي، وتلوح لمحات من "الله في داخلي"، ومن الحضور المتعالي الذي لا يدرك بالحواس بل بالحدس. يقول مثلا:
"أقترب من الله أكثر من خلال الألم،
من خلال ظلمة القلب التي تنفتح،
حيث لا برهان، بل نور داخلي يتكلم".
تأثر تنيسون بالتقاليد المسيحية، لكنه تجاوزها أحيانا نحو حدس شخصي للسر الأعظم، وكان يقول في تأملاته الخاصة إنه "اختبر حالة من الفناء الذاتي في الكل"، وهي تجربة تكاد تتطابق مع ما يصفه الصوفية المسلمون بفناء الذات في الحق. وكان يؤمن بأن الشعر هو الوسيلة الوحيدة للقبض على هذه التجربة الطفولية النادرة، حيث يختفي الزمن، ويصير كل شيء في لحظة واحدة من الإدراك الخالص.
وإذا انتقلنا إلى القرن العشرين، نجد أن التصوف لم يختف من الشعر الإنكليزي، بل اتخذ أشكالا جديدة، أكثر تعقيدا وتركيبا. توماس ستيرنز إليوت، في قصيدته الكبرى "الأرض الخراب"، يعبر عن عطش روحي هائل وسط أنقاض الحضارة الحديثة. وعلى الرغم من أن مظهر القصيدة يبدو سوداويا، فإن قاعها مملوء بإشارات صوفية، هندوسية ومسيحية، تشير إلى إمكانية الخلاص، ولو عبر الصمت والتطهر والموت الرمزي. أما في "الرباعيات الأربع"، فتتبلور النزعة الصوفية أكثر، وتظهر التأملات في الزمن والأبد، والحركة والسكون، والبحث عن النعمة في "نقطة السكون التي تدور فيها كل الدوائر".
لا يمكن فهم الشعر الإنكليزي العظيم دون إدراك هذا البعد الصوفي فيه، لأنه هو ما يمنحه عمقه الباطني، وما يحول اللغة من أداة وصف إلى وسيلة عبور
لم يكن تصوف الشعراء الإنكليز طائفيا، ولا محدودا بإطار ديني ضيق. كان انفتاحا على ما لا يقال، توقا إلى ما وراء اللغة، سعيا إلى الكشف لا إلى الإقناع، احتفاء بالمجهول لا تفسيرا له. ولهذا السبب، تلتقي هذه التجربة الصوفية الشعرية عند بليك ووردزورث وكولريدج وتنيسون وإليوت مع تجارب روحية من الشرق والغرب، ومع تراث المتصوفة الكبار من أمثال جلال الدين الرومي وابن عربي ومولانا جمشيد وشانكارا. إنهم جميعا، عبر لغات مختلفة، يبحثون عن الحقيقة التي لا تحاط، وعن النور الذي يسطع في الداخل، لا في الخارج.
وهكذا، لا يمكن فهم الشعر الإنكليزي العظيم دون إدراك هذا البعد الصوفي فيه، لأنه هو ما يمنحه عمقه الباطني، وما يحول اللغة من أداة وصف إلى وسيلة عبور، من حدود الحواس إلى رحابة الروح.