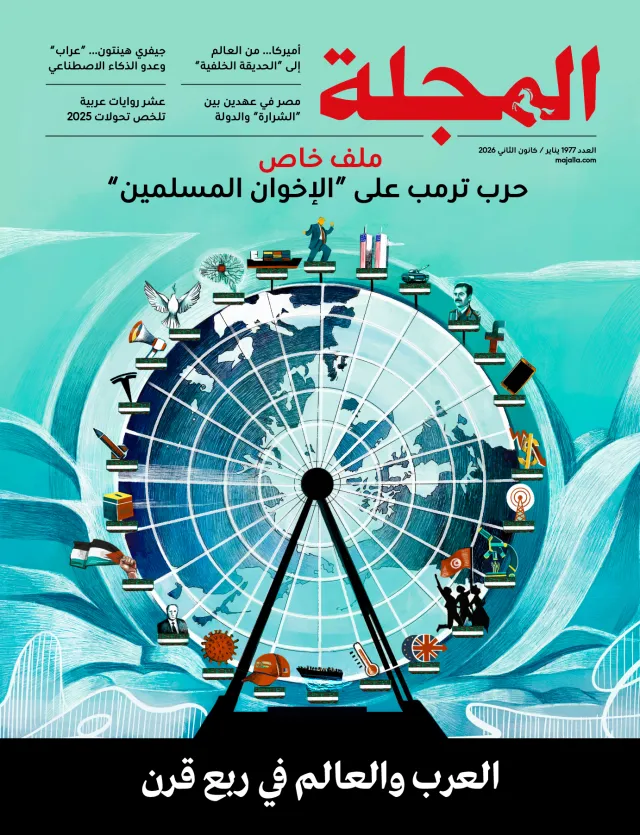أسقطت التطورات المتسارعة والأزمات غير المسبوقة التي ضربت العالم منذ ظهور فيروس "كوفيد-19" وما تلاها من اضطرابات وحروب، الكثير من المنظومات الفكرية والعمارات الفلسفية والثقافية والسياسية. بدا الحدث متجاوزا القدرة على الإمساك به والتنظير حوله والتنبؤ بما سيسفر عنه. في هذا البحر المتلاطم من العمى برزت أسماء قليلة لا زال أصحابها قادرين على مدنا بوسائل للتفكير في ما يحدث في عالمنا ومحاولة تفسيره.
وكان عالم النفس والفيلسوف الإنساني إريك فروم قد أطلق مصطلح "النزوع النكروفيلي" لتفسير ما يجتاح البشرية من نزوع تدميري، وقد وسّع معناه من حدوده المباشرة المرتبطة بالانجذاب الجنسي إلى الجثث ليجعله نزوعا شاملا يتغذى من العداء لكل ما هو حي ومتحرك وحيوي وفاعل والانجذاب نحو كل ما هو ميت وجامد ومتعفن وقذر.
ولا يتعامل فروم مع هذا النزوع في إطار الاعتلال الفردي بل يؤكد أنه بنية ثقافية عميقة تصيب مجتمعات ودولا وكيانات. ويعكس وضع العالم اليوم نموذجا نكروفيليا عميقا ينحاز إلى الآلة والتقنية على حساب الحياة نفسها ويؤمن بالخراب والقتل بشكل إبادي لا يستجيب لمخاوف أو تهديدات بل يمثل غاية في حد ذاته.
ما يحدث في غزة يقدم مثالا ساطعا على أصالة هذا النزوع، إذ تجاوز عدد الأطفال القتلى الـ30 ألفا، ودمرت المستشفيات والأفران، وقتل المئات من العاملين في القطاع الصحي ومئات الصحافيين، واستخدم سلاح التجويع الذي يؤدي إلى موت يومي قاس. كل هؤلاء الضحايا لا يمثلون تهديدا وقتلهم المقصود والمبرمج ليس سوى استجابة لذلك النزوع الذي لا يجد اللذة والراحة سوى في تعميم الموت والدمار. ليس أدل على ذلك من ارتفاع نسبة التأييد للحرب بشكلها الإبادي في وسط الإسرائيليين وظهور الكثير من التعليقات والخطابات التي تمجّد إفناء غزة وقتل الفلسطينيين وتستنكر محاولات وقف الحرب.
يقدم هذا المثال نموذجا للمجتمع النكروفيلي الذي لا يمكنه العيش سوى في ظل الحطام والذي يؤمن بأن التفوق التقني والحربي يخلق تفوقا أخلاقيا يتيح غلبة السردية وإماتة قصة الآخر بقتله وتدمير مدنه.
كل هؤلاء الضحايا لا يمثلون تهديدا وقتلهم المقصود والمبرمج ليس سوى استجابة لذلك النزوع الذي لا يجد اللذة والراحة سوى في تعميم الموت والدمار
ولكن مفارقة بارزة تظهر من خلال كل هذا الهول، تتمثل في أن هذا المشهد النكروفيلي أحيا في العالم النزعة المضادة التي يسميها فروم "البيوفيليا"، إذ انتشرت مظاهرات واسعة وبرزت في جُلّ مدن العالم تحرّكات تندد بما يجري من زاوية إنسانية وأخلاقية وثقافية ما فوق سياسية، وكان لافتا أن المواقف المستنكرة والمُدينة ترفض الوقوع في فخ تقزيم المشهد إلى أزمة سياسية أو تصعيد حربي أو رد فعل وتصر على توصيفه بأنه إبادة تستهدف الإنسانية.
ويمكن التدليل على كيفية خلق مجتمعات نكروفيليّة تؤمن بالموت في النموذج الذي عمم في لبنان الذي لم يغادر قط لحظة الخراب والموت. تعمق التوجه نحو الخراب والعنف والقذارة وانتشر حتى صار صيغة عمومية تنتشر في الاقتصاد والثقافة والخطاب وفي المشهد العام.
النزعات النكروفيليّة لطالما كانت تمثل الثقافة الكامنة وراء جلد كل الجماعات اللبنانية ولكنها كانت تشهد موجات صعود وهبوط قياسا بلحظات القوة والضعف. ومنذ الثمانينات سيطر على البلاد تيار مسلح تشكل ما يسمى النظام اللبناني تحت سلطاته وبالتفاهم معه.
تحت ظل هذه السلطة نما توجه عام يرى في العنف والتمويت الإبادي للآخر وإشاعة الخراب والفقر الشكل الأكمل لبناء السطوة والمكانة. يمكن تلمس معالم هذا النمط السيكولوجي العميق في كثير من المواقف والأحداث التي سيطرت على المشهد في لبنان. في بعض المدارس يُحرَم الأطفال من أسمائهم وصفاتهم، ويُجبَرون على الإجابة عن سؤال هويتهم بكلمة "شهيد" أي إن حيواتهم وطفولتهم وطموحاتهم مشدودة إلى الموت كهدف وغاية.
سرقة أموال المودعين التي أخرجت جزءا كبيرا من الناس من دائرة الفعالية الاقتصادية وحولتهم إلى متسولين وأفقدتهم جنى أعمارهم والبعض منهم مات فعلا بسبب عجزهم عن تأمين كلفة الاستشفاء، كانت قتلا منظّما تم تحت عباءة ذلك النظام.
خلال الحرب الإسرائيلية خرج الخطاب عن حدود الخلاف أو الصراع ليتحول إلى نزعة عميقة تطالب بإبادة مكوّن كامل بشكل مباشر وعلني، كما كانت الشماتة المتبادلة بمصائب الآخرين جزءا من التخاطب اليومي الشائع بين مختلف المكونات.
في بعض المدارس يُحرَم الأطفال من أسمائهم وصفاتهم، ويُجبَرون على الإجابة عن سؤال هويتهم بكلمة "شهيد"
ولعل الارتباط بالقذارة يتجلّى بأبهى صوره في ما حل بلبنان في الفترة السابقة ولا يزال قائما بمستويات مختلفة، إذ انفجرت أزمة قمامة جعلت المكان كله كتلة متصلة بالتعفن والموت، وكان أكبر رقم قياسي يسجل في لبنان خارج مهرجانية أكبر طبق حمص وأكبر سندويش لبنة وأكبر طبق فتوش هو مشهد أوتوستراد طويل تصطف فيه أكياس القمامة كحيوان زاحف خرافي لا بداية له ولا نهاية.
كل ذلك يجعل الناس في لبنان كائنات نكروفيليّة بالقوة تحتاج إلى بيئة حاضنة وهي غير موجودة في لبنان إلا من خلال نزوعات فردية يقرر أصحابها العودة إلى الفن والطبيعة والإيمان بقوة اللطف والتعاطف رغما عن كل شيء.
ويقدّم الفلسطينيون في غزة مشهدا بليغا، نبكي حين نشاهد ما يحل بهم من وراء شاشاتنا، نخلق بذلك حجابا سميكا بيننا وبينهم يؤكد لنا أننا في موقع الناجين وننفصل عنهم، ولكنهم لا يبكون، بل يصرخون ويطالبون ويشتمون، ونراهم يساعدون بعضهم بعضا بثمن غالٍ أقله التعرّض للقتل، ليثبتوا أن قوة الحياة قادرة على تحويل الإبادة إلى حدث عارض وعابر.