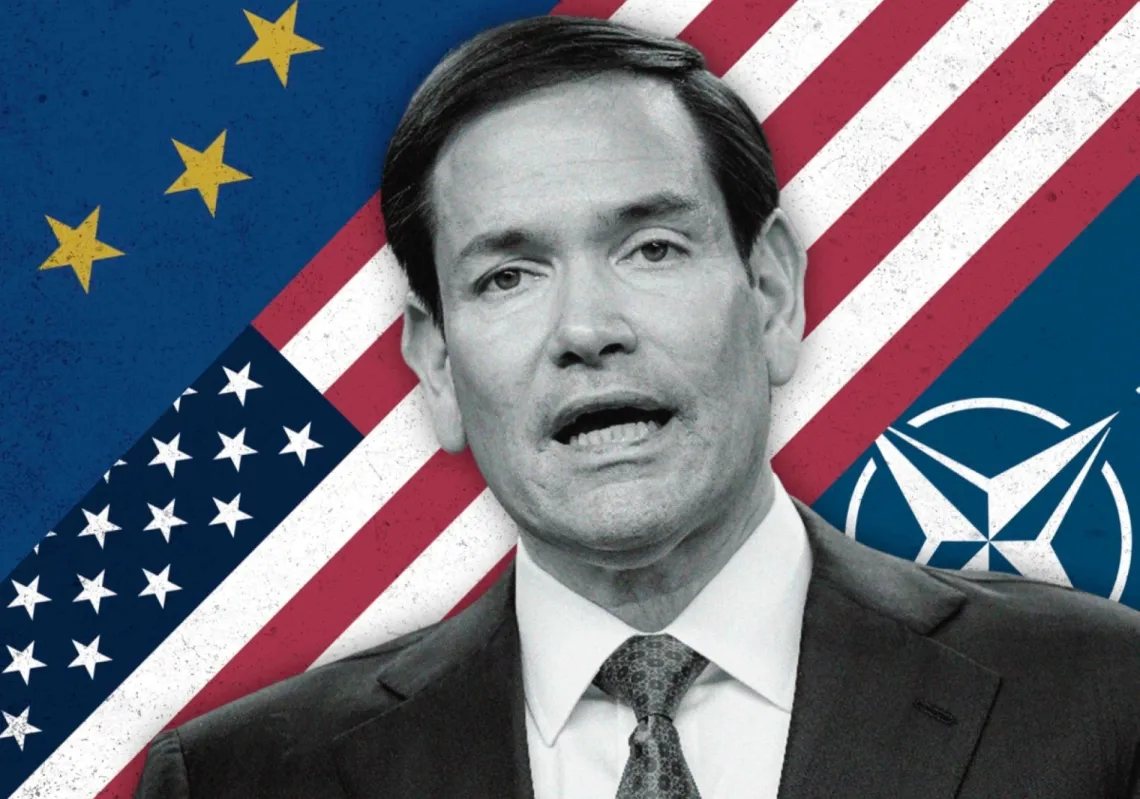«ارحل، ارحل، ارحل». في الأيام الأولى من شهر يناير (كانون الثاني)، تردد ذلك الشعار، الذي سوف يهدد حكم الفرد في الشرق الأوسط، في شوارع تونس، في ما كانت الجماهير التي ملأت الشوارع الواسعة أمام وزارة الداخلية تقدم رسالة باسم الجماهير إلى رئيسها المزدرى، الذي استمر في الحكم لمدة 23 عاما. «ارحل». لقد مثل ذلك الشعار الجديد في تونس بالنسبة لكثيرين صحوة سياسية أو حافزا طال انتظاره.
فبعد سنوات من القمع، والإهانة، والعنف، والإقصاء من الحياة السياسية والاقتصادية، نزل التونسيون إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المدنية بكلمة واحدة، في ترديد جماعي بدأ همسا ثم انضمت له تدريجيا أصوات آلاف المحتجين، وأخذ يعلو ويعلو ويعلو حتى انتهى إلى تحويل الشعار إلى واقع.
لم يكن لكلمة ارحل من قبل مثل ذلك التأثير. فعندما كانت الجماهير تصيح ارحل، تولد إحساس بالتوحد بين التونسيين من الخلفيات كافة. وقد أثبتت قدرتهم على إنهاء نظام بن علي أن أقوى رجل في الدولة اضطر إلى الانصياع إلى إرادة الشعب.
وقد أثبتت عناصر القوة المطلقة، السيطرة على القوى الأمنية، وكل المصادر التقليدية للسلطة في يد الرئيس المخلوع بن علي، عدم فعاليتها في مواجهة الوحدة التونسية. وتأثرا بذلك الانتماء الجديد، واجهوا القناصة، وقنابل الغاز، والاعتقال من أجل التخلص من بن علي.
وكان يمكن أن تستشعر الكبرياء والوطنية اللتين انبعثتا من الأيام الأولى ليناير (كانون الثاني) في الهواء. فقد كانت كل الحوارات التي يعج بها الشارع تتمحور حول المستقبل، والآن وبعد رحيل مبارك، يشعر التونسيون، وهم محقون، بأنهم قد ألهموا الآخرين بشجاعتهم. وعلى الرغم من الإحساس السائد بالتفاؤل، ما زالت ثورة الياسمين في بدايتها.
وعلى الرغم من الأمل الذي يعقده التونسيون على المستقبل، فإنهم واعون بأن الطريق إلى الاستقرار الديمقراطي ما زال طويلا للغاية. ومن مفارقات الثورة أن مظلمتين من مظالم التونسيين التي أدت إلى الانتفاضة سوف يكون لهما تأثير طويل المدى على قدرة التونسيين على خلق ثقافة ديمقراطية وإدارة حكم رشيد، وذلك بالضبط هو مستوى القمع الذي فكك المعارضة وثقافة الفساد التي خلقتها السلطة المطلقة للنخبة الحاكمة.
فعلى الرغم من تضحية الزعماء السياسيين بالمجتمع المدني في تونس منذ أول رئيس لها، فقد تم إسكات أصوات الصحافيين، والنقابيين، والمدافعين عن الحقوق المدنية والإنسانية في عهد بن علي. ففي عهد بن علي، لم تكن جماعات المجتمع المدني بداية من الصحافيين إلى المحامين والقضاة تعمل باستقلال من دون الخوف من التدخل البيروقراطي أو الإيذاء. ولا حاجة للقول إن مسألة الخوف قد تم القضاء عليها خلال الثورة، عندما أظهر كل تونسي استعدادا لمواجهة الحكومة. ومع ذلك فإن ملاحظة مدى القمع ضرورية في فهم كيف كان حشد تلك الجماهير ممكنا، فقد تخلص التونسيون من الخوف الذي يصاحب الانتماء للمعارضة، ولكن أيضا كم العمل المطلوب لإعادة بناء المجتمع المدني والقيم الديمقراطية.
قبل الثورة، كان هناك ما يزيد عن 9000 منظمة مجتمع مدني مسجلة في تونس، وفقا لمركز المعلومات ودراسات التدريب والتوثيق حول الجمعيات. ومن بين تلك المنظمات، لم تكن هناك سوى حفنة مستقلة استقلالا كاملا ولم تكن أي منها تستطيع أن تتحرك بحرية بعيدا عن تدخل الحكومة.
وعلى الرغم من أن الدستور التونسي، نظريا كان يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، حرمت الجماهير عمليا من ممارسة تلك الحقوق. فقد كانت الحكومة دائما ما تحاكم الأفراد نظرا «لنشر معلومات خاطئة» بزعم أنها سوف تهدد النظام العام. وفي ظل تلك الظروف، فإن صعوبة المشاركة في الاحتجاجات أو أي أعمال جماعية ليست بالأمر المفاجئ، وهو ما يجعل من ثورة يناير أكثر إبهارا. وبالحديث مع التونسيين في الأيام الأولى للثورة، كانوا دائما يقولون إنهم قد تخلصوا من الإحساس بالخوف الذي كان يسود البلاد. وربما لم يستطع أي ثوري أن يصدر ذلك الإحساس بخلاف محمد البوعزيزي الذي لم ينظر إلى قتله نفسه باعتباره مجرد رد فعل للإحباط الاقتصادي. فهل يوجد خوف أكبر من الخوف من الموت؟ لقد اختار البوعزيزي بطريقة علنية الموت بدلا من الخوف، وباختياره ذلك ألهم أمته بأسرها لكي تحذو حذوه.
ربما يكون التونسيون قد تغلبوا على واحدة من أصعب عقبات سلطة الفرد، الاستعداد للمخاطرة بالأمن من أجل الحق في التعبير عن الذات. ومع ذلك فإن حقيقة أن تاريخ البلاد المستقلة بكامله يتميز بقمع المجتمع المدني تعد من العقبات المهمة التي يجب أن تتغلب عليها البلاد إذا ما كانت ترغب في تحقيق تغير دائم.
وعلى الرغم من أنه تم تفكيك الحزب الحاكم واستغل العديد من التونسيين الفرصة لتكوين أحزابهم السياسية، فإن النظام الحزبي المتعدد ليس كافيا لضمان الحريات الديمقراطية التي حارب من أجلها التونسيون.
ونظرا لإدراكهم أنه ما زالت هناك العديد من التغيرات الضرورية لضمان مستقبل ديمقراطي، استمرت المظاهرات في الشوارع لمدة طويلة بعد رحيل بن علي. فلم تخف الاحتجاجات في الشوارع في تونس إلا في بداية مارس (آذار)، وذلك بعد قضاء عطلة أسبوعية مضطربة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محمد الغنوشي، والذي حصل على منصبه بعد خلع بن علي.
وبعد ذلك تم اختيار الباجي قائد السبسي، وهو رجل في عقده التاسع، معروف باستقلاله، لكي يصبح رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة وقد شكل الحكومة الانتقالية الثانية.
وعلى الرغم من أن البعض قد أعرب عن عدم رضائه عن عمر رئيس الوزراء، فإن الهدوء النسبي الذي ساد الشارع يعرب عن رأي البعض الآخر. فبدلا من حريق الملصقات، لم يبق إلا الرماد في الشارع الرئيس - الحبيب بورقيبة - وهو المكان الذي جاء إليه التونسيون لكي يعبروا عن سخطهم من بقايا الحكومة السابقة.
وعلى الرغم من أن التونسيين يبدون راضين عن تلك التغييرات الأخيرة، ما زال تاريخ التهميش السياسي يهدد آفاق الانتخابات الديمقراطية. فقد وجد استطلاعا للرأي أجرته «Emrhod Consulting»في الأسبوع الأول من مارس أن غالبية التونسيين (61 في المائة) لم تسمع أبدا عن أي حزب سياسي. ومع ذلك، كانت هناك أقلية (14.6في المائة) تشعر بأن حزب النهضة الإسلامي هو أفضل الأحزاب لتطوير البلاد في المستقبل فيما كان هناك قرابة (74 في المائة) من التونسيين لم تحسم قرارها. ووفقا لما ذكره محلل للأخبار المحلية، فإن حقيقة أن غالبية التونسيين لم تتمكن من تحديد اسم أي حزب سياسي تمثل مؤشرا خطرا، والأخطر منه هو أن الجدال السياسي الذي استمر لمدة شهرين قد أثار العواطف بدلا من أن يحفز ظهور الثقافة السياسية. وعلى الرغم من الافتقار إلى الثقافة السياسية، ما زالت الغالبية التونسية (82 في المائة) متفائلة بشأن مستقبل الثورة.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن الحكومة الانتقالية لديها خطة للانتخابات المستقبلية تمثل فرصة بالنسبة للتونسيين لكي يصبحوا أكثر وعيا بالخيارات الموجودة أمامهم. ففي يوليو (تموز)، سوف يكون التونسيون قادرين على انتخاب مجلس تأسيسي يعمل على إصلاح الدستور. وقد جاء ذلك القرار وسط جدل حول أن سلطات الرئاسة تمثل وضعا مشجعا على الفساد وبالتالي تعرقل آفاق التطور الديمقراطي. وقد قال العديد من الناس أن باختيار منح رئيس الوزراء والبرلمان المزيد من السلطة، سوف تتمكن تونس من تحطيم علاقتها التاريخية بالنظام السلطوي.
وعلى أية حال، فإن أي مناقشة حول الثقافة السياسية لن تكون مكتملة إذا لم تعالج الميل الإشكالي الذي خلقته حرية التعبير الجديدة. بعد الثورة، شهدت البلاد اضرابات في القطاعات كافة. فقد أغلق المطار مرات عدة، وتم إلغاء الرحلات. كما قامت قوات الشرطة بإضراب مطالبة بتحسين الأجور، فيما اتهمهم كثير بأنهم يزيدون من خطورة الوضع الأمني المتهاوي. كما أضرب أيضا سائقو الشاحنات المسؤولون عن توصيل البنزين إلى المحطات مما خلق رعبا من التعرض لنقص في الوقود. ويقال إن تلك الإضرابات كافة تعرقل الاقتصاد وتمنع الدولة من العودة إلى الوضع الطبيعي.
وقد رأى البعض أن تلك الإضرابات والمظاهرات ضارة للغاية، حتى أن مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الغالبية الصامتة» قد نزلت أيضا إلى الشوارع داعية التونسيين إلى العودة إلى أعمالهم وعدم السماح باختطاف قيم الثورة من قبل الأقلية الراديكالية.
ولكن المضربين دافعوا عن حقهم، وأعرب كثير منهم عن إحساسه بالإحباط بسبب الاتهامات بأن سلوكهم غير وطني. وفي النهاية، فإن العديد من تلك الإضرابات عكست مظالم مشروعة كانوا يعانون منها منذ عقود ولم يكونوا من قبل قادرين على التعبير عنها. وليس مستغربا في ذلك السياق أن النقابات كانت مترددة في إغفال فرصة يمكن أو لا يمكن أن تحدث في المستقبل.
وفي ما يتعلق بالسؤال حول استمرار الإضرابات من عدمه، ما زال أمام تونس طريق طويل عليها قطعه لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وأخذا في الاعتبار أن المظالم الاجتماعية الاقتصادية كانت في قلب الاحتجاجات التي أدت إلى خلع بن علي، فإن معالجة بطالة الشباب والتكافؤ الإقليمي سوف يكونان من أولويات الحكومة. ومما لا شك فيه أن قدرتهم على التغلب على تلك التحديات سوف تعرقل الأنشطة الاقتصادية اليومية. وبالفعل، تم تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل فتش راتنغ. ناهيك عن أن تكلفة الاضطرابات الأخيرة تقدر بين 5 مليارات دولار (11 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقا لـ«الفايننشيال تايمز»، فمن المتوقع أن يؤدي التزامن بين الاضطرابات السياسية مع تباطؤ معدل النمو إلى تقليص نحو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2011. ومما زاد الأمور سوءا، انخفاض مصدرين للعملة الأجنبية بنسبة كبيرة وهما السياحة وتحويل الأموال من العمال التونسيين في ليبيا.
وما زال أمام تونس طريق طويل للتخلص من الضرر الذي تعرض له الاقتصاد ويجب أن تتضمن تلك الاستراتيجية إعادة توزيع لثروة الرئيس الكبيرة جدا. وكما ذكرت أميديو، في ديسمبر (كانون الأول) 2010، فإن عائلة الرئيس التونسي لديها هيمنة على نحو 40 في المائة من التدفق النقدي والاقتصادي للبلاد. وتقدر «الإيكونوميست» أن الفساد قد كلف البلاد على الأقل مليار دولار سنويا. وللأسرة حصص في عدد من البنوك تتضمن بنك تونس العربي الدولي، وبنك الزيتونة، وبنك تونس. كما أنها تمتلك جانبا كبيرا من صناعة السيارات وصناعة السياحة (بما في ذلك الخطوط الجوية التونسية)، وتحتكر إدارة الأسواق الحرة والمطارات كافة، وتهيمن على غالبية وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة بالإضافة إلى التوكيلات الدولية الموجودة في البلاد مثل سلسلة متاجر «مونوبريي»، و«جيون»، وشركة الاتصالات «أورانج».
ولسوء الحظ، فإنه على خلاف الحريات السياسية التي حصل عليها الشعب بعد رحيل بن علي من البلاد، فإن المساواة الاقتصادية لا تضمن آفاق التغيير السياسي، ويجب على التونسيين التحلي بالصبر إذا ما كانوا يرغبون في إعادة توزيع ناجحة للثروات والتحسن الكلي لاقتصاد البلاد.
لقد تم الاحتفاء بسقوط بن علي وترك لدى التونسيين إحساسا بالفخر يصعب وصفه. وربما يكون أحد الملصقات في القاهرة قد وصف ذلك على النحو الأمثل: لقد كنا بالأمس جميعا تونسيين، ولكننا اليوم جميعا مصريين، وغدا جميعا سنكون أحرارا.
إن التونسيين واعون بالتغيير الذي تسببوا فيه ليس فقط في بلادهم، ولكن في العالم بأسره. وكما قال عز الدين سنيقرة، الصحافي التونسي الذي يعيش في لندن: «أشعر أننا صنعنا التاريخ، وأن محمد البوعزيزي ليس فقط شهيدا ولكنه ملهم للعرب والمسلمين جميعا وأي أحد يسعى وراء الحرية في هذا العالم لسنوات عدة قادمة. أتطلع لتونس أفضل».
لقد قطعت تونس شوطا طويلا، وما زالت على طريق خلق شكل من الحكومة لطالما كان يرغب فيه التونسيون. ولكن عدد التغيرات المطلوبة لتحويل تلك المثل إلى حقائق ما زال كبيرا. إن التونسيين والعالم الذي يساندهم لا يجب أن ينسوا أن الثورة قد بدأت للتو.
بولا ميجيا