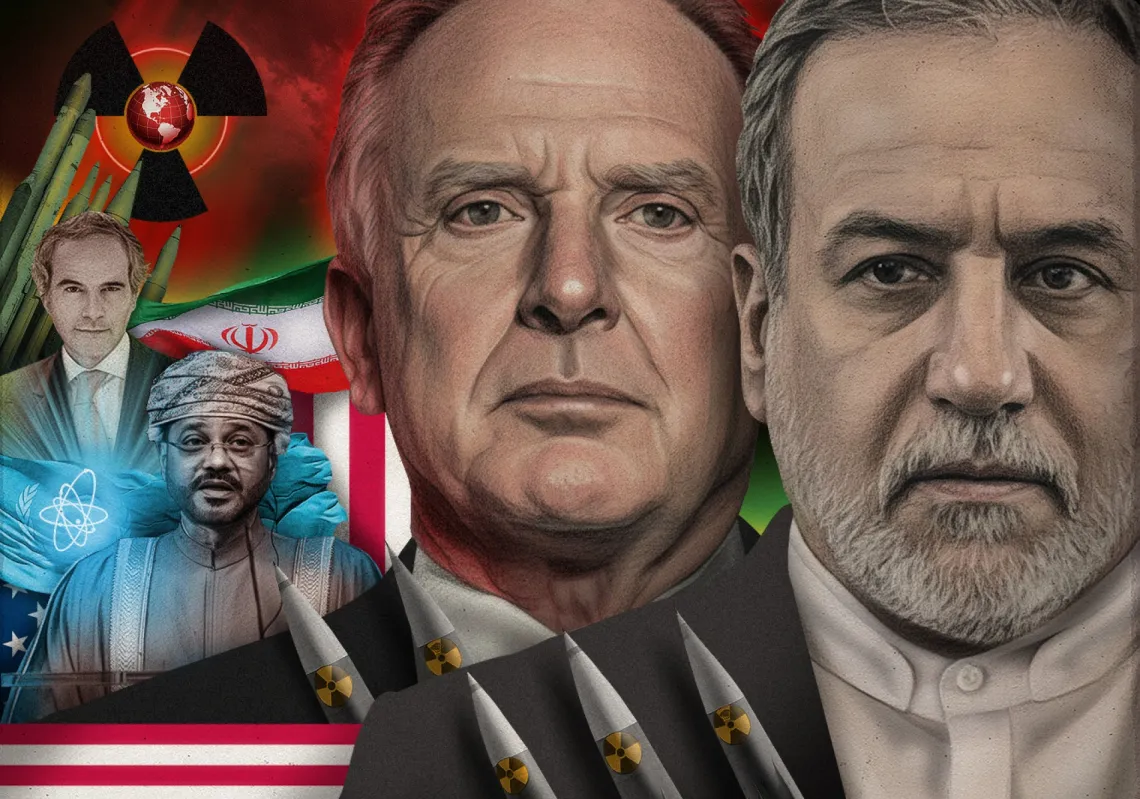أمضيت أياما في توتر يصيبني كلما هممت بفعل أمر ما، لكن التوتّر هذه المرة كان زائداً على الحد حتى أنني رحت أتلكأ وأبحث عن مهرب كي لا أواجه أستاذي وصديقي ابراهيم عبد المجيد وأجلس منه في موضع السائل. بدا الأمر هيّنا في البداية، إلا أنه كان شاقّا ومخيفا على الرغم من علاقتنا الوطيدة منذ سنوات، مررنا خلالها بالكثير ولبسنا ثوب الأمل الكبير ذات يوم، حتى أنّه تقدّم موكبنا في يوم الغضب الكبير. كنا حينها نحلم.
يجمعنا الكثير من الجلسات. ما من مرة قرر مغادرة سكنه البعيد، والذهاب إلى وسط المدينة الذي نعشقه، إلا كلّمتني زوجته صديقتي المقربة لكي نلتقي. تقول لي: "عمّك موصّيني أكلّمك". هو "عمّي" مثلما أحبّ مناداته، فهو إلى جانبي منذ تلك اللحظة التي وقفت فيها أمامه وقد جذبتني صديقتي من يدي لأتغلب على خجلي وأقدّم إليه روايتي.
في ذلك اليوم جلس إلينا كأنه واحد منا لنغرق معه في بحار من الحكايات والضحك، ولنكتشف أن للكاتب الكبير صورة أخرى، صورة تجعل منه أبا أو عمّا أو صديقا. مرّت الأيام وهو لا يكفّ عن تقديم يد العون إليَّ وإلى غيري. عرّفني بزوجته فباتت الأحبّ والأقرب إلى قلبي.
هناك في بيته وبينما يجلس على أريكته المفضلة، استعرتُ مكتبه ولبستُ ثوب المحاور وقد هدّأ هو روعي وأطمأن إلى أنني شربتُ قهوتي قبل أن نبدأ.
أطفأ اللابتوب الذي كانت تنبعث منه الموسيقى كالعادة.
فقلت: كتبتَ قبل أيام: "جعلتُ ليلي للفن والموسيقى والمتعة، أما نهاري فهو للبؤس"، لماذا نهارك للبؤس وهو يبدأ بالموسيقى التي تصاحبك طوال اليوم كأنها خلفية لحياتك كلها؟
لم يبحث طويلاً في ذاكرته. "منذ تلك اللحظة التي استمعتُ فيها إلى أنيس منصور عام 1969 وهو يعلن عبر الأثير إذاعة "البرنامج الموسيقي"، حتى قررتُ الاستماع إليه، فكانت تلك البداية، وعرفت برنامج حسين فوزي "السندباد المصري"، وهو ساعة مخصصة للموسيقى الكلاسيكية. منذ ذلك الحين صاحبتني هذه الموسيقى، خصوصا حين أكتب ليلا، هي رفيقتي ولولاها لما نسيت ما أراه في النهار من صراعات الحياة ومشكلاتها. أذكر أنني كتبت قبل زمن طويل مقالا بعنوان "تعالوا معي للموسيقى لتنسوا السياسة"، وعلى الرغم من أنني شاركت في العمل السياسي وانتسبت إلى أحد الأحزاب في بداية حياتي، إلا أن ذلك كله ينتهي ليلا وكأنني شخص آخر تغسلني الموسيقى فأنسى أحداث اليوم وأبدع. لولا الموسيقى لما كتبت شيئا.
عشق السينماإذا كانت الموسيقى عشقه الأول، فالسينما لا تقلّ أهمية عنها. يروي إبراهيم عبد المجيد أنه باع يوما كتبه الدراسية ليشاهد فيلما في السينما. ألّف كتاباً بعنوان "أنا والسينما"، كما نجد في أعماله تأريخا لحال السينما مثلما هناك تأريخ للحال السياسية والاجتماعية.