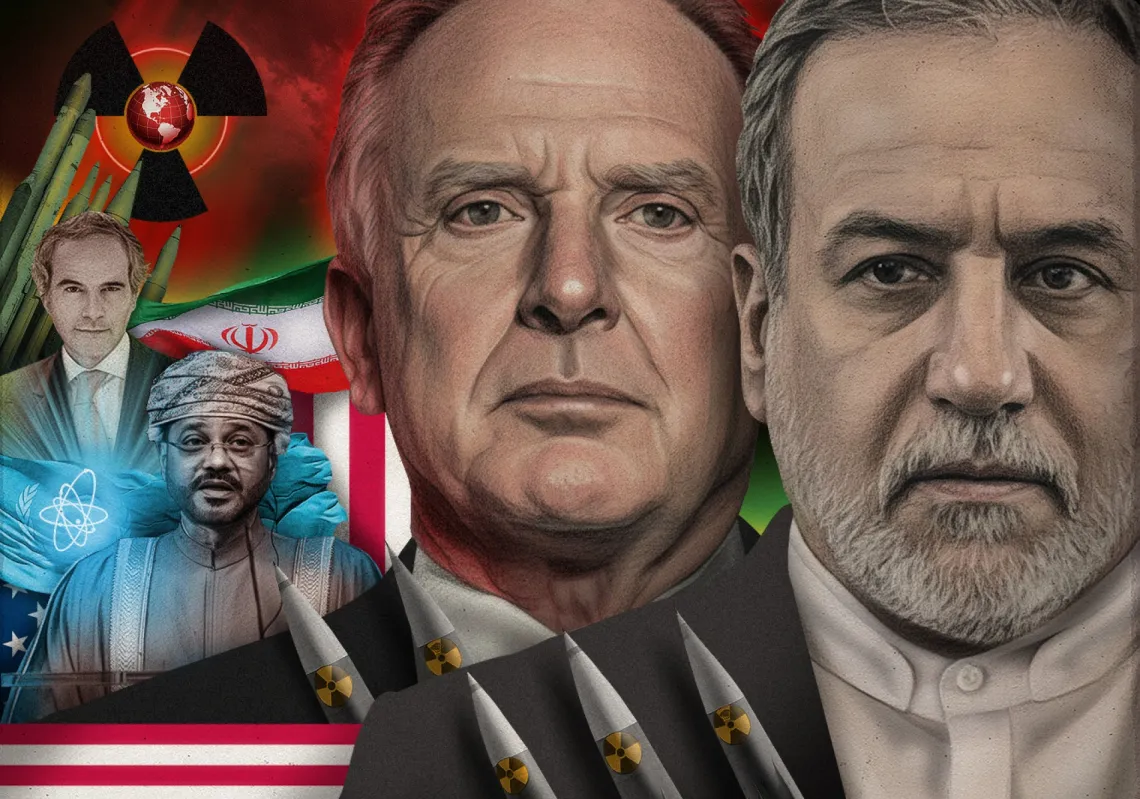كانت "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أعلى مستوياتها عام 2003 أي قبل عقدين. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد تعهد آنذاك بالوقوف "جنبا إلى جنب" مع واشنطن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، قبل أن ينضم إلى الحملات العسكرية الأميركية اللاحقة التي جرت في أفغانستان والعراق.
وفي حين أن عدد القوات الأميركية كان يفوق عدد الجنود البريطانيين بنسبة أربعة إلى واحد في غزو عام 2003 للعراق، فقد لعبت لندن دورا دبلوماسيا حيويا في إضفاء جو من الشرعية الدولية على العملية بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على تدخل البيت الأبيض. وقد بدا أن ولاء بلير قد أمن له مكانة خاصة لدى الرئيس جورج دبليو بوش. وكثيرا ما وقف الاثنان جنبا إلى جنب في المؤتمرات والاجتماعات الصحافية، ما مثل وقتها جبهة موحدة في "الحرب على الإرهاب".
تبدو الصورة بعد عقدين من الزمان ظاهريا متشابهة. فبريطانيا والولايات المتحدة متحدتان اليوم في صراع مشترك آخر، إذ تدعمان هذه المرة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي يوليو/تموز، التقى الرئيس جو بايدن وهو في طريقه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، رئيس الوزراء ريشي سوناك في لندن. وأعلن أن العلاقات بين الولاياتِ المتحدة والمملكة المتحدة "متينة" قبل أن يسافر إلى قصر وندسور للقاء الملك تشارلز. ومع ذلك، فثمة أمور كثيرة تغيرت في الأعوام العشرين الماضية.
وعلى الرغم من إصرار بايدن، فإن "العلاقة الخاصة" تبدو أبعد ما يمكن عن اتصافها بالقوة. فقد ألغت واشنطن فعليا اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي سعى رؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون للوصول إليها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى نحو مشابه، بدد بايدن طموحات لندن بترشيح وزير دفاعها، بن والاس، كي يشغل منصب الأمين العام المقبل لحلف الناتو. وفي حين فُسر توقف الرئيس في لندن على أنه إشارة إلى الصداقة مع حليف دائم للولايات المتحدة، فإن العلاقة قد تبدلت في السنوات الأخيرة في ظل تغير ديناميات القوة، والأولويات على كلا جانبي الأطلسي. ويبقى السؤال: هل ما زالت العلاقة تتصف "بالخصوصية"؟
العلاقة الخاصة
تم إضفاء الطابع الرومانسي على العلاقات التي تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى حد ما، ولا سيما من الجانب البريطاني. وفي الحقيقة فقد اتصفت العلاقات بأنها وثيقة، ولكنها مع ذلك كانت أيضا تتسم بالتعقيد. كان ونستون تشرشل هو من صاغ مصطلح "العلاقة الخاصة" لأول وهلة عام 1946، لكن بريطانيا والولايات المتحدة لم تتمتعا بعلاقات وثيقة ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي واقع الأمر، استخدم تشرشل المصطلح خلال خطابه المشهور باسم "الستار الحديدي"، والذي ألقاه في الولايات المتحدةِ بعدما غادر منصبه كرئيس للوزراء البريطاني، لأنه كان يسعى إلى إقناع الأميركيين بالعودة إلى المملكة المتحدة وأوروبا بعد انسحابهم من القارة إثر هزيمة ألمانيا النازية.