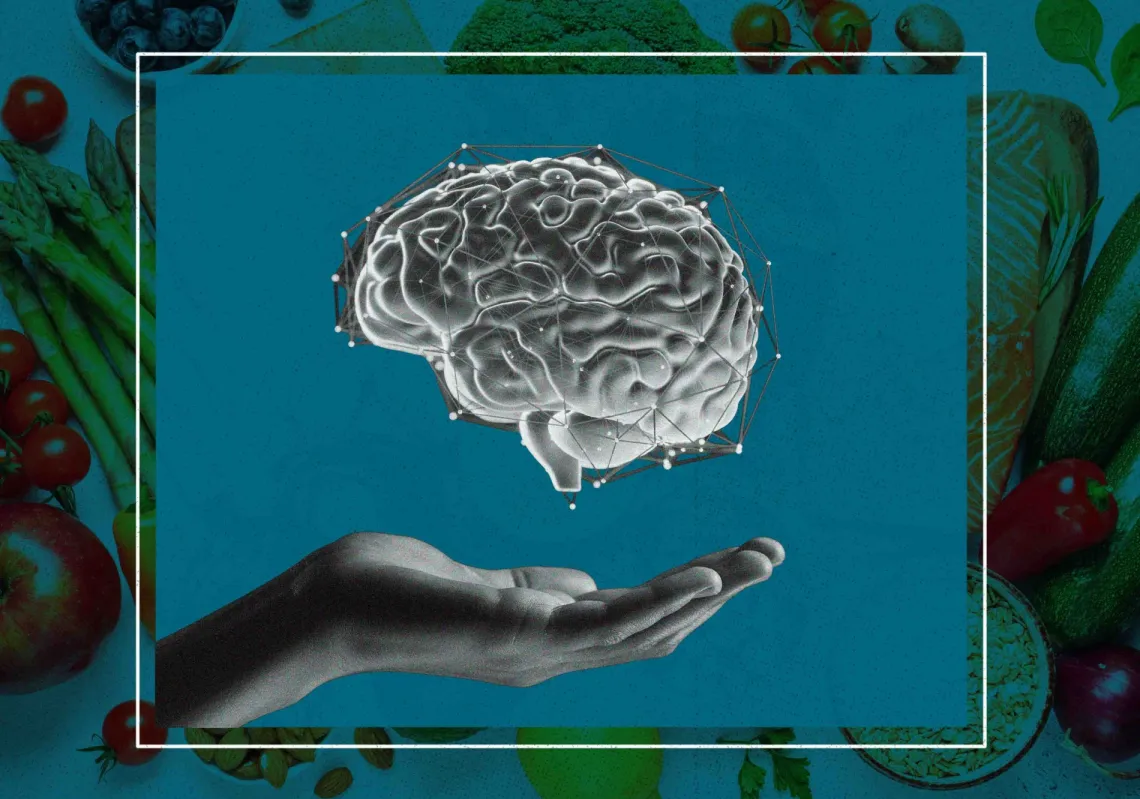يواصل ابن بطوطة رحلته في الآفاق من خلال "الجائزة العربية لأدب الرحلة"، أكبر جائزة عربية تحمل اسمه وتخلد ذكراه وآثاره وآثار الرحالين من قبله وبعده، والتي أطلقها المركز العربي للأدب الجغرافي من العاصمة المغربية الرباط سنة 2003، وها هي تعود إلى الرباط في ربيع هذا العام، حيث أعلنت، قبل أيام، الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة والعشرين، في اختتام المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
تدعونا جائزة ابن بطوطة إلى رحلة أخرى بين رفوف أكبر مكتبة عربية خاصة بأدب الرحلة، بعدما أصدر المركز العربي للأدب الجغرافي حتى يومنا هذا أكثر من 300 كتاب، وفي صدارتها الكتب الفائزة بالجائزة في مختلف فروعها. فثمة فرع خاص بالرحلات المحققة، وآخر خاص بالدراسات، وثالث خاص بالرحلة المترجمة، ورابع خاص بالرحلة المعاصرة، وخامس مخصص لليوميات. وقد جاءت حصيلة هذه السنة جديرة بالتأمل، كما قال وزير الثقافة المغربي محمد المهدي بنسعيد في افتتاح حفل الجائزة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، مؤكدا أنها "جديرة بالتأمل كونها كشفت المكانة الأثيرة التي يحظى بها أدب الرحلة وما يتصل به من فروع لدى المؤلفين بالعربية، والمغاربة منهم على وجه الخصوص".
حوار الذات والآخر
والحال أن خلاصة هذه الجائزة كونها "حوار الذات والآخر"، كما يصفها راعيها الشاعر محمد أحمد السويدي، معتبرا أن أدب الرحلة تحول بفضل كوكبة متعاظمة من الدارسين والمحققين والكتاب المتحلقين حول مشروع "ارتياد الآفاق" وجائزته مغربا ومشرقا إلى "خزانة عامرة بالنصوص الكلاسيكية والوسيطية في هذا الجنس الأدبي العريق، والدراسات التي تناولته بالبحث، إلى جانب الاحتفاء بكتابات الرحالين المعاصرين"، الأمر الذي يبرهن، في نظر راعي الجائزة والمؤمنين بالمشروع، على أن "ميل العربي نحو السفر وتدوين الرحلة، يعبر عن نزوع أصيل لدى الثقافة العربية نحو التواصل والتعرف والحوار مع الآخر بوصفه شريكا حضاريا".
وكان وصل إلى لجنة تحكيم الجائزة هذه السنة نحو خمسين مخطوطا في مختلف الفروع والمجالات، بينما غطت الأعمال الفائزة في هذه الدورة "مساحة واسعة من السفر شرقا وغربا"، كما يوضح مدير عام المركز العربي للأدب الجغرافي ومدير جائزة ابن بطوطة الشاعر السوري نوري الجراح، يقينا منه أن "الرحلة مغامرة فكرية وروحية تعكس تفاعل الذات مع الآخر من منظور فكري وأدبي يكرس صورة الرحالة العربي شاعرا وأديبا".