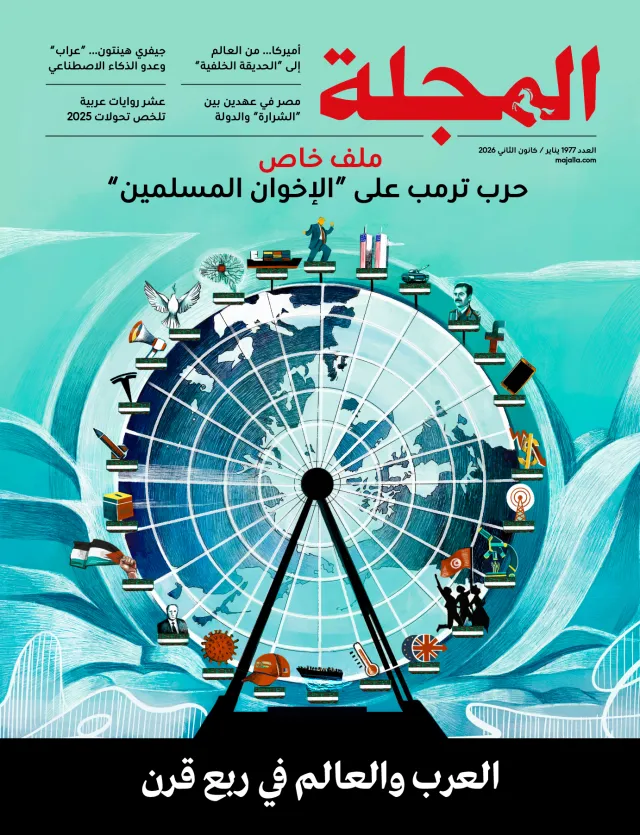لم تكن العلاقة بين الدين والعلم في الثقافة الإسلامية علاقة صراع أو توجّس، بل علاقة توليد وتحفيز متبادل. فقد شكّلت الوظيفة الدينية اليومية أحد أبرز المحرّكات التي دفعت العقل المسلم إلى الانخراط العميق في دراسة العلوم الطبيعية، بما في ذلك الرياضيات والفلك والهندسة والفيزياء والكيمياء، وذلك استجابة لحاجات تعبّدية ملموسة: كمعرفة أوقات الصلاة بدقة، ورؤية الهلال، وتحديد القبلة من أي موضع على وجه الأرض.
هذه المتطلبات، بما تنطوي عليه من دقة زمانية ومكانية، فتحت المجال أمام نقلة علمية منهجية، تقوم على الرصد المنتظم والملاحظة الدقيقة والتقعيد الرياضي. لم يكن السؤال: متى نصلي؟ أو أين نتجه؟ أو متى نصوم؟ مجرد استفسار ديني، بل بوابة للتفكير في الانتظام الكوني، والربط بين الزمن الإنساني والدورة الفلكية، وبين الحدث الأرضي والنظام السماوي.
ومن أبرز نتائج هذا التداخل بين الحاجة التعبدية والتفكير العلمي، تبرز آلة الأسطرلاب بوصفها تجسيدًا مادّيًا لعقل حضاري استطاع أن يوحّد بين الرؤية الشرعية والابتكار الرياضي، وبين الوظيفة الدينية والدقة العلمية. فهو ليس مجرد أداة لتحديد الوقت، بل بنية فكرية مصغّرة تلخّص كيف نظر المسلمون إلى الكون: كيانٌ قابل للفهم، منظَّم، ومفتوح أمام العقل البشري للتأمل والاستكشاف.
حين تنظر اليوم إلى الأسطرلاب لا تطالع أداة فلكية، بل خارطة فكر ومرآة حضارة. في دقته ترى النظام العجيب، وفي نقوشه ترى الفن الرفيع، وفي وظيفته اجتمع الدين والعلم في عقل واحد. إنه تجسيد حي لعقلٍ يكتشف السماء بأنامله، ويكتب النجوم بلغة عربية فصيحة.
ولئن لم يكن الأسطرلاب اختراعًا إسلاميًا خالصًا من حيث النشأة، إذ تعود أصوله إلى الحقبة اليونانية، فإن لحظة اللقاء بينه وبين الحضارة الإسلامية لم تكن لحظة نقل، بل لحظة تحول، أعيد فيها تشكيل الأداة ضمن نظام معرفي متكامل.
في القرن الثاني الهجري، ومع حركة الترجمة الكبرى في بغداد، انتقل الأسطرلاب من كونه آلة في المخطوطات اليونانية إلى جهاز حيّ في يد علماء المسلمين، الذين أدركوا إمكاناته الهائلة، فبدأت موجة تطوير واسعة قادها علماء مثل الخوارزمي، الذي أدخل الحسابات الهندسية الدقيقة إلى تصميمه، والبتّاني الذي حسّن جداول الرصد، والزرقالي الذي طوّر "الأسطرلاب الشامل"، ومريم الأسطرلابية التي ابتكرت أقراصًا متقدّمة، والمجريطي الذي لعب دورًا مهمًا في انتقال التقنية إلى الأندلس وأوروبا.
تصوير الفقه في جهة، والعلوم الطبيعية في جهة مقابلة، هو تصويرٌ متخيّل لا يصمد أمام حقائق التاريخ. فالعقل العربي حين ابتكر الأسطرلاب، لم يكن يتجاوز الفقه، بل كان يمدّه بأدواته
إن آلة الأسطرلاب في جوهرها تكشف عن زيف الثنائية التي شاعت في بعض السرديات الحديثة حول الصراع بين "العلماء العقليين" من أهل الفلك والرياضيات والطبيعيات، وبين "الفقهاء" من أهل النص والأثر. فليست هذه الأداة العلمية المذهلة إلا ثمرة لحاجة فقهية شرعية بامتياز: ضبط أوقات الصلاة، وتحديد الأهِلّة، واستقبال القبلة، وكلها مسائل شغلت الفقهاء واحتلت حيّزًا واسعًا في كتبهم. فقد ناقشها أمثال الإمام الشافعي والماوردي والنووي في أبواب المواقيت، كما أفرد لها علماء كالباجي وابن رشد فصولًا دقيقة تتناول الحسابات الفلكية وآلات الرصد. بل إن بعضهم، كتقي الدين السبكي، اعتبر الأخذ بالحساب في رؤية الهلال ضربًا من الفقه العميق لا خروجا عنه.
لقد وُلد الأسطرلاب في حضن الضرورات التعبدية، وتشكل في تربة السؤال الشرعي، لا بمعزل عنه. ومن ثم، فإن تصوير الفقه في جهة، والعلوم الطبيعية في جهة مقابلة، هو تصويرٌ متخيّل لا يصمد أمام حقائق التاريخ. فالعقل العربي حين ابتكر الأسطرلاب، لم يكن يتجاوز الفقه، بل كان يمدّه بأدواته، ويترجِم حاجاته بلغة رياضية وفلكية دقيقة، تعكس انسجامًا لا صراعًا، وتكاملًا لا تناقضًا.
إنها دوائر لم تكن تدور عبثاً، بل ثورةٌ فكريةٌ تربط العبادة بالعلم، والروح بالفلك. قرأت الفضاء بلغة الرياضيات، وأعادت رسم خريطته بروحٍ عربيةٍ إسلاميةٍ لا تزال بصماتها محفورة في السماء.