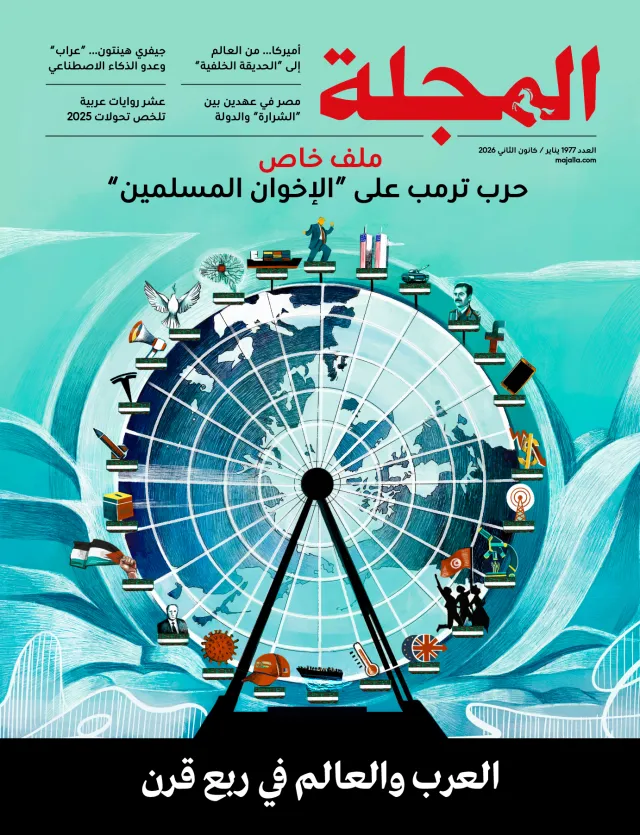ثمة سردية راسخة في الكتابات الفكرية تقول إن دخول الفلسفة اليونانية إلى الحضارة الإسلامية كان منعطفًا كبيرًا، مهّد الطريق لنقل المعارف والعلوم إلى آفاق أرحب، وأسهم في نشوء نهضة علمية شملت الطب، والفلك، والرياضيات، والمنطق، وعلوم الطبيعة. ورغم وجاهة هذا التصور من حيث أثره في بعض الحقول، إلا أنه يغض الطرف عن سؤال لا يقل أهمية: هل شكّلت الفلسفة اليونانية عنصر دفع حقيقي للعقل العربي، أم أنها زاحمت مسارًا كان يتكوّن من داخله، وأدخلته في سجالات استبقت نضجه الفلسفي الذاتي؟
لسنا هنا في مقام الخصومة مع الفلسفة، ولا في معرض التقليل من شأن التراث الإغريقي، إنما نحن بصدد مساءلة لحظة ثقافية مفصلية: ماذا لو واصل العقل المسلم آنذاك مسيرته، مستندًا إلى الوحي، واللغة، والإرث العربي، والتجربة، دون أن يُقحم مبكرًا في قضايا مستوردة لا تنتمي إلى بيئته؟
عند الحديث عن الفلسفة العربية الإسلامية، كثيرًا ما يُختزل المسار في علاقتها بالفلسفة اليونانية، سواء من زاوية النقل، أو الترجمة، أو النقد والتطوير، أو حتى التكميل. هناك اتجاه يروّج لفكرة أن العرب لم ينتجوا فلسفة حقيقية، بل اكتفوا بترجمة الفلسفة اليونانية وإعادة عرضها بحروف عربية، كما ذهب المستشرق الفرنسي إرنست رينان وآخرون ممن رأوا أن العقل العربي عاجز بطبعه عن التفلسف. وفي المقابل، يرى اتجاه أكثر إنصافًا أن العرب لم يكتفوا بالنقل، بل قدّموا إضافات فلسفية أصيلة، وطوروا ما نقلوه، ودفعوا الفكر اليوناني إلى آفاق جديدة. لكن في الحالتين، تظل الفلسفة العربية – وفق هذا الطرح- محكومة بسياق الفلسفة اليونانية، إما تبعًا لها، أو تفرعًا عنها، أو نقدًا وتطويرًا لها. ما يُغفل غالبًا هو أن هذه الهيمنة -حتى في ظاهرها الإيجابي- همّشت إمكانية تشكّل فلسفة عربية خالصة، نابعة من بنية النص، ومن تجربة الوحي، ومن تقاليد الفقه واللغة والشعر، ومن العقلية العربية الأصيلة، بكل ما تحمله من تراث ثقافي ولغوي ووجودي خاص، تشكّل قبل الإسلام واستمرّ بعده. لقد كانت هناك لحظة ممكنة لفلسفة تتكوّن من الذات لا من استجابتها للغير، لكن الاستغراق في استيعاب الفلسفة الوافدة، بمشكلاتها ومفاهيمها، جعل هذا المسار يتأخر، وربما يتوارى.
ظلت الفلسفة العربية وفق الطرح السائد محكومة بسياق الفلسفة اليونانية، إما تبعًا لها، أو تفرعًا عنها، أو نقدًا وتطويرًا لها.
قبل أن تصل كتب أرسطو وأفلاطون إلى العالم الإسلامي، كان هناك مشروع علمي يتشكّل من الداخل: أئمة المذاهب الأربعة أسّسوا تقاليد فقهية متكاملة؛ الشافعي أنشأ علم الأصول، ومالك دوّن الحديث في الموطأ، وأحمد بن حنبل جمع الرواية في المسند. هذه العلوم لم تكن مجرد أدوات فقهية، بل كانت تنطوي على نسق عقلاني عميق، يربط النص بالاجتهاد، والواقع بالمقصد، ويضبط عمليات التفكير ضمن نظام داخلي شديد الدقة. وفي الموازاة، كانت علوم اللغة تُبنى بأدوات عربية خالصة، من أبي الأسود الدؤلي إلى الخليل بن أحمد وسيبويه، حيث استُنبطت قواعد النحو والعَروض والمعجم، لا كأدوات لفهم النص فقط، بل كمناهج عقلية حاملة لفلسفة لغوية عميقة. وقد ذهب المفكر مصطفى عبد الرازق إلى أن علم أصول الفقه هو الذروة التي بلغها التفكير العربي، من حيث كونه علمًا فلسفيًا في جوهره، استمد مادته من النص، وأدواته من اللغة، ومنهجه من البيئة التي نشأ فيها، دون حاجة إلى الاستعارة من الخارج.
في هذا السياق، جاءت الفلسفة اليونانية محمّلة بإرث ميتافيزيقي كثيف، فاستحوذت على اهتمام النخبة، وتحول مركز التفكير إلى مفاهيم مثل "الجوهر والعرض"، و"العلة والمعلول"، و"القدم والحدوث"، و"العقل الفعّال"، و"النفس الكلية". ومعها وُلد علم الكلام، لا بوصفه شرحًا للعقيدة، بل كمشروع معرفي متأثر في بنيته العميقة بالمنطق الأرسطي وشروحه.
انقسمت المدارس الاسلامية بين فرق تتبنى هذا الإرث أو ترفضه، فيما تراجعت مناهج التفكير العربية الأصيلة التي كانت تتبلور في أصول الفقه واللغة والحديث. وقد أدرك بعض العلماء هذا التبدّل، فرفض الإمام أحمد بن حنبل المسار الكلامي بشدة، ووقف ابن تيمية لاحقًا موقفًا نقديًا من المنطق الأرسطي ذاته، داعيًا إلى عقل يستمد منطقه من النص، لا من فلسفات وافدة.
وقد أشار محمد علي أبو ريان إلى هذا المعنى بوضوح في كتابه "تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام"، مؤكّدًا أن الفلسفة اليونانية لم تدخل إلى العالم الإسلامي في لحظة فراغ، بل جاءت والمسلمون قد بلغوا درجة من النضج العقلي والفكري، واستوت لديهم علومهم الشرعية واللغوية، وبدأت تتشكل لديهم ملامح فلسفة نابعة من ذاتهم الثقافية. ويرى أبو ريان أن العرب والمسلمين، لو لم تصلهم الفلسفة اليونانية، لشقّوا طريقهم نحو إنتاج فلسفتهم الخاصة، القائمة على أصالتهم الفكرية والحضارية. غير أن هذه الفلسفة، حين دخلت إلى البيئة الإسلامية، جاءت محمّلة بتناقضات ميتافيزيقية، وصراعات مذهبية، وتحريفات تراكمت عبر قرون من النقل والتأويل، فغدت الأجواء الفكرية مشوشة ومربكة، مما حال دون انطلاق المشروع الفلسفي العربي الخالص. يقول أبو ريان: "لم يستطع العقل العربي أن يبرز جوهره الخلاق في ميدان الفلسفة نقيًا مخلصًا، فقد تعثّر في مواطئ هذا الخليط المعوق للانطلاق الفكري، وبذل مجهودًا ضخمًا في محاولة التخلص منه".
هذا لا يعني أن الفلسفة اليونانية كانت شرًا محضًا. فقد أسهمت في تنشيط التفكير، وفتحت أبوابًا في الطب والرياضيات والهندسة والفلك، أثرها كان مفيداً في بعض المجالات، لكنها زاحمت في مجالات أخرى مشروعًا كان في طريقه إلى التكون، وأدخلت العقل المسلم في معارك غير منتجة، بل أحيانًا مُربكة، وبدّلت ملامح علوم أصيلة، وأثرت على طرائق التفكير، بل على فهم العقيدة نفسها.
هذا الرأي لا يدعو إلى قطيعة مع الفلسفة، بل على العكس، هو محاولة لاستعادة فلسفة عربية كان يمكن أن تولد من داخلنا على طريقة الشافعي والأصمعي وابن قتيبة والخليل، لا على طريقة أرسطو أو أفلاطون، فلسفة نابعة من نصوصنا، وسياقنا، وتجربتنا، لا مستعارة من خارجها.