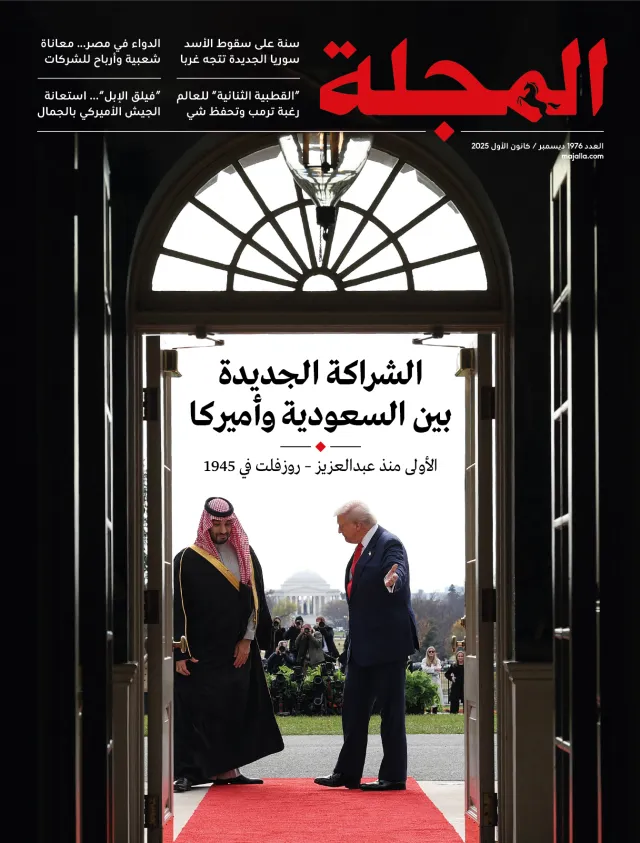حين يتأمل الإنسان العالم من حوله، يبدأ عادة من الأشياء، من الخارج، من الظواهر التي تفرض نفسها عليه بالحس والانطباع والانفعال. لكن في لحظة أعمق من الوعي، تنقلب وجهته إلى الداخل، لا ليسأل: ما هذا؟ بل: كيف سأفكر في هذا؟ هنا يبدأ التفكير في التفكير، لا بوصفه تمرينا تأمليا، بل باعتباره الخطوة الأولى نحو المعرفة الصحيحة.
لمدة طويلة، ظنّ فلاسفة أن طريق المعرفة يبدأ من أن تجعل لنفسك منهجا، وأن هناك خريطة جاهزة يجب اتّباعها، وأن العقل كائن يحتاج إلى قواعد خارجة عنه تضبط حركته. هذا ما نجده في المنطق الأرسطي، ويتكرّس بوضوح في مشروع ديكارت، أبي الحداثة، حيث يُفترض أن الشك المنهجي والمنهج الرياضي هما السبيلان إلى اليقين. لكن هذا التصوّر سرعان ما ظهر محدودا، لأنه يتعامل مع العقل كأداة محايدة يجب تقييدها مسبقا، لا كقوة حية تفكّر وتفهم وتعي ذاتها من داخلها.
أما الفلسفة التي تُعيد العقل إلى مركزه الحقيقي، كما عند سبينوزا، فترى أن المعرفة لا تُبنى من خارج، بل من الداخل. فحين يُدرِك العقل نفسه إدراكا صادقا، ويمارس قواه، لا يعود محتاجا إلى معيار خارجي للحقيقة، لأن الحقيقة تتجلّى فيه من خلال فعله هو. التفكير في التفكير، أو ما يسمّيه سبينوزا "فكرة الفكرة"، ليس تأمّلا تجريديا فارغا، بل هو الوعي بقوة المعرفة في ذاتها، وهو اللحظة التي ندرك فيها أننا نعرف، وأن هذه المعرفة ممكنة، بل محققة.
كم من الناس يملكون معتقدات راسخة، يدافعون عنها بحرارة، لكنهم لم يسألوا يوما عن كيفية تشكّلها، أو ما إذا كانت طريقة تفكيرهم نفسها قابلة للفحص
ومن هنا، فإن المنهج الحقيقي لا يسبق المعرفة، بل هو أثر لها، ووعي لاحق بها. لا يمكننا أن نعرف ما هي الفكرة الصادقة إلا إذا كانت لدينا تجربة صادقة فعلا بها. هذا القلب للمسار المعرفي هو ما يمنح التفكير في التفكير منزلته التأسيسية، فهو الشرط الأول لتمييز الصدق من الوهم، وللفصل بين الرأي الناقص والمعرفة.
والمعرفة التي تبدأ من التفكير في التفكير ليست انعزالية، ولا مغلقة على ذاتها، بل تنفتح على العالم لا من موقع المتلقّي، بل من موقع الفاعل. لأن من يعرف أنه يعرف، يعرف أيضا حدود معرفته، ويعرف كيف ينظّم تجربته، ويصوغ علاقته بالعالم دون خضوع أعمى أو افتتان ساذج. وهكذا، فإن التفكير في التفكير هو ما يمنح المعرفة قوتها لا لأنها مطابقة للواقع فحسب، بل لأنها تبدأ من وعي ذاتها، ومن مساءلة أدواتها، ومن كشف قدراتها. هذا ما يجعلها معرفة أصيلة، لا صدى لتقليد، ولا محاكاة لمثال.
وإذا كان التفكير في التفكير هو الشرط الأول للمعرفة الحقة، فإن غيابه هو أول بوابة إلى الوهم. فكم من الناس يملكون معتقدات راسخة، يدافعون عنها بحرارة، لكنهم لم يسألوا يوما عن كيفية تشكّلها، أو ما إذا كانت طريقة تفكيرهم نفسها قابلة للفحص. حين لا يفكّر المرء في تفكيره، يصبح عقله آلة بليدة تسير بقوة العادة، لا بقوة الفهم، ويغدو تابعا لصور جاهزة، لا لحقائق متكشّفة. في مقابل ذلك، فإن الوعي بالبنية التي يُنتج بها الفكر معانيه هو ما يمنح الإنسان حرية الحكم، ويمنعه من الوقوع ضحية لأوهام موروثة أو أنماط لغوية تحجب الواقع أكثر مما تكشفه.
أدرك هيغل بوضوح أن الفكر ليس شيئا خارجيا ينظر إلى العالم من مسافة، بل هو حركة داخلية تُحقّق ذاتها من خلال وعيها بذاتها. فالحقيقة، في فلسفته، ليست حقيقة جاهزة تنتظر أن تُكتشف، بل هي عملية دينامية، تنمو وتتطوّر من خلال الصراع بين الفكرة ونقيضها، ثم تجاوز هذا التناقض في مستوى أعلى من الفهم. هذا المسار الجدلي، حيث تعود الفكرة إلى ذاتها في كل مرة لتفحص نفسها وتنقض ما كان ناقصا وتؤسّس ما هو أعمق، هو ما يجعل "التفكير في التفكير" لحظة ضرورية في تحقق الوعي. فالفكر، عند هيغل، لا يكتفي بأن يكون وعيا بالعالم، بل لا يكتمل إلا إذا صار وعيا بنفسه، وعرف شروط إمكانه، وتابع مسيرته في الكشف عن الحقيقة من خلال ذاته.
أما فتغنشتاين، في طوره المتأخر، فقد نقل مركز التفكير من الذهن إلى اللغة، وأظهر أن المعنى لا يُستخرج من الأشياء مباشرة، بل يُنتج داخل "ألعاب لغوية" نمارسها يوميا دون أن ننتبه إلى قواعدها. لم تعد اللغة، في نظره، أداة تمثيل تنقل الواقع كما هو، بل صارت فضاء يمارس فيه الفكر نشاطه، وتُصاغ فيه القواعد التي تحدّد ما يمكن قوله ومعناه. من هنا، فإن مساءلة اللغة التي نفكر بها، والتدقيق في الكيفية التي نصوغ بها أفكارنا، هما السبيل إلى زعزعة البداهات، وكشف الأسس الخفية التي تُبنى عليها تصوراتنا. وهذا بدوره يجعل التفكير في التفكير عند فتغنشتاين مراجعة لطرائق التفكير ذاتها، لا فقط لمحتواه، ويفتح الباب لإدراك أن كثيرا مما نظنه بدهيا ليس إلا نتاجا لعادة لغوية رسخت فينا دون فحص.
الفكر لا يكتمل إلا إذا رجع على نفسه بالتأمل، والمعرفة لا تكون صادقة إلا حين تعرف شروط صدقها. في عالم يتسارع فيه تدفّق المعلومات، ويختلط فيه الصدق بالزيف، تزداد الحاجة إلى هذا النمط من التفكير المنعكس. فالمعرفة اليوم لا تتطلب فقط أن نعرف، بل أن نعرف كيف نعرف، وأن نتحرّى المسافة بين ما نعتقد والطريقة التي توصّلنا بها إلى هذا الاعتقاد. وهكذا، فإن التفكير في التفكير ليس ترفا فلسفيا، بل هو الشرط الإبستمولوجي الأول لبناء معرفة حرة، مسؤولة، وفاعلة. ومن دونه، تغيب الحقيقة، ويحلّ محلها التكرار والتلقين. فإذا كان التفكير في التفكير هو الشرط الأول للمعرفة الحقة، فإن غيابه هو أول بوابة إلى الوهم.
من لا يسائل تفكيره يبقى أسيرا لصور ذهنية لا يدري كيف تشكّلت. أما الذي يفكّر في تفكيره، فهو الذي يملك مفتاحا لفهم ذاته والعالم معا. بهذا الوعي، لا يعود العقل متلقيا سلبيا، بل يصير قوة فاحصة، حرة، ومبدعة. فالمعرفة الحقة تبدأ حين يعترف الإنسان بأن طريقه إلى الحقيقة يمرّ أولا عبر وعيه بوسائله. وكل فكر لا يرجع على نفسه بالنظر، محكوم عليه بالتكرار لا بالاكتشاف.