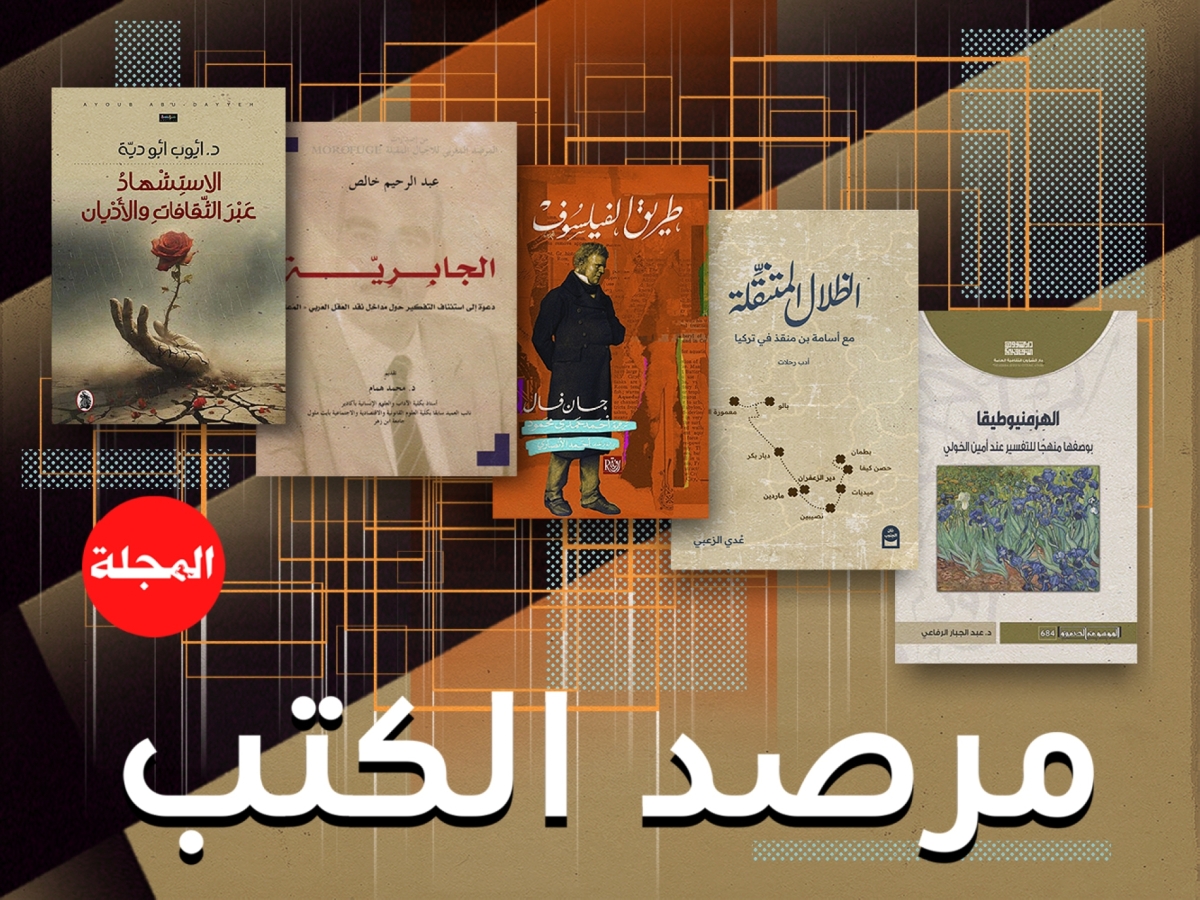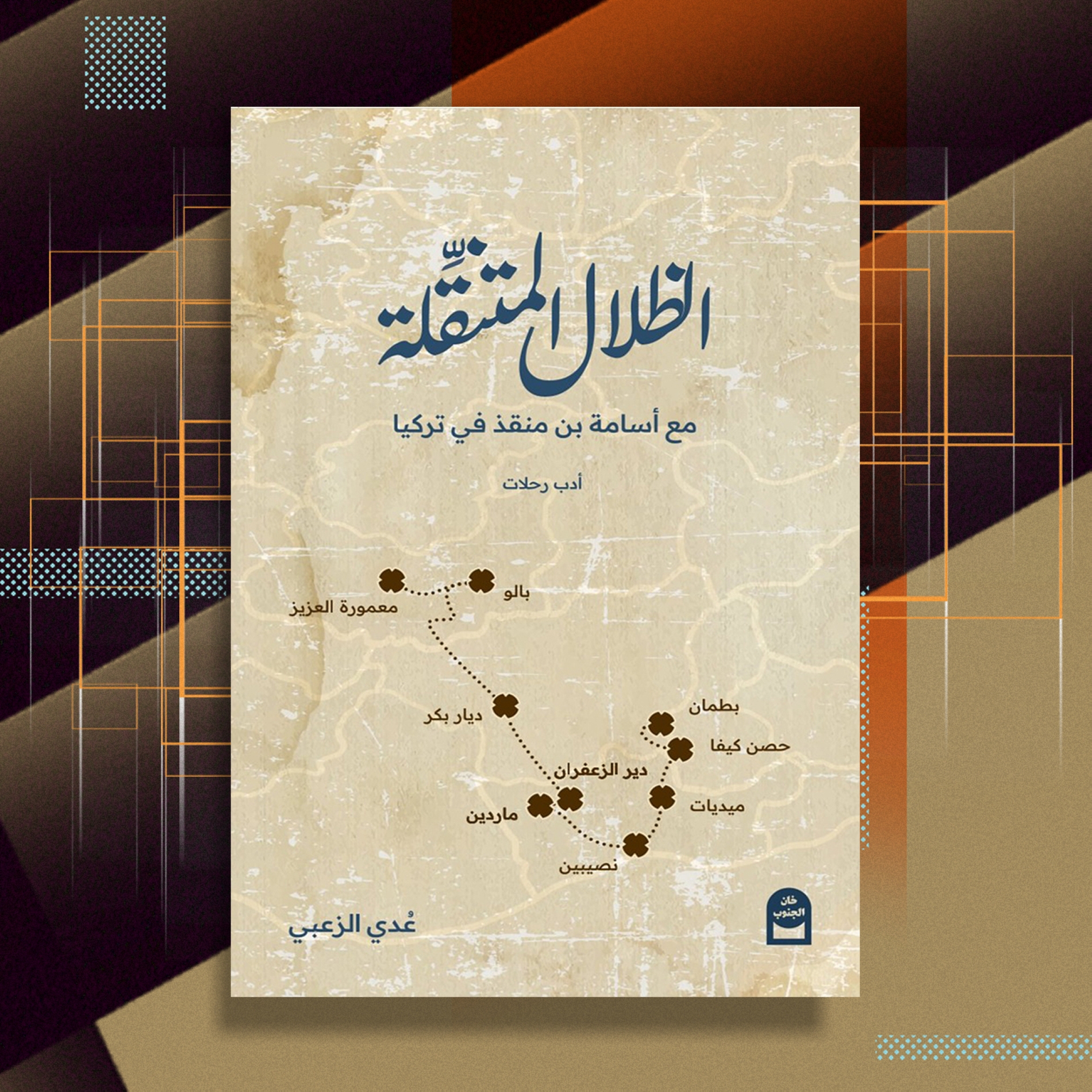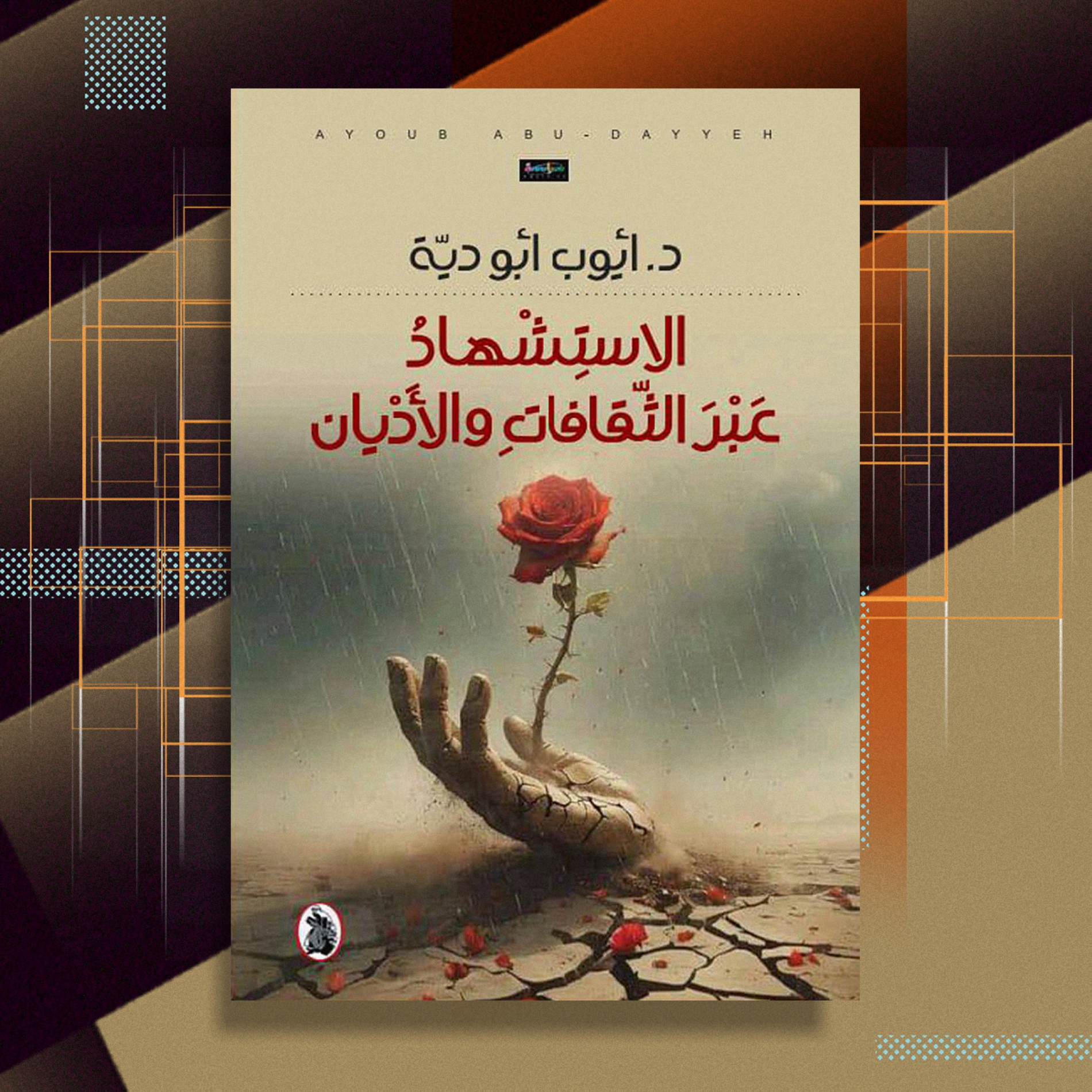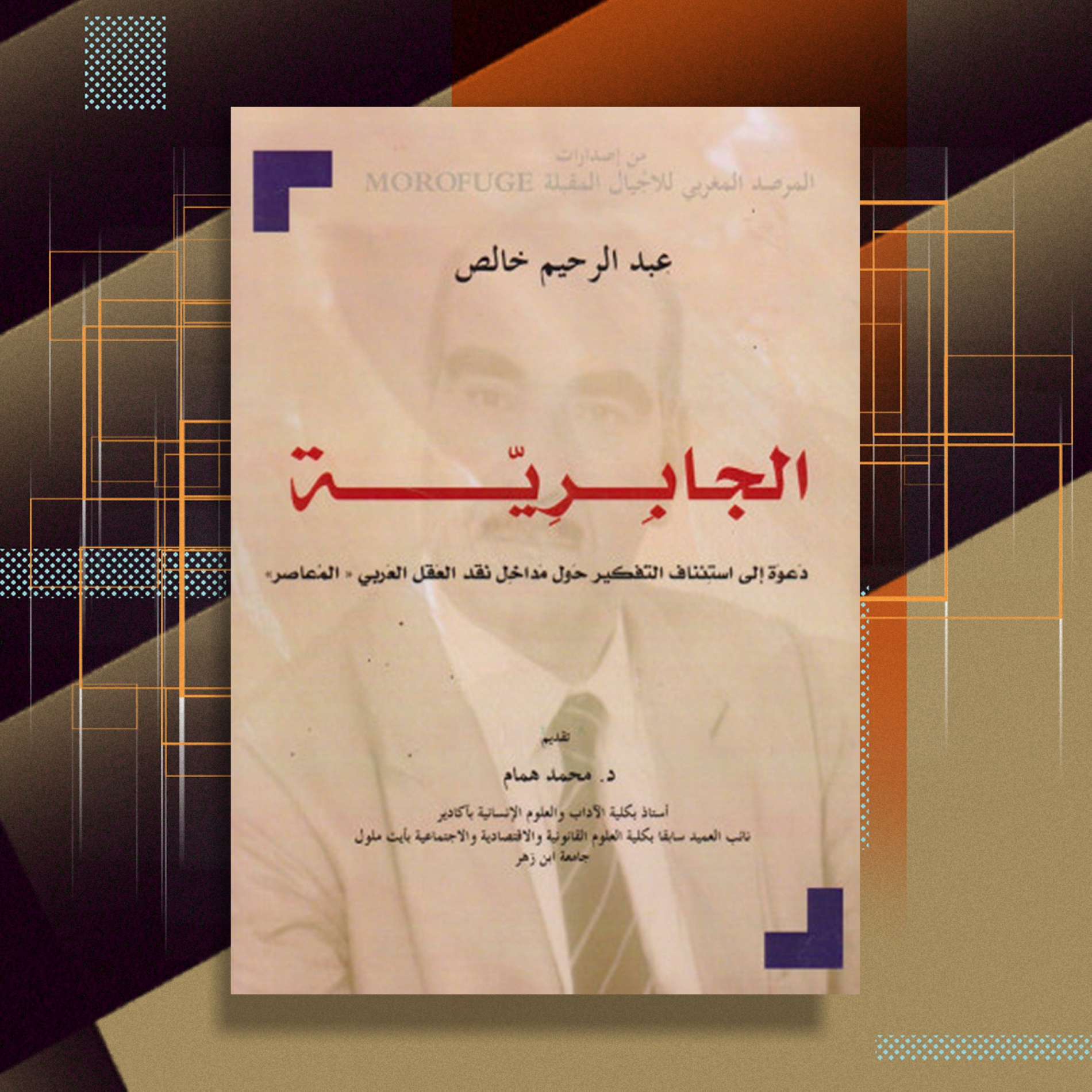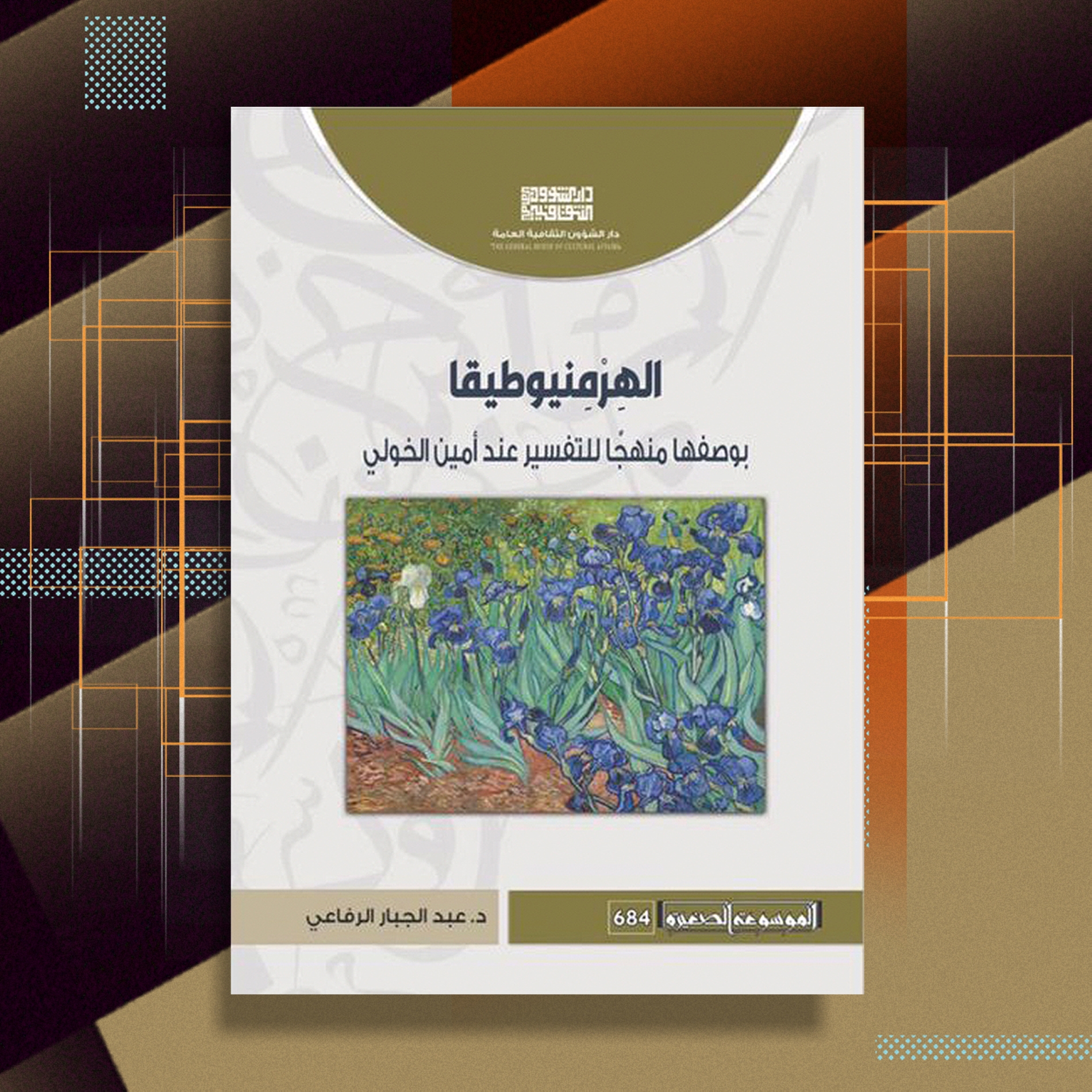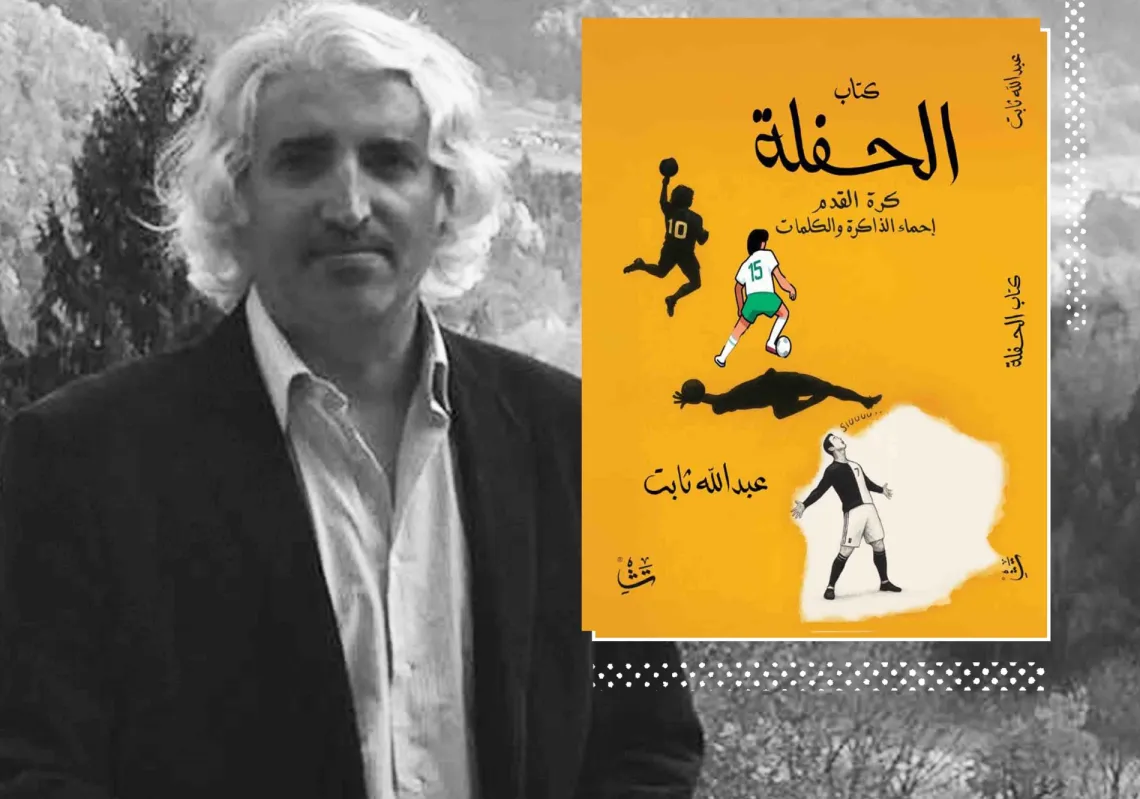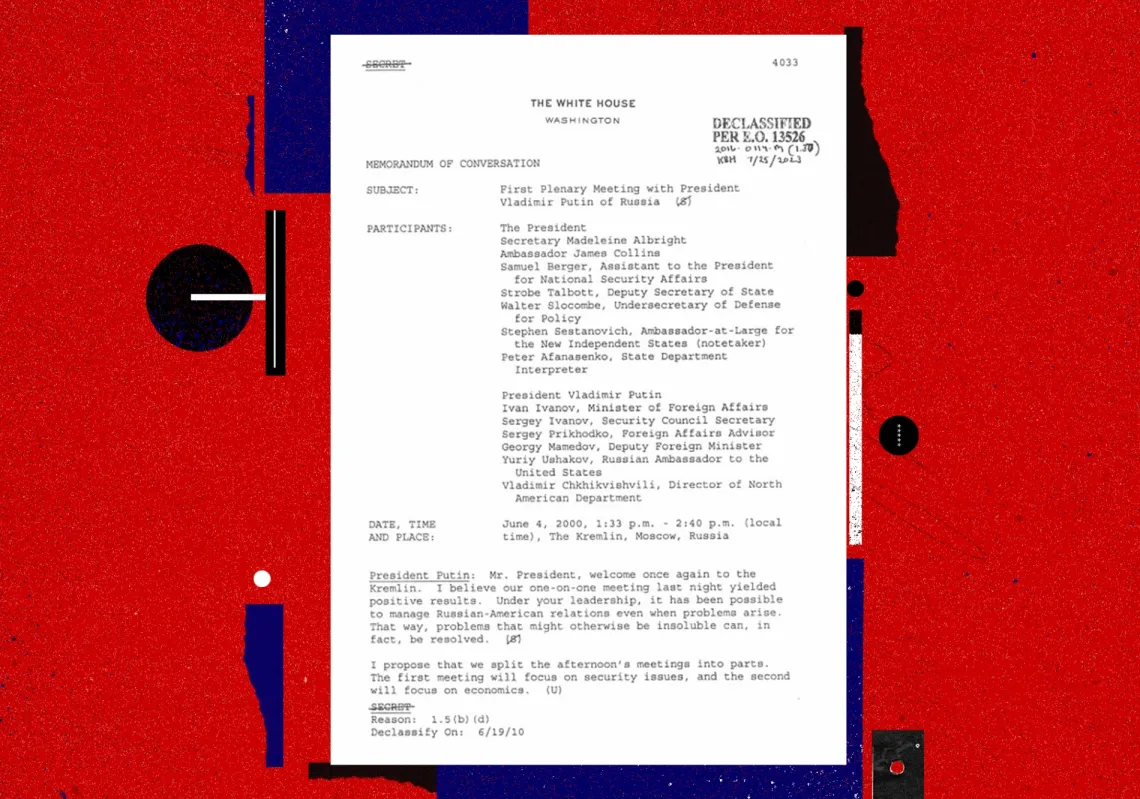نتعرف من خلال هذه الزاوية إلى أحدث إصدارات الكتب العربية، في الأدب والفلسفة والعلوم والتاريخ والسياسة والترجمة وغيرها. ونسعى إلى أن تكون هذه الزاوية التي تطل كل أسبوعين مرآة أمينة لحركة النشر في العالم العربي.
الكتاب: طريق الفيلسوف
الكاتب: جان فال
المترجم: أحمد حمدي محمود
دراسة وتقديم: أحمد الأنصاري
الناشر: دار رؤية للنشر والتوزيع – مصر
هناك إجماع بين دارسي الفلسفة والمهتمين بها على أن كتاب "طريق الفيلسوف" للكاتب الفرنسي جان فال، لا يمكن الاستغناء عنه، ليس للقارئ المتخصص فحسب، بل للقارئ العام أيضا. فهو يعرّف ويعيد تعريف الكثير من المفاهيم الفلسفية بالكثير من التدقيق والشرح والتحليل، علاوة على أنه كتاب متيسر القراءة بسبب أسلوبه البسيط في الشرح وتقديم الأفكار.
بالعودة إلى فهرس الكتاب يجد القارئ كم أن المواضيع والمفاهيم التي قدمها كثيرة ومتنوعة، وكم هي ضرورية لكل مهتم بالفلسفة أن يعرفها، مثل: الميتافيزيفيا والجوهر والكينونة والوجود والواقع والصيرورة والماهية والصورة والكم والكيف والحرية ونظريات المعرفة والقيمة والنفس والديالكتيك وغيرها...
الكتاب هو مجموعة من المحاضرات التي قدمها الكاتب في أكاديميات، لذلك فهو -كما جاء في تعريف الناشر- يختلف جوهريا عن كتب تبسيط الفلسفة التي سادت في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين كـ "قصة الفلسفة" و"مباهج الفلسفة" وغيرهما. وعلى الرغم من ذلك فإنه كتاب يسعى إلى تنوير عقول المهتمين من الطلاب والمبتدئين بتكوين ثقافة فلسفية تعتمد عرض المواقف الفلسفية ومناقشتها بالاتفاق أو الاختلاف اعتمادا على الجمع والتدقيق مع الفحص والتحليل في آن واحد.