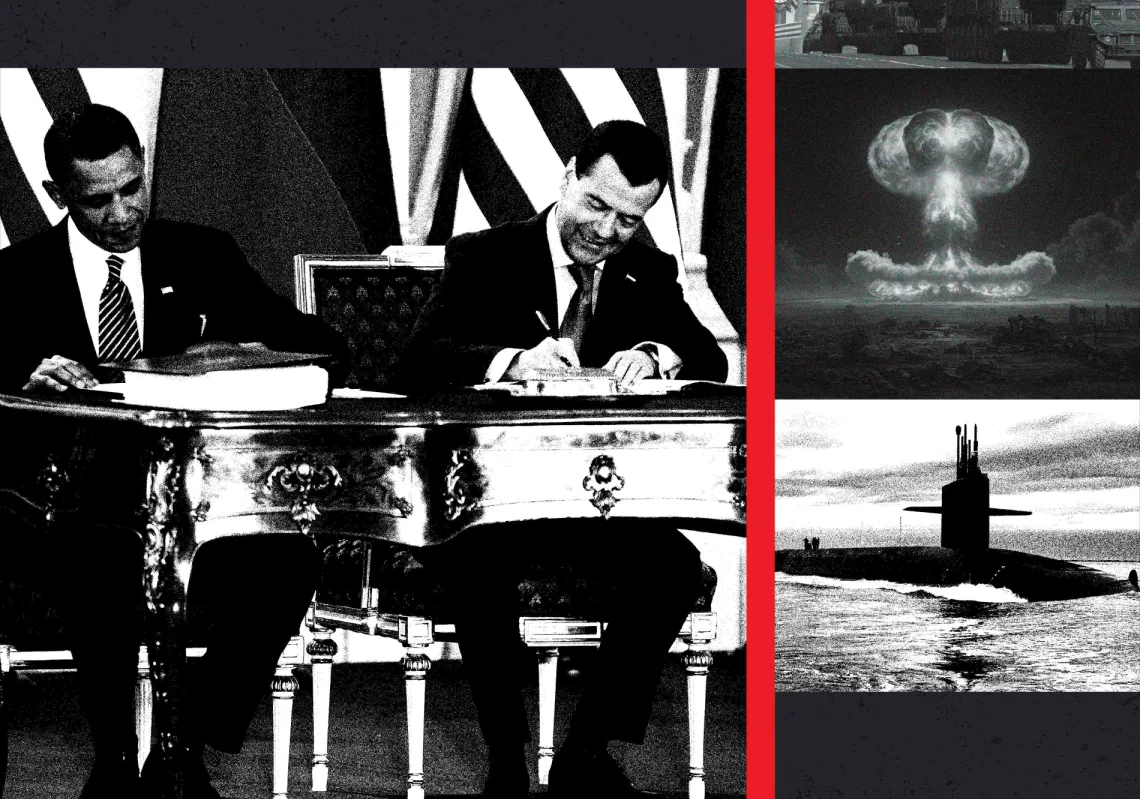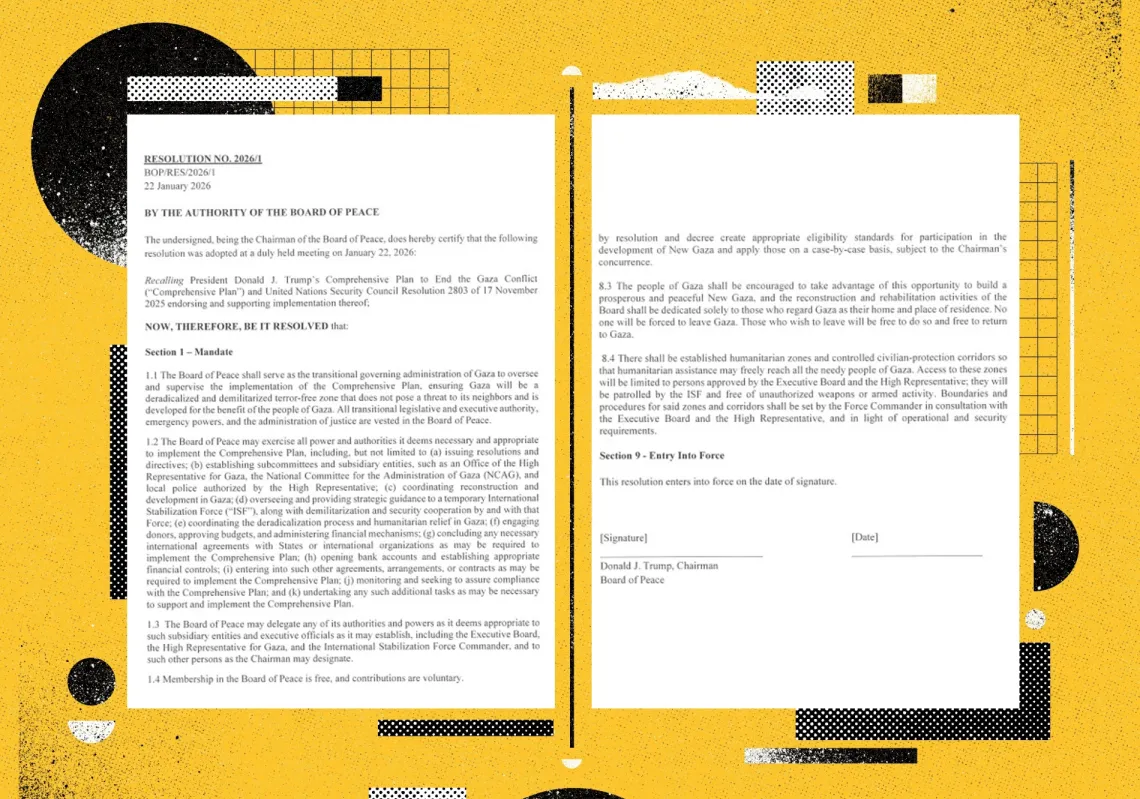في إحدى رحلاتي الأخيرة إلى لندن، ابتكرت لعبة صغيرة لتمضية الوقت على الطرق السريعة الكئيبة في بريطانيا: لعبة عدّ الأعلام. طوال الطريق، راحت تتراءى أمامنا رايات الاتحاد البريطاني (علم المملكة المتحدة) إلى جانب الصليب الأحمر البسيط على خلفية بيضاء، شعار القديس جورج ورمز إنكلترا. كانت الأعلام متدلية بخفوت من فوق الجسور. تساءلت إن كان ثمة سبب لهذا المشهد: هل يخوض المنتخب الإنكليزي بطولة كبرى؟ أم إن الملك يحتفل بذكرى يوبيل أو مناسبة وطنية؟
لم يكن الأمر كذلك. ومع انقضاء واحد من أطول وأشد صيف عرفته البلاد جفافا، بدا أن الشعب البريطاني بأسره قد اتحد في احتفال بذاته، انفجار جماعي من الثقة الوطنية، منبعث من أصدق الدوافع: الفخر بالانتماء إلى الأرض. أعلام كثيرة، لكنها تبدو للوهلة الأولى مجرد تعبير بريء عن رضا ذاتي لا يضير أحدا.
لكن الأعلام ليست بالبساطة التي توحي بها مظاهرها. ففي ظاهرة بدأت صيف العام الماضي وتجددت هذا الصيف بقوة أكبر، يبدو أن البريطانيين يعيشون أزمة هوية. كانت البداية مع أعمال الشغب التي مهّدت الطريق لحكومة "العمال" الجديدة، بعدما أشعلها هجوم دموي على أطفال عزل في ساوثبورت. وكعادتها في تجاهل الحقائق، التقطت وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة بأن منفذ الجريمة طالب لجوء، على الأرجح مسلم، فسارع غرباء إلى البلدة، واحتشدوا في شوارعها، محاصرين مسجدها في أجواء مشحونة بالغضب والريبة.
وتوالت الهجمات. من أبرزها الهجوم على فندق قيل إنه يؤوي لاجئين، حيث حاول المحتجون اقتحامه، ولما فشلوا أشعلوا فيه النيران. وكانت المعجزة أن لا يسفر الحادث عن قتلى.
وبعد عام كامل، لا تزال التوترات حول ملف الهجرة مشتعلة، بل إنها ازدادت التهابا. وأبرز الأمثلة اليوم هو فندق "ذا بيل" في مدينة إيبينغ، التي حاول المجلس المحلي فيها الطعن في حق الحكومة باستخدام الفندق لإيواء المهاجرين، لكنه خسر القضية. بقي المهاجرون في أماكنهم، غير أن ذلك لم يُهدئ الأجواء؛ فالاحتجاجات ما زالت مستمرة، والغضب لم يخفت.
ما بدا في البداية مجرد هوس عشوائي بالأعلام هو في الحقيقة جزء من حملة منظمة استولت على مخيلة الأمة. فمن نيوكاسل إلى نورويتش، راحت الأعلام تتدلى من أعمدة الإنارة. وحين اعترضت بعض المجالس المحلية على هذه "الوطنية التلقائية"، بادر السكان إلى شراء أعمدة خاصة وتثبيتها أمام بيوتهم.
في أحياء مثل تاور هامليتس وبرمنغهام، يُقرأ انتشار الأعلام المفاجئ كرد فعل على الرايات الفلسطينية التي رُفعت منذ اندلاع حرب غزة. أما في أماكن أخرى، فتبدوا أشبه باحتجاج صامت ضد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزي في قوارب واهية ويصلون إلى شواطئ مقاطعة كِنت. وككل الأعلام، فهي صامتة بطبيعتها، لكن ما يمنحها معناها هو السياق: متى وأين تُرفع.
وكان الصليب الأحمر على خلفية بيضاء – صليب القديس جورج أكثر حضورا بكثير من علم الاتحاد البريطاني في إحصائي على الطرق السريعة. جذوره تعود إلى الحروب الصليبية، لكنه صار اليوم شعارا شائعا بين مشجعي كرة القدم الإنكليز، الذين يرتدونه في المدرجات أحيانا مع دروع وسلاسل معدنية تستعيد أجواء القرون الوسطى.
غير أن هذا العلم بدأ يظهر في أماكن غير مألوفة. ففي كناري وورف، قرب فندق قيل إنه يؤوي طالبي لجوء، لم يُرفع على قطعة قماش، بل رُسم بجرأة على خطوط معبر مشاة. وفي مكان آخر، جرى عكس ألوانه بالخطأ على جزيرة مرورية، فبدا لا كعلم إنكلترا، بل كعلم الدنمارك.
وقد علّق أحد قراء صحيفة "الغارديان"، ويدعى أندرو غولد، بسخرية على هذه المفارقة قائلا: "إن ريتشارد قلب الأسد هو من تبنى هذه الراية أول مرة، ومع ذلك قضى معظم حياته في فرنسا، بالكاد وطئت قدماه إنكلترا، ولم يتحدث الإنكليزية مطلقا. أما القديس جورج نفسه فكان جنديا رومانيا، وُلد فيما يُعرف اليوم بتركيا، واستشهد من أجل إيمانه المسيحي". ثم ختم غولد متهكما: "يا لها من تعددية ثقافية تجعلك فخورا بكونك بريطانيا".
فمن أين جاء هذا الطوفان المفاجئ من الصلبان؟ الحقيقة أن العفوية لا تفسره. وراءه حملة منظمة تُعرف باسم "عملية رفع الألوان". ووفقا لمنظمة "الأمل لا الكراهية"، فإن أحد مؤسسي الحملة هو أندرو كوريين، الذي يفضّل أن يُعرف باسمه الحركي "آندي ساكسون".