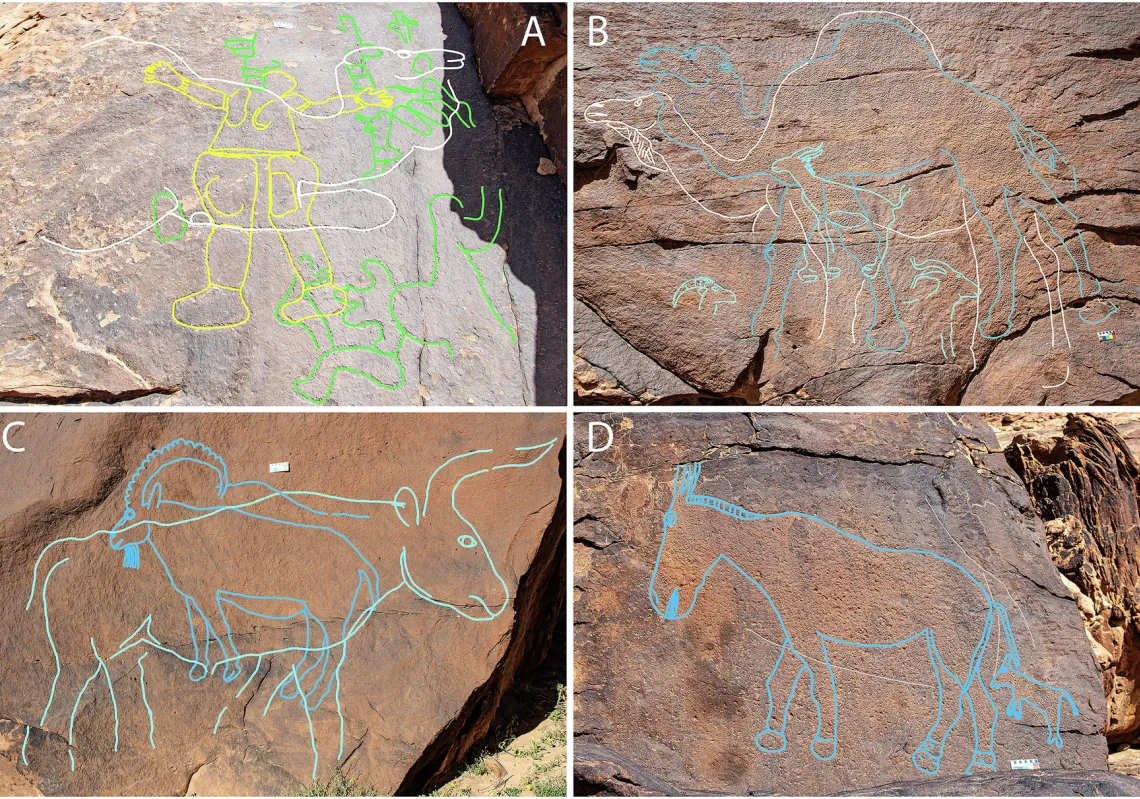ظل معبد الكرنك الواقع في مدينة الأقصر جنوب مصر موضوعا لتكهنات طويلة حول بداياته الأولى، إذ لم تكن هناك أدلة قاطعة تحدد زمن أول استيطان بشري في المكان ولا السبب وراء اختيار هذا الموضع تحديدا لبناء أكبر مجمع ديني في مصر القديمة.
ومع أن النصوص القديمة تحدثت عن طيبة بوصفها "المدينة المقدسة"، فإن الجغرافيا الدقيقة للكرنك بقيت غامضة. وقد افترض بعض الباحثين في العقود الماضية أن المعبد بني فوق أرض كانت قريبة من فرع قديم للنيل، لكن غياب الأدلة الجيولوجية جعل تلك الفرضيات محل جدل واسع.
جاءت دراسة جديدة لتملأ هذا الفراغ المعرفي، إذ استخدم الباحثون منهجا ميدانيا دقيقا شمل حفر احدى وستين عينة رسوبية داخل منطقة المعبد وفي محيطه المباشر، إلى جانب تحليل آلاف القطع الفخارية التي وجدت في الطبقات نفسها. وبمقارنة النتائج الجيولوجية مع الفخار المؤرخ زمنيا، تمكن الفريق من رسم خريطة زمنية لتغيرات الموقع تمتد لأكثر من أربعة آلاف عام.
قالت دراسة علمية حديثة إن معبد الكرنك وهو أحد أضخم المعابد الدينية في العالم القديم وأحد أعمدة التراث الإنساني، نشأ في الأصل فوق جزيرة مرتفعة أحاطت بها مياه النيل منذ أكثر من أربعة آلاف عام، قبل أن يتحول عبر القرون إلى المركز الأكبر لعبادة الإله آمون رع. وقد كشفت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعتي ساوثهامبتون البريطانية وأوبسالا السويدية، عن تفاصيل غير مسبوقة حول أصل المعبد وجغرافيته المقدسة، مشيرة إلى أن موقعه ارتبط ارتباطا مباشرا بمفهوم الخلق الأول في العقيدة المصرية القديمة. ويمثل هذا البحث أوسع دراسة جيومورفولوجية أُجريت على موقع الكرنك حتى اليوم، بما يوفر فهما علميا جديدا للعلاقة بين الطبيعة المقدسة والمكان الديني في مصر القديمة.
تعود أهمية الدراسة إلى أنها تمثل تحولا نوعيا في منهج دراسة المواقع الأثرية الكبرى في وادي النيل، إذ انتقلت بالتحليل من منظور أثري محض إلى مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين الجيولوجيا والهيدرولوجيا والآثار وتاريخ الدين. ويعد هذا الاتجاه العلمي المتكامل محاولة لفهم كيف تشكلت البيئة الطبيعية التي احتضنت أبرز المعابد المصرية، وكيف ساهمت هذه البيئة في بلورة التصورات الدينية نفسها التي وُلدت داخلها. ومن خلال هذه المقاربة، يصبح الكرنك ليس فقط معبدا حجريا عظيما، بل نموذجا لعلاقة تفاعلية بين الإنسان والنهر، وبين المعمار والفيض، وبين المعتقد والجيولوجيا.