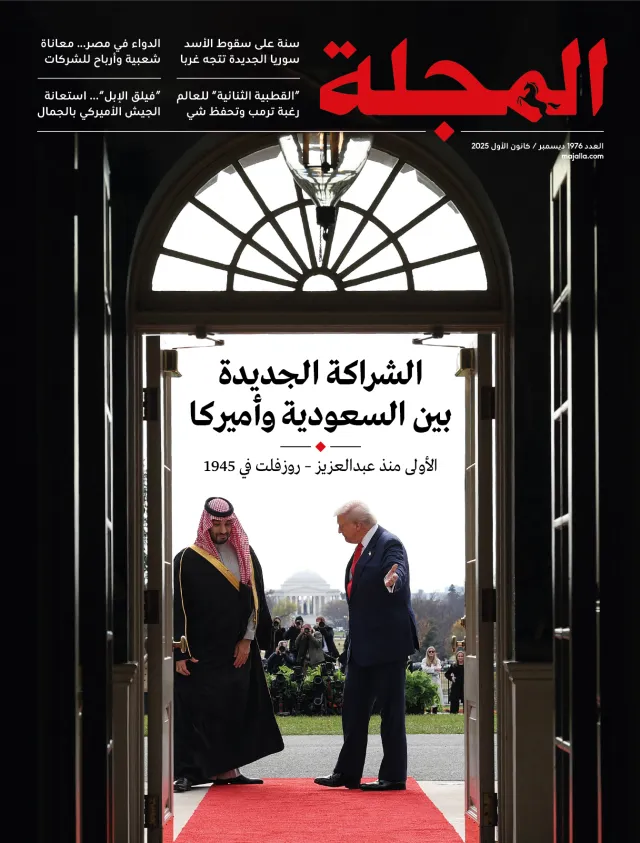في هذه الأيام أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة "ملتقى الترجمة الدولي لعام 2025"، في أجواء احتفالية بهيجة جمعت المترجمين والباحثين وصناع اللغة من مختلف أنحاء العالم. وقد كان الملتقى بمثابة كرنفال أو مهرجان كبير للمترجمين، وفرصة للتعارف وتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث الاتجاهات التي تشكل ملامح مستقبل الترجمة في ظل التحولات التقنية المتسارعة. الملتقى أقيم في السنوات الماضية، لكن الجهد هذه السنة كان فاخرا لدرجة تستحق الإشادة والتنويه بنشاط من يعملون بصمت.
وفي أحد أيام الملتقى، أقيمت ورشة عمل قدمها الباحث والمفكر التقني الأميركي ستيفان هوي، حول موضوع "الذكاء الاصطناعي الوكيلي"، وهو مفهوم جديد بدأ يفرض نفسه بقوة في السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات اللغة والإبداع. رؤية مختلفة حول ما يمكن للآلة أن تفعله حين لا تكتفي بالتنفيذ، بل تبدأ بالفهم والاستنتاج والتصرف الذاتي.
ستيفان هوي من أولئك الذين يعتقدون أن لا حدود لما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، وقد تحدث مستعرضا الفارق الجوهري بين الذكاء الاصطناعي التقليدي الذي يجيب بناء على أنماط محفوظة، وبين الذكاء الوكيلي الذي يمتلك قدرة على تمثل الأهداف واتخاذ القرارات وفق سياق متغير. فالنظام الوكيلي ليس مجرد برنامج، بل كيان رقمي قادر على التعقل السياقي، يتفاعل مع المعطيات المحيطة، ويتعلم من التجربة، ويقيم علاقات متبادلة مع المستخدمين ومع بيئته الرقمية.
وقدم هوي مثالا عمليا، حين يطلب من نظام لغوي تقليدي ترجمة فقرة من نص فلسفي، فإنه يكتفي بتحليل الجمل، واستبدال الكلمات بما يقابلها في اللغة الأخرى. أما الذكاء الوكيلي فشيء جديد، حيث يحاول فهم نوايا الكاتب، وسياق النص، والمستوى المفهومي المطلوب، بل قد يقترح على المترجم أكثر من أسلوب للترجمة وفق الغاية المستهدفة من النص. إنه لا يعمل بالمطابقة الآلية، بل بالفهم الموجه نحو الهدف.
وأوضح ستيفان هوي أن هذا النوع من الذكاء يسمى "الذكاء الوكيلي" (agentic) لأنه يملك نوعا من الوكالة، أي القدرة على التصرف المستقل داخل حدود معينة. فهو لا يكتفي بما يملى عليه، بل يستطيع إدارة المهام، وتحديد الأولويات، وتحليل أخطائه السابقة لتجنبها مستقبلا. هذه السمة تجعله قريبا من طريقة تفكير الإنسان حين يواجه مشكلة ويبحث عن أفضل حل ممكن لها في ضوء ما يعرفه وما يريده.
الآلة يمكنها أن تتعلم أسلوب المترجم، وأن تحاكي تفضيلاته الجمالية، بل أن تقترح حلولا لغوية منسجمة مع أسلوبه الشخصي عبر التعلم المستمر من نصوصه السابقة
ولعل ما شد انتباه الحاضرين أكثر هو حديث "هوي" عن علاقة هذا الذكاء بعالم الترجمة تحديدا. فالمترجم، كما قال، ليس ناقلا للكلمات، بل فاعل تأويلي يشتغل على المعنى ضمن شبكة من العلاقات الثقافية والتاريخية. ومن هنا، يمكن للذكاء الوكيلي أن يصبح شريكا فعالا للمترجم، يسانده في استكشاف الاحتمالات، لا أن يحل محله. فالآلة يمكنها أن تتعلم أسلوب المترجم، وأن تحاكي تفضيلاته الجمالية، بل أن تقترح حلولا لغوية منسجمة مع أسلوبه الشخصي عبر التعلم المستمر من نصوصه السابقة.
وقد تطرق المتحدث إلى البنية التقنية لهذا النوع من الأنظمة، موضحا أنها تقوم على نماذج متعددة الطبقات، تمكن الذكاء من بناء صورة ديناميكية عن العالم. فهو لا يخزن المعلومات فحسب، بل ينشئ نموذجا ذهنيا للعالم الرقمي الذي يعمل فيه، ويتعامل مع المهام مثلما يتعامل الإنسان مع الواقع، من خلال الفرضيات والتجريب، والتصحيح وإعادة التقييم. هذه السمة تجعل الذكاء الوكيلي مختلفا عن المساعدين الآليين الذين يلتزمون بالأوامر الثابتة دون تجاوزها.
ثم طرح "هوي" سؤالا أثار نقاشا حيا: هل يمكن لهذا الذكاء أن يبدع فعلا؟ أم إنه يظل انعكاسا لما يزوده به الإنسان؟ وأجاب بأن الإبداع الإنساني لا يختزل في الخوارزمية، ولكن يمكن للذكاء الوكيلي أن يوسع أفق الإنسان المبدع، لأنه يتيح له التفاعل مع كيان رقمي يتعلم منه بقدر ما يتعلم منه الإنسان. وبهذا التبادل، تنشأ بيئة من التعاون التفاعلي الذي قد ينتج أشكالا جديدة من الكتابة والترجمة، تتجاوز النماذج القديمة القائمة على الفصل بين المبدع وأداته.
بعد انتهاء المحاضرة، شعر كثيرون بأن ما شاهدوه لم يكن عرضا تقنيا بقدر ما كان تأملا في مستقبل اللغة نفسها. فالذكاء الوكيلي كما وصفه "هوي" يتجاوز كونه أداة سريعة أو أرخص من اليد البشرية، إلى أن يكون مرحلة جديدة في تطور الوعي، إذ تبدأ الآلة في فهم العالم الذي تعمل فيه، وتطور علاقة تفاعلية مع الإنسان لا تقوم على الأمر والطاعة، بل على التعاون والتعلم المتبادل.
وفي نهاية الملتقى، بدا واضحا أن العالم اللغوي يمر بتحول جذري. وقد برز الآن أمام الجيل الحالي من المترجمين تحد مزدوج، من جهة، امتلاك أدوات تقنية لم يكن يحلم بها السابقون، ومن جهة أخرى، ضرورة تحديد العلاقة مع هذه الأدوات بحيث تظل خادمة للمعنى لا أوصياء عليه.
الترجمة ليست نقلا محايدا للكلمات فحسب، بل هي انكشاف للمعنى، ولقاء بين العقول والثقافات، وتجسيد للروح في اللغة
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح السؤال الفلسفي المركزي نفسه: كيف يمكن الحفاظ على إنسانية اللغة في عصر تتكلم فيه الآلات؟ هذا سؤال كبير. لكن الذي لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي فتح أمام الترجمة آفاقا واسعة نحو الدقة والفهم السياقي، وفي الوقت نفسه يذكر أن جوهر الترجمة سيبقى فعلا إنسانيا لا يمكن لأي نظام استبداله. فالترجمة ليست نقلا محايدا للكلمات فحسب، بل هي انكشاف للمعنى، ولقاء بين العقول والثقافات، وتجسيد للروح في اللغة.