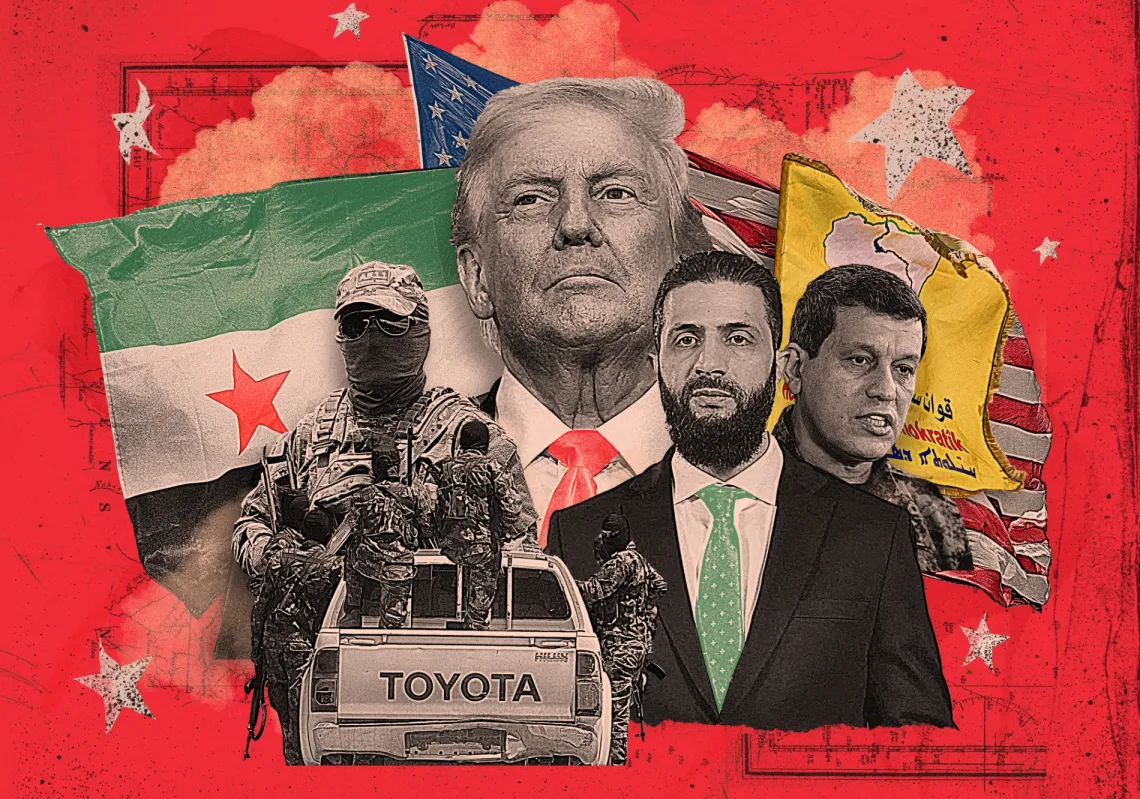منذ ستينات القرن الماضي، صارت البنيوية أكثر من مجرد توجه فكري، غدت موضة ثقافية، وككل موضة، اجتاحت ميادين متعددة متنوعة: الفلسفة، والأنثروبولوجيا، والنقد الأدبي، واللسانيات، وعلم النفس، وصولا إلى الفكر السياسي. أسماء كبرى اقترنت بهذه "الحركة": كلود ليفي-ستروس، أ. جوليان غريماس، تزفيتان تودوروف، ميشيل فوكو، رولان بارت، جاك لاكان، لوي ألتوسير، لوسيان سوباغ... وغيرهم.
في قلب البنيوية، كان هناك رهان نظري: وهو أن اللغة، والثقافة، والأسطورة، والسلوك، كل هذه الظواهر تخضع لبنى غير مرئية، يمكن تحليلها كأنظمة، مستقلة عن الأفراد، وعن الحركة التاريخية.
كانت الثورة البنيوية في جوهرها ثورة على المعنى والقصدية والذات والتفسير التكويني، مستبدلة كل ذلك بـ"المنظومة"، و"البنية"، و"اللاوعي البنيوي".
منذ بدايات هذه "الحركة"، وحتى عندما كانت ما تزال في أوج ازدهارها، كان رولان بارت قد نبه إلى أن قضية البنيوية، رغم المظاهر، ليست هي البنية وما تثيره من إشكالات، وأنه "لا يكفينا الحديث عن بنيات النصوص لكي نكون بنيويين (...) وإلا فستكون البنيوية عريقة في القدم: فكون العالم بنية، وكون الأشياء والحضارات بنيات، هذا أمر عرفناه منذ زمن بعيد، أما الجديد فهو التمكن من الخلخلة".
قد يبدو غريبا، للوهلة الأولى، أن يصرف أحد أعمدة البنيوية ذهننا عن مفهوم البنية في تحديده للبنيوية، إلا أن هدفه، كما يبدو، هو أن يضع أصبعنا على أهم ما طبع تلك "الحركة"، التي لم تقتصر على مجال الأدب والفلسفة، وإنما امتدت لتطال ميادين الدراسات الإبستمولوجية والأنثربولوجية والتاريخية، وأهم ما طبعها في نظر صاحب "أسطوريات" هو طاقتها وقوتها على الخلخلة، وعلى زعزعة ما يعد ثابتا، طبيعيا، أو متماسكا.