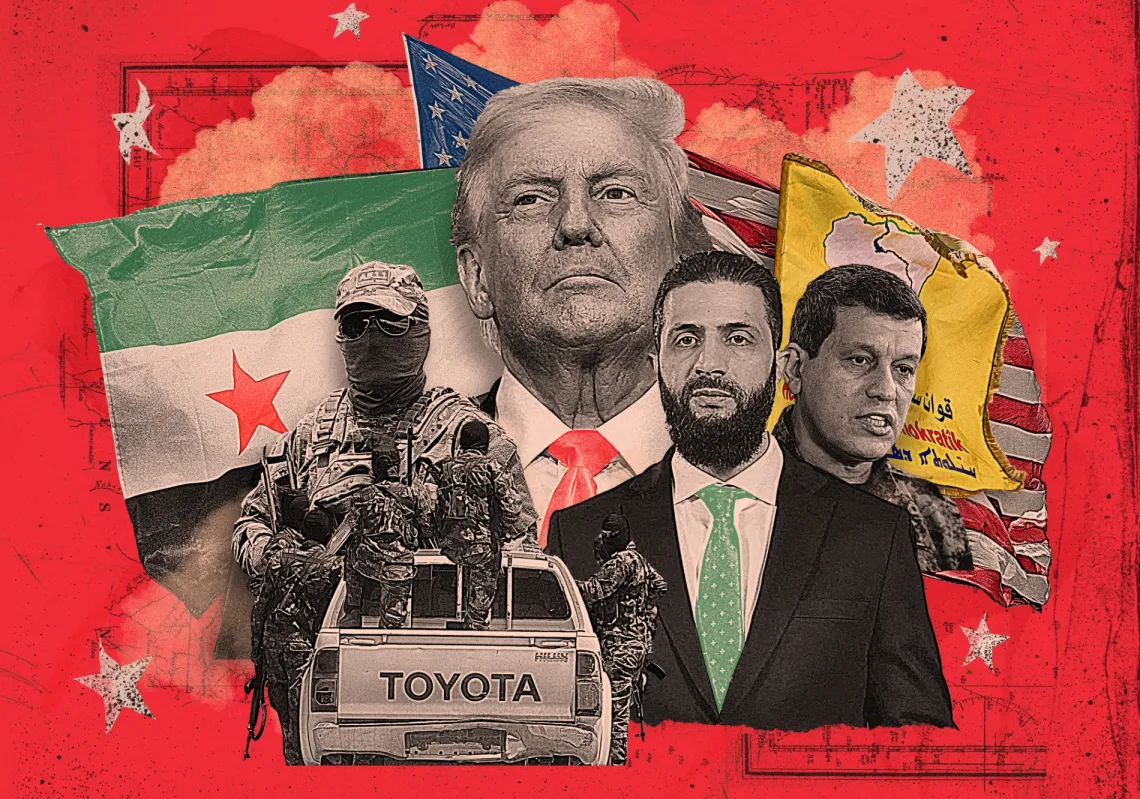القاهرة: لقد أثبت الوقت والخبرة أن مصر هي، إلى حد بعيد، أهم شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتسم بأنها الأكثر تعقيدًا ومحلاً لسوء الفهم. على الرغم من أن الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جوزيف بايدن استغرقت أكثر من خمسة أشهر لإدراك هذه الأهمية، خاصة بعد تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وحماس، يبدو أن العلاقة بين الحليفين القديمين تشهد أخيرًا قفزة نوعية إلى المسار الصحيح.
في 8-9 نوفمبر (تشرين الثاني)، استؤنف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر بعد سنوات من الجمود، وهو يبشر بمرحلة جديدة كاملة في العلاقة بين البلدين التي يعود تاريخها إلى قرن مضى. ومع ذلك، انطلاقًا من تاريخ العلاقات بينهما، علينا أن نسأل عن المدة التي يُتوقع أن يستمر فيها هذا الزخم قبل أن تطفو الخلافات غير المحسومة بين الدولتين إلى السطح، مرة أخرى.

علاقات ودية صعبة
في العام المقبل، سنحتفل بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة. يرجع بعض المؤرخين بداية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة إلى القرن التاسع عشر؛ عندما سُمح للأطباء الأميركيين بالوصول إلى مصر لمساعدة الجنود السودانيين الجرحى، في عام 1823. وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل، لم تكن العلاقة بين الحليفين سهلة أو سلسة على الإطلاق؛ بل تجسيد مثالي لعلاقة ودية صعبة.
وعلى الرغم من اعتراف البلدين بأنه لا يمكن الاستغناء عن بعضهما البعض، دائمًا ما توجد خلافات قوية في المعتقدات والتصورات بين القادة المصريين والأميركيين المتعاقبين، مما جعل من الصعب على فترات التعاون القصيرة أن تسفر عن أي آثار ملموسة على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، تركت الفترات الطويلة من الفتور والتباعد ندبات غير قابلة للإزالة على كل جانب، وإن كانت بدرجات متفاوتة من الألم.
في الوقت الحالي، نشهد لحظة صعود في الشؤون الأميركية المصرية ينبغي استخدامها بشكل مناسب لجعل مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر أكثر ثباتًا واستدامة، من خلال التغلب على نمط الصعود والهبوط، أو الفتور والدفء، في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر .
عقدت الأسبوع قبل الماضي في واشنطن جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري بقيادة وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. وتناول الحديث، الذي استمر يومين، بين الوفدين الدبلوماسيين رفيعي المستوى، العلاقات الثنائية، فضلاً عن التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد جاء في البيان الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية: «مصر شريك حيوي للولايات المتحدة. نحن ملتزمون بتعزيز الشراكة الأميركية المصرية التي استمرت أربعين عامًا». وفي ختام الحوار، أصدر البلدان بيانا مشتركا أكد على «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والقضايا الثقافية، والشؤون القنصلية. وحقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. كما اتفقا على أهمية إجراء هذا الحوار على أساس منتظم».
هذه هي الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية المصرية الأميركية التي تعقد في ظل إدارة بايدن الجديدة، كما أنه أول حوار فعلي بين الحليفين منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أسفرت عن تغييرين للنظام في مصر خلال أقل من ثلاث سنوات. ولا يمكن احتساب الجولة السابقة من الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري التي عقدت عام 2015، حيث تمت في وقت شابته التوترات بين إدارة الرئيس أوباما والرئاسة المصرية الجديدة آنذاك للسيسي. وجعلت الاضطرابات السياسية والأمنية التي طغت على مصر في ذلك الوقت من الصعب وضع أي خطط بشكل مناسب أو تطبيقها بشكل ملموس.
ومع ذلك، هذه المرة، تشارك مصر في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة كدولة قوية راسخة يمكنها حقًا إحداث تغيير في المنطقة. علاوة على ذلك، تبدو السياسة الخارجية لإدارة بايدن تجاه مصر ودول أخرى في المنطقة أكثر برغماتية وتفهماً مما كان متوقعاً منه مسبقاً.

ثنائية حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية
على الرغم من الخلافات السياسية والدبلوماسية العديدة بين مصر والولايات المتحدة، إلا أن التعاون العسكري بين البنتاغون والقوات المسلحة المصرية لم يتزعزع. فعلى العكس، لعبت هذه الرابطة القديمة بين الجيشين دورًا هائلًا في السيطرة على نتائج لحظات الاضطرابات الحرجة في مصر والشرق الأوسط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حرب الخليج عام 1991 والأحداث اللاحقة للربيع العربي عام 2011.
يذكر أن التعاون الاستراتيجي الأميركي المصري في مجال الدفاع، بدأ في النصف الثاني من السبعينات، عندما قرر الرئيس أنور السادات إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قطعها سلفه جمال عبد الناصر لصالح حلفائه الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي. بعد ذلك، في الثمانينات، انتقلت العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر إلى مستوى جديد تمامًا حيث بدأت الولايات المتحدة في تقديم التدريب والمساعدات المالية للجيش المصري، وفقًا لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
ومن بين معايير العلاقة العسكرية القوية بين البلدين التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات (النجم الساطع)، والتي تقام سنويًا منذ عام 1981 على الأراضي المصرية وتحت إشراف أميركي. في سبتمبر (أيلول) الماضي، نظمت الولايات المتحدة ومصر أكبر مناورات عسكرية في تاريخ «عملية النجم الساطع»في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، شاركت فيها 21 دولة من جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، تعرضت العلاقات العسكرية القوية بين الولايات المتحدة ومصر للاستخدام بشكل غير مناسب، أكثر من مرة، للضغط على الدولة المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومن المؤسف أن الإدارة الأميركية الحالية تصر على اتباع نفس اللعبة المحفوفة بالمخاطر مع مصر، على الرغم من أنها أثبتت ضررها لكلا الجانبين في الماضي. وفي سبتمبر، ذكرت مجلة «بوليتيكو»أن إدارة بايدن تبحث وقف 10 في المائة من المساعدات العسكرية المستحقة لمصر (حوالي 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار) من أجل الضغط على الدولة المصرية لتحسين أدائها فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان واحترامها. وصرح مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركيةلـ«بوليتيكو»التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن المبلغ المجمد قد يكون متاحاً في السنوات المالية المقبلة إذا نجحت مصر في تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
ومن المؤسف أن إدارة الرئيس بايدن لم تتعلم من أخطاء الإدارة السابقة وليست على استعداد لتغيير السياسة المعيبة الممثلة في تطبيق الضغوط الاقتصادية والسياسية، من خلال قطع أو تجميد المساعدات العسكرية، لدفع مصر إلى تحسين حقوق الإنسان.هذه الطريقة لم تنجح مع الأنظمة المصرية السابقة ولن تنجح مع القيادة المصرية الحالية. ناهيك عنالأثر السلبي الذي ستتركه على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أدى ربط المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بتحسين أداء الدولة في قضايا حقوق الإنسان إلى إثارة عشرات الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة ومصر في الماضي، مما كان له كبير الأثر على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
ففي عام 2005، هددت الإدارة الجمهورية للرئيس جورج بوش الابن بقطع جزء من حزمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية السنوية المستحقة لمصر، إذا لم يخصص الرئيس مبارك في ذلك الوقت مساحة في البرلمان للإخوان المسلمين، الذين قدموا أنفسهم للمجتمع الدولي كمعارضين سياسيين في ذلك الوقت.ونتيجة لذلك، اكتسب الإخوان المسلمون والسلفيون المتطرفون نفوذاً أكبر على الساحات الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل مصر. وأثناء ذلك، توقفت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة لفترة طويلة قرابة أربع سنوات، حتى حل أوباما محل بوش في عام 2009. وخلال تلك السنوات، تعرقل دور الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.
بعد عشر سنوات، قاد المصريون خلالها ثورتين ناجحتين أسقطتا نظام مبارك الاستبدادي في عام 2011، ونظام الإخوان المسلمين الثيوقراطي في عام 2013، لعبت إدارة الرئيس أوباما نفس الورقة الخطيرة بخلط المساعدات العسكرية بقضية حقوق الإنسان ضد النظام الحالي بقيادة الرئيس السيسي. وعلى غرار ما حدث مع الرئيس بوش، جاءت خطوة إدارة أوباما بنتائج عكسية وألحقت أضرارًا جسيمة بالنفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة على الشرق الأوسط، بينما لم تحفز في المقابل أي إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان كنتيجة مباشرة لهذا الضغط.
خلال العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر، بشكل شبه حصري، على الولايات المتحدة في التسلح. تتلقى مصر حزمة مساعدات اقتصادية وعسكرية قدرها 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة على أساس سنوي، تماشيا مع بنود اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1979. وبعد أشهر قليلة من الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة في عام 2013، قررت إدارة أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وبالتالي أوقفت جهود المشتريات العسكرية. تم رفع تجميد المساعدات جزئيًا في عام 2015، ثم تم تطبيقه مرة أخرى في عام 2016، ثم رفع مرة أخرى في عام 2018، بعد أن تولى ترامب الرئاسة، ثم توقف جزئيًا في نهاية إدارة ترامب.
في النهاية، وجدت مصر نفسها مضطرة للتخلي عن الولايات المتحدة كحليف عسكري حصري لها، وقررت تنويع مصادر التسلح بنشاط لتجنب عواقب إساءة استخدام الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية في ممارسة الضغوط السياسية.
واليوم، تشمل الدول المصدرة والحلفاء العسكريون لمصر: روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ووفقًا لمعهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، احتلت مصر المركز الثالث بين أكبر 25 مستوردًا للأسلحة في العالم عام 2019.
وعلى هامش الزيارة الأخيرة، التقى الوفد المصري خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري بمسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأميركية. وكانت تلك فرصة جيدة بالتأكيد لمناقشة النهج المعيب المتمثل في استخدام حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر كأداة للضغط من أجل تحسين أداء حقوق الإنسان. إلا أن البيان الختامي للاجتماع لم يشر إلى أي تقدم في هذه القضية بالذات، على الرغم من أهميتها القصوى. وكان ما جاء في البيان المشترك الآتي: «رحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات مروحية مصرية طراز أباتشي، مما يدعم مئات الوظائف الأميركية ويرفع مستوى الاستعداد العسكري المصري».

إقليمياً: السودان قبل أي شيء آخر
يجاوز نطاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية المباشرة للعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. استخدمت الحلقات السابقة من هذا الحوار الاستراتيجي لتحديد أجندة المناطق التي تهم الولايات المتحدة، وتمتلك مصر فيها نفوذاً سياسياً أو اقتصادياً؛ وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا. هذه المرة، يجري الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في أوقات ساخنة لجميع المناطق المذكورة أعلاه. ولحسن الحظ، تلعب مصر دورًا حاسمًا في التحكم في مسارات ونتائج هذه النزاعات.
لا يكاد الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة الخليج والمشرق العربي، يتعافى من عواقب الانسحاب الأميركي الفوضوي للغاية من أفغانستان، مما زاد من المعاناة القائمة في المنطقة من انعدام الاستقرار السياسي والإرهاب. وفي الوقت نفسه، لا يزال التهديد المتزايد للميليشيات المحلية والمرتزقة في دول شمال أفريقيا الضعيفة، مثل ليبيا، مصدر قلق كبير.وبالمثل، فإن منطقة شرق أفريقيا تغلي بالحروب الأهلية التي وفرت تربة خصبة للمنظمات الإرهابية والميليشيات القبلية. وعلى الرغم من التهديد المستمر للإرهاب، لم يذكر الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري أي شيء عن التعاون في مكافحة الإرهاب. وهذا يشير إلى تحول صادم في السياسة الخارجية لإدارة بايدن، على عكس الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة التي وضعت مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط كموضوع محوري لعلاقتها مع دول المنطقة.
ملاحظة أخرى مثيرة للاهتمام تثبت التغيير الحاد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في عهد بايدن، تتعلق بتهميش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لسبب ما، لم يكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على رأس أولويات أجندة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر. هذا على الرغم من حقيقة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان السبب الرئيسي الذي دفع إدارة كلينتون لبدء الحوار الاستراتيجي مع مصر في عام 1998. ومن المفارقات أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان أيضًا السبب وراء قرار إدارة بايدن باتخاذ نهج أكثر ودية مع قيادة السيسي، على الرغم من الحذر والتردد الأولي. دفع نجاح مصر منفردة في السيطرة على النزاع المسلح بين حماس وإسرائيل في مايو (أيار) الماضي بايدن إلى أخذ القيادة المصرية للرئيس السيسي بجدية أكبر، وإعادة تقديم مصر كشريك إقليمي لا غنى عنه.
ومع ذلك، يبدو أن الاضطرابات في السودان كانت الموضوع الرئيسي على جدول أعمال المحادثات المصرية الأميركية الأسبوع قبل الماضي. حيث يرى بعض المراقبين أن الانقلاب الأخير في السودان هو السبب الرئيسي وراء قرار الولايات المتحدة استئناف المحادثات مع مصر في المقام الأول. لكن لدى مصر والولايات المتحدة وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع في السودان، حيث يشير ذكر السودان المقتضب في البيان الختامي المشترك إلى أن الجانبين لم يتفقا على كيفية التدخل للسيطرة على الاضطرابات.
من ناحية، يبدو أن مصر غير مستعدة لعكس الانقلاب في السودان لأنه يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، خاصة عند النظر في الصراع طويل الأمد على نهر النيل مع إثيوبيا. فمصر، الجار والحليف الأقرب للسودان، لم تتفاعل مع الاضطرابات لا بطريقة سلبية ولا إيجابية. هذا على الرغم من حقيقة أن مصر أدانت سابقًا محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها البرهان في سبتمبر. ولكن على ما يبدو، تفضل مصر التزام الصمت هذه المرة حتى لا تدفع السودان إلى جانب إثيوبيا في الصراع الدائر على نهر النيل.
على الجانب الآخر، كانت الولايات المتحدة تضغط بلا هوادة على الجنرال البرهان لعكس الانقلاب وإعادة تنصيب الحكومة المدنية. وفي اليوم التالي لانقلاب البرهان، أعلن وزير الخارجية الأميركية بلينكن، أن إدارة بايدن ستعلق المساعدات المستحقة للسودان (700 مليون دولار) حتى يتراجع البرهان عن تحركه. وعلى الرغم من ذلك، كان المسؤولون الأميركيون حريصين جدًا على عدم وصف الأحداث الجارية في السودان علانية بأنها انقلاب.
التفاؤل الواقعي
يحمل استئناف عقدين من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر هذا الشهر الكثير من الوعود المبهجة التي ينبغي أن تجعلنا متفائلين. فعلى الأقل، ساعدنا ذلك في الكشف عن التحولات الحاسمة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة بايدن. وسيتطلب هذا بالتأكيد من مصر إعادة هيكلة دورها في المناطق الرئيسية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه، سواء قررت التنسيق مع الولايات المتحدة أم لا.
ومع ذلك، هذا لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل نقاط الخلاف الحاسمة، على جداول الأعمال الثنائية والإقليمية، بين رؤى بايدن والسيسي التي قد تعيق أي نتائج إيجابية لهذا الحوار أو أي محادثات أخرى في المستقبل. وعلى الرغم من أن أجندة الحليفين الاستراتيجيين تتماشى تمامًا مع الموضوعات الإقليمية الكلاسيكية مثل إسرائيل وإيران، فإن الشريكين بحاجة إلى إعادة مواءمة رؤيتهما فيما يتعلق بالتحديات الملحة الحديثة أيضًا.
إن مثل هذه الآراء المتضاربة تجاه التحديات المحلية والإقليمية الحالية تحتاج إلى حل مناسب لضمان نجاح الحوار الاستراتيجي في تحقيق تأثير أوسع جغرافيًا ولأطول فترة زمنية. وهذا بدوره يشمل الآراء المتباينة بشأن وتيرة وعملية النهوض بحقوق الإنسان؛ قضية الإخوان المسلمين الذين يتظاهرون بالخداع في الولايات المتحدة بأنهم معارضون مصريون أو مدافعون عن حقوق الإنسان، والاضطرابات الحالية في السودان، ولا مبالاة الإدارة الأميركية تجاه الصراع على نهر النيل.
خلاصة القول، هي أن نجاح أي تعاون استراتيجي مستقبلي، ثنائي أو إقليمي، بين مصر والولايات المتحدة، يعتمد على تضييق الفجوة بين الرؤى المتضاربة التي يتبناها الرئيسان الأميركي والمصري حول هذه الموضوعات المحددة.