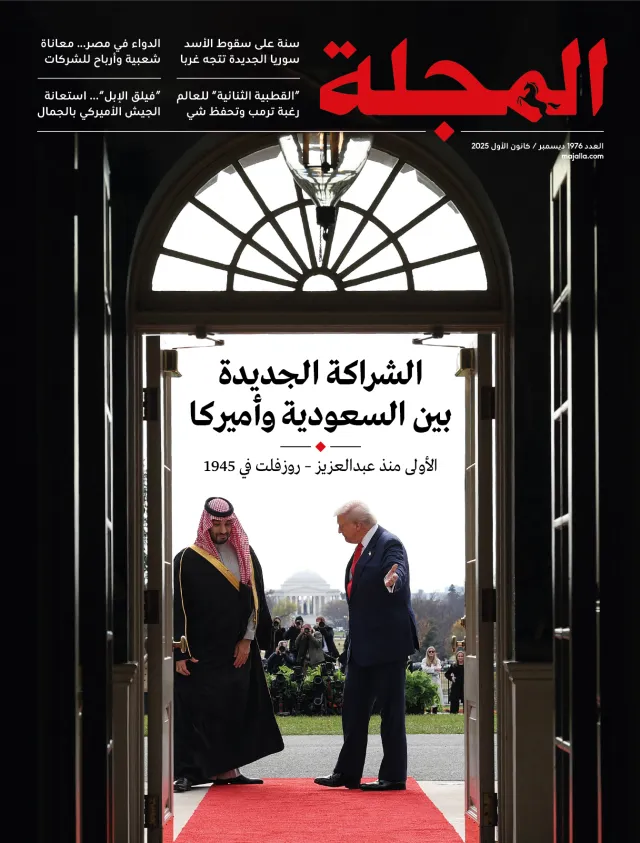بعد عقدين من إقرار دستور ناظم للعلاقة بين الحكومة الاتحادية العراقية ونظيرتها في إقليم كردستان، يبدو الخلل المستدام والمستعصي بينهما على أي حل، لا يلبث أن يظهر بين حين وآخر ولأسباب متعددة، وكأنه يتجاوز التنازع السياسي والتباين الإداري والتناقض الأيديولوجي الاعتيادي، ليكون تعبيرا عن "معركة مستترة"، تستمد أصولها وترتيباتها وأدواتها من أصول وتاريخ المسألة الكردية في هذا البلد، حيث كانت الجماعة الكردية العراقية تبحث لنفسها عن اعتراف وحضور منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. ولا يمنع من إقرار هويتها كـ"معركة"، إلا بعض فروض "اللياقة الوطنية".
إذا لم تكن كذلك، فما معنى كل أنواع الاحتكار والقسر التي تمارسها السلطة المركزية بشكل يومي متواتر بحق الملايين من أبناء شعبها؟ مخالفة كل التفاصيل شديدة الوضوح من الدستور الناظم لعلاقتهم وروابطهم وحقوقهم والتزاماتهم مع الدولة العراقية.
فطوال السنوات الأربع الماضية، ورغم البحبوحة المالية والاستقرار الأمني والهدوء الشعبي، لم يُحلّ تفصيل مثل "رواتب موظفي إقليم كردستان". يحدث ذلك رغم قرار المحكمة الاتحادية العراقية الواضح، القاضي بفصل هذا الملف عن أي إشكال سياسي. فالملايين من موظفي إقليم كردستان، الذين هُم أدبياً وقانونياً موظفو خدمة عامة لدى الدولة العراقية وليس لدى الحكومة الإقليمية أو السلطة الاتحادية، صار الحصول على الراتب الوظيفي الشاغل الأهم في حياتهم. إذ لا تتوقف الحكومة والكتل البرلمانية والقوى السياسية، عن اختراع حجج وظيفية، مرة تلو أخرى، إما بدعوى وجود فساد إداري في الإقليم، وإما طلباً للتدقيق العام أو اشتراط الإشراف المركزي على مؤسسات الإقليم. تلك الأدوات المعيارية التي يشغل العراق آخر الترتيب فيها على مستوى العالم، لو طبقتها الجهات المركزية على نفسها، لامتنعت عن دفع أية رواتب لكل موظفي الدولة العراقية.
فما يحضر هنا هو "الإرادة القبلية" من قِبل الحاكمين المركزيين في "منع الحل"، عزمهم المستبطن في إبقاء إقليم كردستان في منطقة شديدة القلق والتطلب، دفعه إلى مساحة التلهف المستدام لإرضاء المركز وتلبية شروطه وفروضه، وعدم منح الإقليم أي وقتٍ أو فرصة للمطالبة بما هو أكثر من التفاصيل الحياتية اليومية، وإلحاقه قدر المستطاع بالإرادة المركزية.
مختلف الساسة والأحزاب العراقية، وإن بدرجات متفاوتة، يعتقدون في صميم وعيهم السياسي أن ما جرى وثُبّت في دستور عام 2005 كان مجرد "خلل تاريخي"
كل تفصيل آخر في العلاقة غير المتوازنة بين الطرفين تشبه ذلك. فبعد سنوات من الجدل بشأن نفط إقليم كردستان، واتهام المركز للإقليم بعدم الإصغاء له في عملية التصدير، سلمت حكومة الإقليم كل مستخرجاتها النفطية لـ"شركة سومو" الوطنية، ومع ذلك يمتنع المركز عن تصدير نفط الإقليم حتى الآن.
يُمكن للمرء أن يأخذ أي قضية عامة أخرى في العراق المعاصر، ليجد فيها خطابات وأشكال وعي وسياسات واستراتيجيات عمل شديدة المركزية تجاه إقليم كردستان، وبدرجة أقل تجاه المحافظات غير المنتظمة في إقليم. سلوكيات وسياسات لا تبالي بتناقضها الجوهري مع البنية القانونية والسياسية الناظمة للدولة العراقية الحديثة، أي الدستور. بداية من السياسة الخارجية للبلاد وقوانين الميزانيات المالية السنوية، مروراً بالتعليم والصحة والإدارة العامة، وليس انتهاء بتفصيلٍ مثل اهتمام وتركيز الساسة والمسؤولين العراقيين بالقضايا العربية، ولو في الدول الأخرى، وهذا حق طبيعي لا اعتراض عليه، بحكم الهوية الثقافية والعرقية لجزء واسع من الشعب العراقي، لكن إهمالهم النظير والتام لأي شيء يتعلق بالقضايا الكردية في المحيط العراقي هو ما يثير التساؤل، رغم تضمين الدستور العراقي تعريفاً أساسيا يقول إن العراق مؤلف بالأساس من الشعبين العربي والكردي.
يُمكن إيراد تفسيرات وأسباب كثيرة تقف وراء ذلك، لكن عاملين تأسيسيين يشكلان معا السبب البنيوي والنواة التفسيرية لاستدامة هذه "المعركة".
طبيعة النخبة السياسية، الحاكمة منها والمعارضة، هي العامل الأول.
فمختلف الساسة والأحزاب العراقية، وإن بدرجات متفاوتة، يعتقدون في صميم وعيهم السياسي أن ما جرى وثُبّت في دستور عام 2005 كان مجرد "خلل تاريخي"، ما كان له أن يحدث لولا الدور الأميركي وتنامي النفوذ الكردي وقتئذ. ويسعون جاهدين لتفكيك وتبديد ما يصنفونه "عطباً" في الذات الوطنية. فالكرد حسب معتقدهم السياسي لا يحق لهم التمتع بجزء من السيادة عبر المنظومة الفيدرالية، ومجموع السلطات الممنوحة لهم في هذا النظام يتجاوز موقعهم و"قيمتهم" كجماعة أهلية كانت "هامشية" في الكل الوطني، حسب نزعاتهم، غير البعيدة كثيرا عن الجذر "البعثي" ووعيه القومي للدولة/الأمة الواحدة والمُسيطر عليها من المركز.
لا تبخل اليوميات السياسية العراقية عن كشف ذلك، منذ عقدين وحتى الآن. فعند كل أزمة، تعلو الأصوات المطالبة بتفكيك الفيدرالية الكردية وإرجاعها إلى مجرد محافظات. وما إن يدخل سياسي عراقي في أزمة حادة، حتى تراه ينبري للتحذير من تقسيم العراق.
السبب الآخر هو بنية الدولة العراقية، التي لا تُسيّر حياتها العامة حسب الدستور وأفراد الجهاز الحكومي فحسب، بل عبر شبكة ضخمة من القوانين العامة شديدة المركزية. فتلك القوانين التي رفضت النُخب العراقية تغييرها طوال عقدين كاملين، كانت قد أُقرت في الزمن "البعثي" بروح تبتغي أولا "إحلال المسألة الكردية"، لذا صُممت بمركزية فائضة، ولأجل ذلك ما تزال عائقا مستداما أمام أية ممارسات فعلية للفيدرالية.
لا يُمكن لأية دولة أن تكون فيدرالية السلوك والأداء والهوية وهي مُقيدة بهذا الكم من القوانين والفروض المركزي
فالقوانين الناظمة لوزارتي الدفاع والداخلية، ومثلها قانون النفط والغاز، وإلى جانبها كل التشريعات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني وقانون الجنسية العراقية و"إقامة الأجانب" والإدارات المالية والموازنات السنوية، وقانون مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والادعاء العام، ومثلها قوانين الصحة والتعليم وسلم الرواتب والتقاعد، تفيض بالنزعة المركزية التي تفترض عراقا مستمرا منذ الزمن "البعثي"، بوعيه لنفسه ومواطنيه وشكل العلاقة بين مركزه وأطرافه.
لا يُمكن لأية دولة أن تكون فيدرالية السلوك والأداء والهوية وهي مُقيدة بهذا الكم من القوانين والفروض المركزية. لأنه، وعلى العكس من مختلف تجارب الدول الأخرى، لم تأتِ الفيدرالية في العراق كنتيجة لتوافق المتصارعين في البلاد على توزيع السلطة والسيادة داخلها حسب معايير وآليات عادلة، لتكون لهم جميعا بالتساوي، وبالحياد عن صراعاتهم التفصيلية. فـ"الفيدرالية العراقية"، حسب غالبية النُخب الحاكمة، هي مجرد "خطأ لحظة تاريخية خاصة"، ولأجل ذلك يُبقون كل شيء على حاله، إلى أن تحين لحظة تصحيح "الخطأ"، كما يعتقدون.