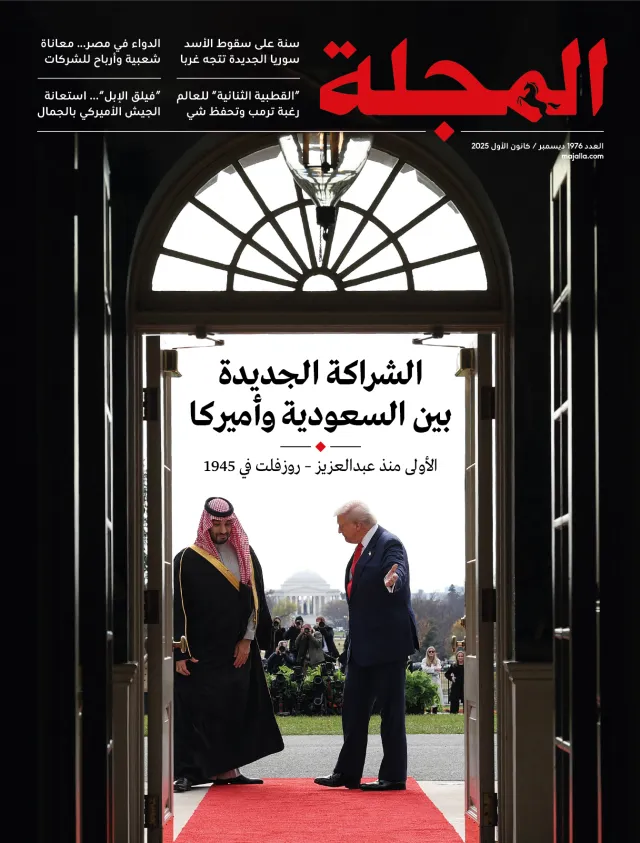بينما ينتظر العالم بأسره ما سيجري في غزة خلال الأسابيع والشهور القادمة، من خلال المشروع السياسي والإداري والسلطوي الذي سيدير القطاع في مرحلة "ما بعد حماس"، يعيش الغزاويون واحدا من أصعب الأسئلة وأكثرها حرجا في تاريخهم الحديث، يتعلق بشكل علاقتهم مع الآلاف من أبناء القطاع من الذين سينخرطون في مؤسسات وآلية حُكم المنظومة الجديدة، التي ستشهد دون شك استقطابا شديدا. فالحاكمون الجدد سيعُتبرون في رؤية الكثير من الغزيين أفرادا وجماعة سياسية أتت على أنقاض ما فعلته إسرائيل بهم، وحسب ترتيبات وافقت وشاركت إسرائيل في تطبيقها.
قبالتهم، سيعتبرهم مئات الآلاف من غزيين آخرين طبقة سياسية وأمنية واقتصادية حاكمة خلصتهم من "عدوانية إسرائيل" و"آفة حماس" في الآن عينه، التي لم تجلب لهم إلا حروبا مستدامة، لم تكن وفق حساباتهم ومصالحهم وأفق مستقبل أجيالهم.
ليس في الأمر ما هو جديد، فلسطينيا على الأقل. فالاستقطاب السياسي/المجتمعي على قاعدة الانقسام إلى وطنيين/خونة أمر تقليدي في تاريخ القضية الفلسطينية. فضبابية القدرة على منح أية طاقة أخلاقية ومكانة تقديرية لأي شخص أو جماعة أو خيار سياسي بوضوح تام في نموذج غزة الراهن، يُقدم نموذجا على هشاشة الاعتبارات القيمية المنطلقة من أسس سياسية، أيا كانت هذه الأخيرة، ولو كانت شيئا من مثل التعاون مع دولة مثل إسرائيل.
لكن القضية تأخذ أهمية أكبر في اللحظة الراهنة. ففي الوقت الذي صار فيه التقسيم الواضح للفاعلين والاستراتيجيات السياسية على أساس قيمي وأخلاقي واعتباري أمرا شبه مستحيل في قضية بالغة "الوضوح" مثل القضية الفلسطينية، فإن جماعات قومية ودينية وطائفية ومناطقية في دول أخرى، صارت تتبنى منظومة متكاملة من "التكفير السياسي" بثقة فائضة بالنفس. فمجموعات أهلية كبرى تُخرج أخرى من "المظلة الوطنية"، وتشكيلات سياسية تاريخية تعتبر نظيراتها الأخرى في البلد نفسه "طابورا خامسا"، وفاعلون ثقافيون ومعرفيون ومناطقيون وأيديولوجيون يمارسون "محقا رمزيا" ضد الآخرين، لأسباب ودوافع وآليات أقل جدارة ووجاهة من الانقسام الفلسطيني التقليدي.
عدد غير قليل من المجتمعات والدول أخرجت الانقسامات السياسية، أيا كانت، من حيز الصراع الأخلاقي والأحكام القيمية، وحولتها إلى مجرد خلاف في الرؤى
يحدث ذلك كنتيجة ودلالة على نوعية مجتمعاتنا ومستوى القوى السياسية الفاعلة في منطقتنا، تحديدا في مرحلة التحول الجذري هذه، عقب خضة "الربيع العربي". ففيما تجاوزت المسألة الفلسطينية، بكل جذريتها، ذلك الاعتبار، لأسباب موضوعية تتعلق بوعي النُخب والقوى السياسية، وحتى الشعبية، ومدى التركيب والتعقيد الذي تستبطنه السياسة كديناميكية كبرى، مُجبرة على احتضان وقبول واستيعاب كل النزعات والمصالح والرؤى، وإن كانت شديدة الاختلاف، وحتى التناقض، لكنها مُجبرة في المحصلة على التعايش المشترك، بفعل الضرورة الحياتية، فإن هذه الفعلة صارت تحضر بكثافة في بيئات ودول ونماذج إقليمية أخرى، شهدت موجة التحول هذه.
الكثير من المجتمعات شهدت موجات من مثل تلك في مراحل التحولات الكبرى. في عصر "ما بعد الاستعمار" في دول أفريقيا وشرق آسيا مثلا. تصارعت أطياف الشعوب الصينية والكورية والفيتنامية حول آلية نعت وتصنيف الملايين من أبناء شعوبهم، من الذين تعاونوا مع الاحتلال الياباني خلال النصف الأول من القرن العشرين مثلا. انقسموا إلى نصفين شبه متساويين، واحدٌ يعتبرهم "خونة" وعملاء لليابانيين الأجانب، وآخرون قبلوهم كأصحاب رؤى واقعية، حاولت بقدر ما تستطيع التقليل من قسوة الاحتلال الياباني. الأمر نفسه حدث في الكثير من دول أفريقيا بشأن المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي. في دولة مثل الجزائر تحول الأمر إلى شبه حرب أهلية. كذلك شهدت مجتمعات دول المنظومة السوفياتية أشياء كثيرة من ذلك، بالذات في مرحلة التحول من النظام الاشتراكي/الديكتاتوري إلى الأنظمة "الديمقراطية" الحديثة. ومثلها حدثت تجارب لا تحصى في مختلف دول العالم، كانت الانقسامات السياسية في كل واحدة منها أكبر وأكثر تركيبا من قدرة المحددات الأخلاقية والتعابير والشعارات الخطابية "الواضحة" على تعريفها وتفكيكها، وطبعا مستحيلة القدرة على إيجاد حلول لها.
استجابة لتلك الصعوبة، فإن عددا غير قليل من المجتمعات والدول أخرجت الانقسامات السياسية، أيا كانت، من حيز الصراع الأخلاقي والأحكام القيمية، وحولتها إلى مجرد خلاف في الرؤى. وكانت هذه الدول والتجارب العالمية ناجحة وذات مردود إيجابي على السلام الاجتماعي والحياة السياسية الصحية، بقدر نزوعها لذلك الفصل. لأن العكس كان يعني استمرار الاستقطاب على أساس صفري، يستجلب مزيدا من أشكال التنابذ الأهلية، بل ويفتعل الكثير من الصراعات الأهلية. ففي دولة مثل ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية، قالت الإحصاءات وقتئذ إن أكثر من نصف الذكور البالغين كانوا منخرطين في التجربة النازية. ومن دون نزعة "الطاقة الأخلاقية" عن الانقسام الداخلي الذي كان وقتئذ، كانت الحرب الأهلية الألمانية ستستمر غالبا حتى الآن.
تتحول الاختلافات التقليدية بين التنظيمات والأيديولوجيات السياسية إلى أنواع من "التكفير السياسي" و"المحق الرمزي" لجماعات أهلية كاملة
خاض العالم كل ذلك، لكن راهننا يقول إن مجتمعات دول مثل السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والعراق وتركيا وإيران تُعيد إحياء تجارب جديدة وحيوية في ذلك السياق، وإن بالاتجاه المعاكس. إذ تتحول الاختلافات التقليدية بين التنظيمات والأيديولوجيات السياسية فيها إلى أنواع من "التكفير السياسي" و"المحق الرمزي" لجماعات أهلية كاملة، إلى سلعة شبه يومية في يومياتها المعاشة. إذ يُستسهل فيها إخراج ملايين البشر من "النعيم الوطني" ووسمهم بـ"عار الخيانة"، ولا تمانع استدعاء المزيد من التباينات الأهلية، بل وتعمقها بمزيد من الجروح. لتؤسس بالضرورة موجة جديدة من الحروب الأهلية المستدامة، التي ليس لها أي أفق.
المفجع أنها لا تفعل ذلك على أساس "العمالة للخارج"، مثلما فعلت طوال قرن كامل مضى، بل حسب ولأجل خلافات داخلية شديدة البساطة والعادية، جوهرها هو الصراع المرير على السلطة، وفقط كذلك.
هل من حلول لكل ذلك؟
غالبا لا. لأن النُخب الثقافية والسياسية التي من المفترض أن تقف حاجزا منيعا أمام ذلك، وتصنع من السياسة أكبر مروحة لاستيعاب كامل طيف الفروقات الوطنية، مانعة ومتصدية لأحكام التخوين السياسي والتحطيم الرمزي في كل عالم السياسة الداخلية، أيا كانت الآراء والمواقف والاستراتيجيات التي قد يتخذها أي طرف سياسي، مثلما تمكنت بعض النُخب الدينية من إلغاء أحكام "التكفير الديني" بكل أشكاله، وأيا كانت الآراء الذاتية للشخص، هي نفسها النُخب التي تؤسس لهذه الممارسات في هذه البلدان، مفضلة مصالحها في التحول إلى "نُخبة" ذات هيمنة على المجتمعات على حق أفراد هذه المجتمعات في نيل مساحة من الطمأنينة والقبول المتبادل والسلام الاجتماعي، خارج مراحل ثنائية الحروب الأهلية الباردة والمؤجلة، عبر تقسيم أبناء الدولة الواحدة إلى "وطنيين/خونة".