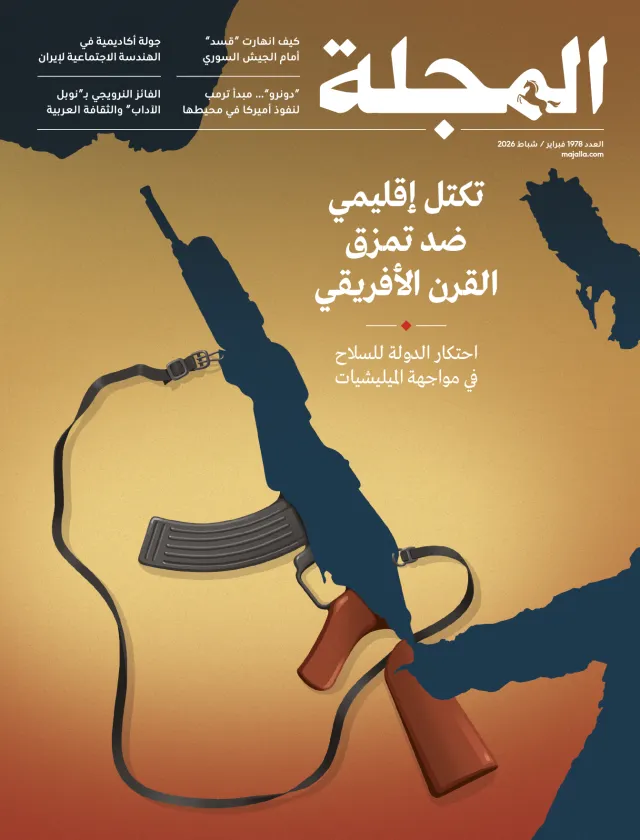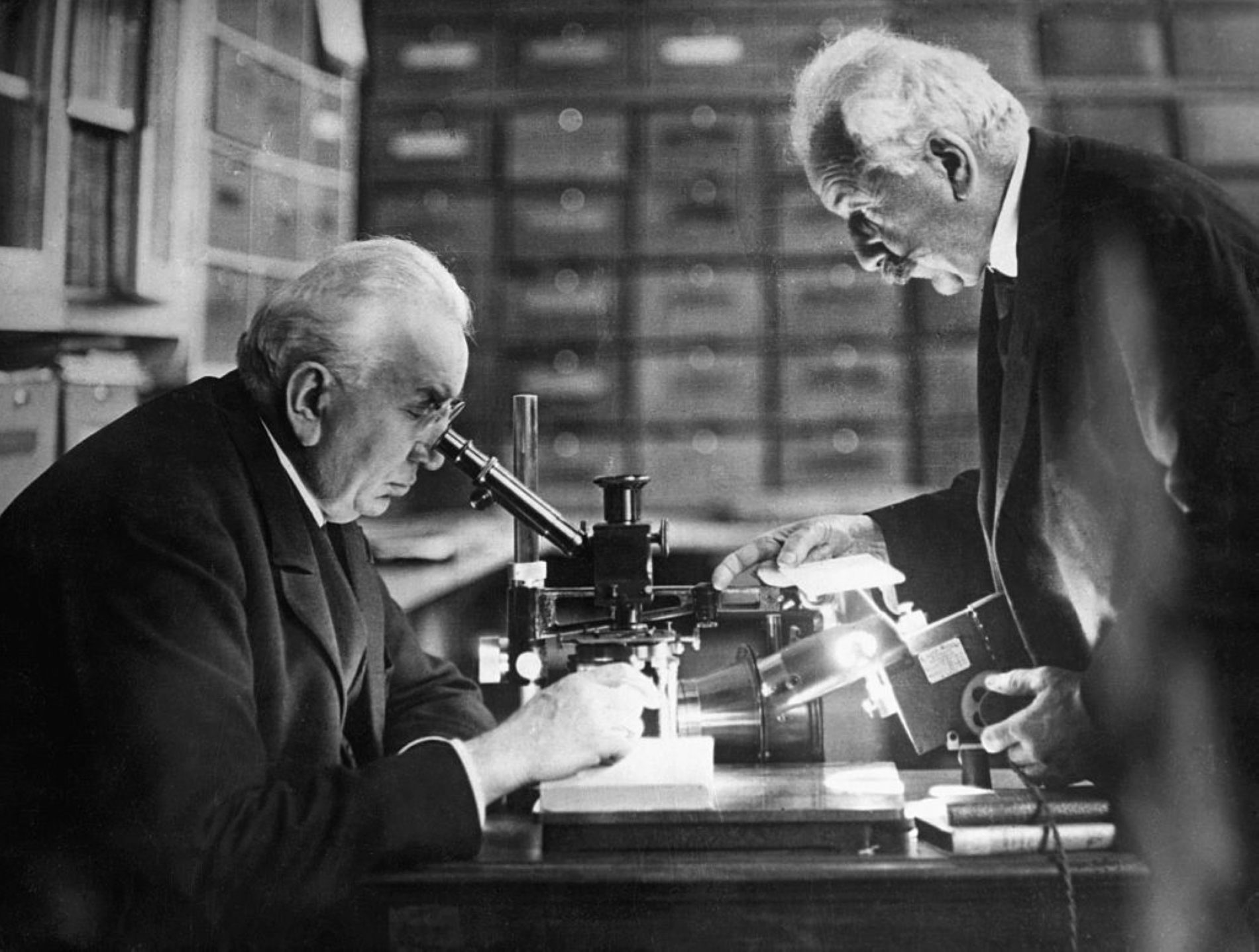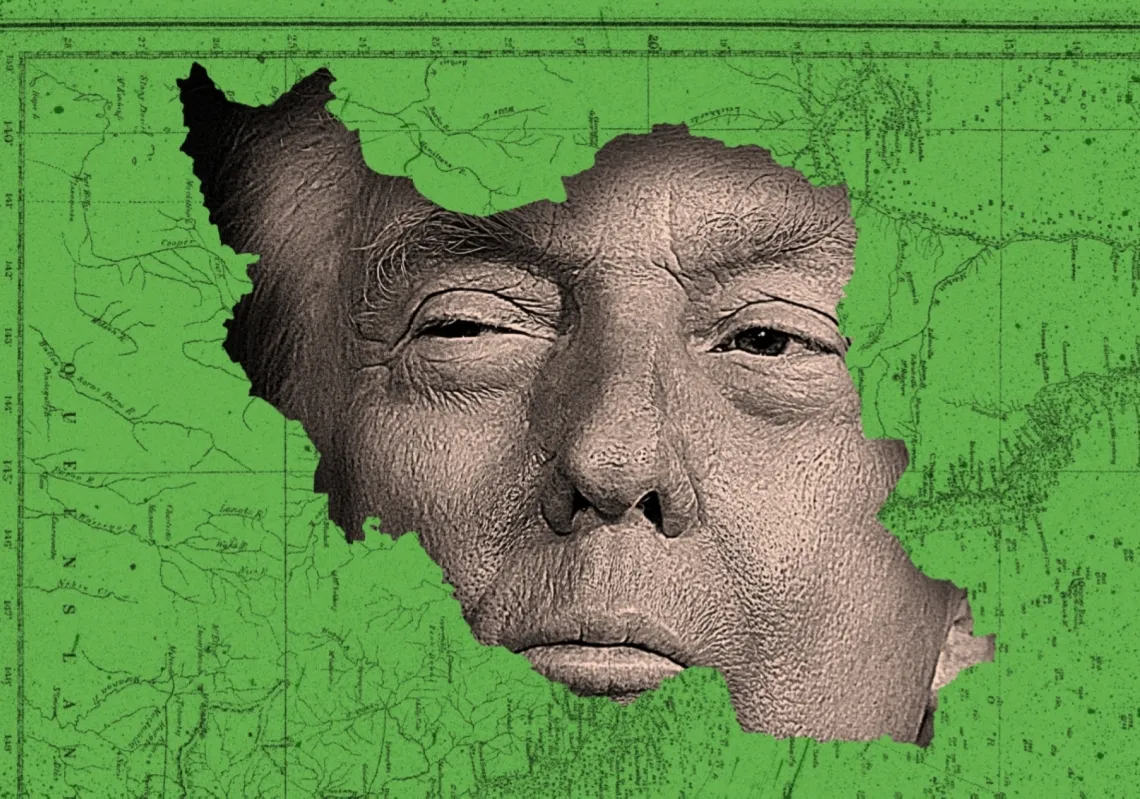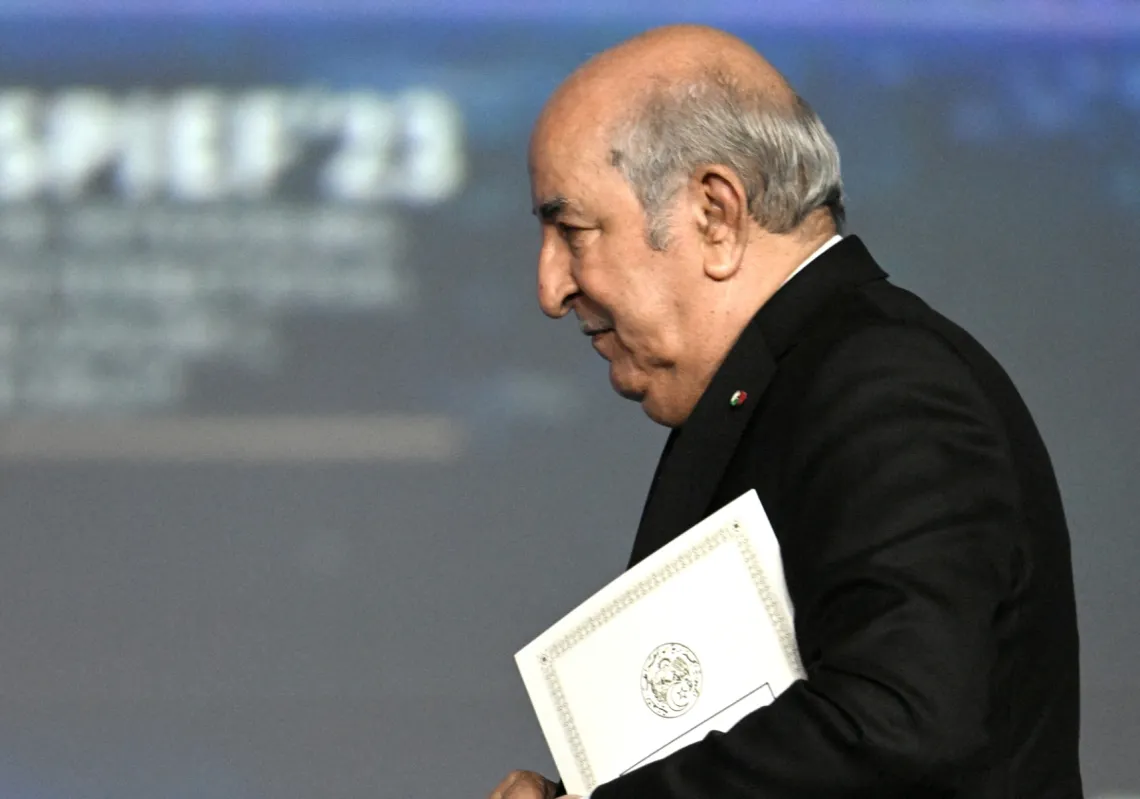حين يغادر المرء قاعة السينما المظلمة وقد أطفئت الشاشة، يبقى ضوء الصور عالقا في عينيه وذهنه، وكأنها لم تزل تتحرك في داخله، تهزه من الأعماق وتجعله يتساءل: هل ما رأيته حقيقة أم وهما؟ هنا بالضبط يبدأ الحدث الفلسفي، ليس باعتباره تعليقا على الفن، وإنما بوصفه تجربة داخلية يصوغها الفن أولا وتعيد الفلسفة تشكيلها بلغة "المفهوم" -إن أخذنا بتعبير جيل دولوز. إن لحظة كهذه تكشف أن العلاقة بين الفن والفلسفة ليست علاقة تبعية أو تبادل وظائف، إذ إنها علاقة ولادة مشتركة، حيث يولد التفكير الجمالي والفكري في لحظة واحدة، في المكان نفسه، في ذلك الفضاء المتوتر الذي يسمى "حركة الصورة" أو بتعبير مغاير فهو يكاد يصير طية طوبولوجية بين مجالين يبدوان متوازيين.
أو كما يشير ألان دونو في كتابه "السينما"، فإن العلاقة بين هذه الممارسة الفنية والفلسفة، ليست مجرد علاقة خارجية أو ثانوية، إنما هي علاقة جوهرية وفريدة. إذ يمكن النظر إلى السينما بعدّها تجربة فلسفية قائمة بذاتها. ومن هنا يبرز سؤالان أساسيان: أولا، كيف تنظر الفلسفة إلى السينما؟ وثانيا، كيف تعمل السينما على تحويل الفلسفة ذاتها؟ فهذه العلاقة ليست علاقة معرفية بالمعنى التقليدي؛ فالفلسفة لا تمنحنا معرفة بالسينما، وإنما تفتح الأخيرة مجالا للتحويل والإبداع. فالسينما قادرة على تحويل الفلسفة من الداخل، أي إعادة صوغ مفهوم الفكرة نفسها. إنها ليست مجرد أداة للتفكير فحسب، بقدر ما هي فعل ابتكار للأفكار حول ماهية الفكرة. بهذا المعنى تصبح السينما موقفا فلسفيا قائما بذاته. وكل موقف فلسفي، في جوهره، هو لقاء بين مفاهيم متباعدة أو غريبة عن بعضها، لقاء يفتح أفقا جديدا للتفكير والفهم.
ثنائية الصورة والفلسفة
في المقابل، حين نستعيد أسطورة الكهف (سينما العهد القديم) عند أفلاطون، ندرك أن العلاقة بين الفلسفة والفن لم تبدأ مع الحداثة، إذ هي متجذرة في أصول التفكير الفلسفي ذاته، قائمة منذ البعيد على ثنائية الصورة (تجلي الفن) والفلسفة. ففي الكهف يقبع البشر وهم ينظرون إلى ظلال تتحرك على جدران مثلما تتساقط صور السينما على القماش الأبيض، فيظنونها حقيقة العالم؛ لنتذكر هنا أولى الصور التي أسقطت من آلة سينماتوغرافية للإخوة لوميير (lumière) [=الضوء] قبل أن يفر الجمهور الصغير من الغرفة خوفا من اختراق القطار المصور الجدار. إن هذه الصورة الأبدية تختزل طبيعة الفن كصناعة للصور والظلال، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن الصورة قد تكون جسرا نحو الحقيقة، أو حجابا يحجبها، او صنيعة وهم يصير حقيقة، مثل صورة القطار ذاك. الفلسفة عند أفلاطون تتهم الفن بالبعد عن المثال وتعتبره محاكاة للمحاكاة، لكن هذا الموقف لم ينج من المفارقة: فالمثل نفسها لم تعرض إلا عبر صورة رمزية، أي عبر فن القول، عبر الخطابة. إن الاستعارة هي فن داخل الفلسفة، وبدونها كان من الصعب أن يتجسد المفهوم في الذهن. وهنا يفتح الكهف الباب أمام مساءلة عميقة: هل يمكن أن تقوم الفلسفة بغير الفن؟ وهل يمكن الفن أن يستغني عن الفلسفة؟