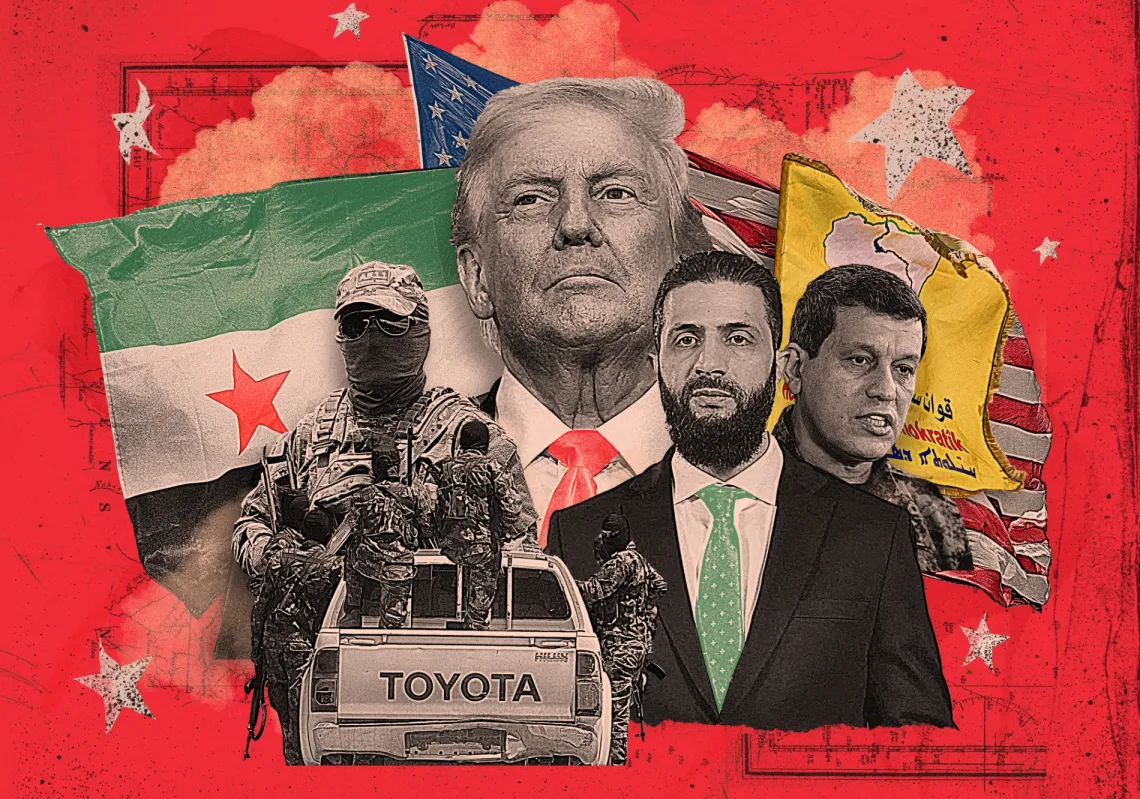ليس مبالغة القول إن قضية دريفوس (1894–1906) فعلت في الحقل الأدبي ما تفعله المحاكمة في جسد نص: أرغمته على إنتاج الأدلة، على إعادة توزيع زمنه بين زمن الواقعة وزمن الحكي وزمن التلقي، وعلى تسجيل الشائعة بوصفها وثيقة ينبغي تفكيكها، وكذلك إعادة صوغ الذات الجماعية (الـ"نحن") في مرآة العدالة والحقيقة. فجأة صار النص ساحة مرافعات وأسئلة أخلاقية يستدعى فيها الضمير واللغة والذاكرة معا، وتختبر قدرة السرد على تحويل الوقائع إلى حجج وتحويل الضوضاء إلى معنى قابل للمساءلة.
يصرخ إميل زولا فتغادر القضية قاعة المحكمة إلى الفضاء العمومي، يتلاعب أناتول فرانس بالرموز ليعيد ترتيب سلم القيم، ويضع شارل بيغي المفاهيم والتصورات كمن يبني جهازا نقديا للوعي، ويستقلب مارسيل بروست الأثر في نسيج الذاكرة ليكشف كيف تصاغ الحقائق من مادة الزمن. وخلف هذه الإيماءات الفرنسية تلوح ساحة أوروبية أوسع: فرانز كافكا يجرب متاهة القانون والملف، كارل كراوس يفكك مونتاج الصحافة، وفالتر بنيامين يرقب انقلاب الأزمنة وتجاور الوثيقة والصورة، وهنري جيمس يصغي إلى دراما الشائعة والأخلاق في عيون السرد... هكذا يستقر منطق صار مشتركا: ملفات محكمة الإغلاق، ومونتاج إعلامي، وزمنيات قابلة للعكس، ويغدو الأدب مختبرا عموميا لإعادة تركيب "الحق" والـ"نحن".
من "الرواية-الملف" إلى "أخلاقيات الحجة"
فرضت "قضية دريفوس" واجب الإثبات على مستوى الكتابة، وهذا الإثبات ليس علميا، إنما إثبات يبنى بالسرد، عبر عرض الوقائع، إظهارها ومقارنتها. البداية مع زولا: رسالته المفتوحة كانت فعلا أدبيا يقوم على التسمية المباشرة، وهو ما تجلى في رسالته المفتوحة المعنونة بـ"إني أتهم". يبرز زولا نظام السرية في المحاكمة حين يقول: "لكن ها هو دريفوس أمام المحكمة العسكرية. يطلب عقد جلسة مغلقة بكل صرامة"، ليبين أن الحجب هو المشكلة التي يواجهها النص. هكذا تربط الفقرة بين دهشة الجمهور والإجراءات الإغلاقية، فتستخدم السرد لفتح ما أغلق أكثر من مجرد زخرفة. وهذا ما يتجلى في استخدام صيغة المضارع في التراكيب الجملية، فالهدف من ذلك هو إشعار القارئ وكأنه "في قلب الحدث".
غير أن الاستنكار وحده لا يحقق الاستمرارية الأدبية، وهذا ما أدركه أناتول فرانس حين حول القضية إلى تخييل تحت قناع شخصية بيرو في روايته "جزيرة البطاريق": في الكتاب السادس، ما يلفت النظر هو عرض آلية الحجة نفسها وليس السخرية فحسب، فحين يقول الوزير غريتوك: "قضية بيرو سرية، يجب أن تبقى سرية"، تؤدي الجملة مبدأ "إثبات مستحيل"، جاعلة من الغياب القطعة الرئيسة في الملف، إنها مشهد مبدأ لا مشهد نفس.