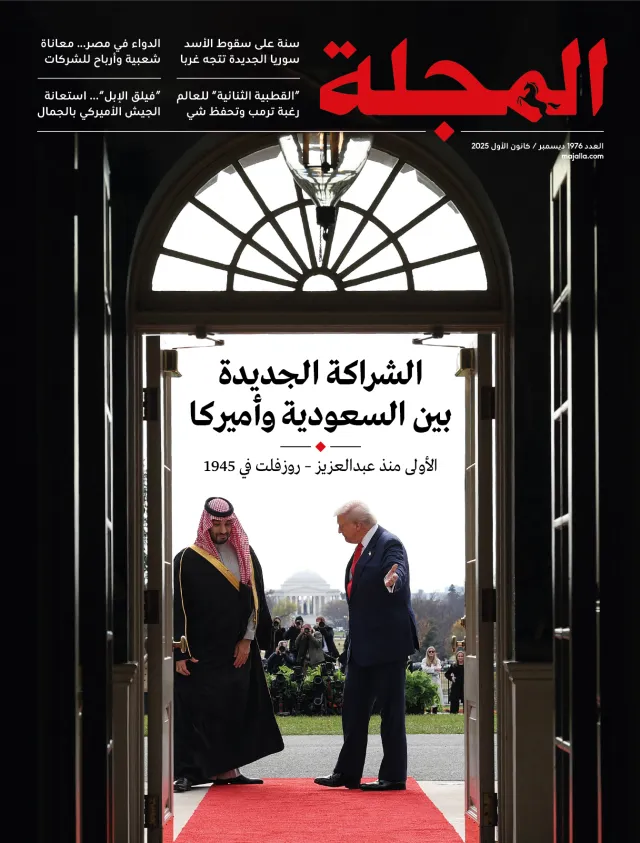الحديث عن الهوية لا يستقيم من دون العودة إلى التراث، فهو المكوّن الأعمق للهوية الإنسانية، منه نستمد اللغة التي نتكلم بها، والرموز التي نفكر من خلالها، والخيال الذي نصوغ به رؤيتنا للعالم. لكن حين نلتفت إلى تراثنا العربي والإسلامي تحديدا، يبرز أمامنا سؤال جدلي مهم: أيّ تراث نقصد؟ أهو تراث الفقهاء أم الشعراء؟ تراث الفلاسفة أم المتصوفة؟ تراث العقل أم النقل؟ هنا نكتشف أن صورة التراث ليست كتلة واحدة صافية، بل فضاء واسع من اتجاهات متعددة، بعضها يتكامل وبعضها يتعارض.
حين ننظر في مرآة تراثنا، لا نرى وجها واحدا صافيا، بل وجوها متداخلة ومتعارضة: عقل يخاصم اللاعقل، أشعري يجادل معتزليا، فقيه يحاور فيلسوفا، صوفي يواجه فقيها، وشاعر يهزأ بالزاهد. هذا التراث لم يُصغ على هيئة خط مستقيم متجانس، بل على شكل فسيفساء متشابكة من المدارس والاتجاهات، من سنة وشيعة وخوارج، ومن معتزلة وأشاعرة، ومن صوفية، وصابئة وديانات أخرى شاركت في تشكيل المشهد الحضاري.
هذه التناقضات لم تلغِ نفسها، ولم تمحُ إحداها الأخرى، بل تراكمت مع الزمن، وتشابكت في وعي الأجيال، حتى صارت جزءا من هويتنا الثقافية.
حين أتأمل هذا التراث، لا أجد حرجا أن أنجذب إلى ابن تيمية وأحمد بن حنبل والشافعي، وفي الوقت نفسه أن أُعجب بالمتنبي وبشار بن برد، وأن أقرأ ابن سينا والرازي والفارابي وابن الهيثم، كما أقرأ ابن حزم، والغزالي، وابن عربي، والسهروردي، وابن رشد، وابن النفيس، والتوحيدي، والأصفهاني. قد يظنّ البعض أن هذه الأسماء لا تجتمع، لكن الحقيقة أنها بمجموعها هي التي صنعت الثقافة العربية الإسلامية، وهي التي شكّلت انتماءنا الأوسع.
وهنا يطلّ السؤال: كيف يمكن أن ننتمي إلى تراث متناقض متضارب؟ وهل الانتماء يعني أن نصطفّ مع اتجاه واحد ونقصي ما عداه، أم إن الانتماء الأعمق هو إلى هذا المشهد الواسع بكل ما فيه من اختلاف وصراع، لأنه وحده هو الذي صاغ وعينا وملامحنا؟
هذه التناقضات لم تلغ نفسها، ولم تمح إحداها الأخرى، بل تراكمت مع الزمن، وتشابكت في وعي الأجيال، حتى صارت جزءا من هويتنا الثقافية
إن الانتماء إلى التراث ليس خيارا نمارسه بوعي فردي، بل هو قدرٌ حضاري لا فكاك منه. فنحن نولد في لغة وأعراف وصور ذهنية صاغتها قرون طويلة من التراكمات. وطبيعة الأفكار لا تتشكل في فراغ ولا تظهر فجأة، بل تنمو عبر تفاعلات وتعقيدات تاريخية، تتداخل فيها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع المنظومات الفكرية والدينية. هكذا نشأت المذاهب والتيارات والمدارس، لا بوصفها رؤى ذهنية صافية، بل باعتبارها حصيلة تفاعل طويل المدى، وصراع وتداخل، بين قوى المجتمع ومصالحه واتجاهاته.
ومن هنا فإننا، شئنا أم أبينا، لسنا أبناء صورة ثقافية نقية بسيطة، وإنما أبناء بيئة معقدة ومتناقضة في آن واحد. كل ما نحمله من مفاهيم وأفكار وموروثات إنما هو نتاج تلك الشبكة الكثيفة من التراكمات. وما نظنه اليوم صفاء فكريا أو نقاء عقديا ما هو إلا وهم يطمس حقيقة أننا أبناء هذه الفسيفساء، وأن هويتنا الثقافية قد صيغت في رحم هذا التعقيد التاريخي.
إن الهوية الثقافية ليست وحدة صافية متجانسة كما نحب أن نتخيل، بل هي نسيج من التوترات المتداخلة. فقد صيغت في بيئة جدلية لا تكف عن طرح الأضداد: عقل ونقل، فقه وفلسفة، زهد وشعر، سلطة ومعارضة. هذه الثنائيات لم تكن عارضا يمكن تجاوزه، بل كانت جزءا من حركة الفكر والحياة، وهي التي أعطت الثقافة العربية الإسلامية قدرتها على الجدل والحوار، وعلى التوليف والمرونة في آن واحد.
فالتراث الذي نُسائل أنفسنا اليوم عن علاقتنا به لم يتكون من خط واحد نقيّ، وإنما من هذه الشبكة الكثيفة من التناقضات. ولعل سر استمراره وخصوبته أنه لم يسعَ إلى محو أضداده، بل احتواها جميعا في ذاكرة حضارية واحدة. ومن هنا فإن انتماءنا إلى هذا التراث لا يعني الوقوف في صف تيار ضد آخر، بل الاعتراف بأن هذه الأضداد نفسها هي التي صنعت وعينا، وأن هويتنا ليست إلا ثمرة لهذا التناقض الخلّاق.
المعضلة الكبرى في بعض الأطروحات الحديثة التي تتعامل مع التراث تكمن في الرؤى الانتقائية التي تريد أن تحصره في اتجاه واحد
غير أن المعضلة الكبرى في بعض الأطروحات الحديثة التي تتعامل مع التراث تكمن في الرؤى الانتقائية التي تريد أن تحصره في اتجاه واحد. نرى تيارات حداثية تجعل من المعتزلة وابن رشد وحدهما صورة "العقلانية" في التراث، ثم تنفي ما عداهما باعتباره ظلاما أو تخلفا. وعلى الضفة الأخرى، نجد تيارات دينية متشددة تُضيِّق دائرة التراث كله في صورة واحدة من الفقه أو العقيدة، وتتعامل مع بقية الأصوات بوصفها انحرافا أو بدعة.
لكن التراث أوسع من هذه المحاولات الضيقة، وهو لا يُختزل في مدرسة دون أخرى. إن ابن تيمية وأحمد بن حنبل لا يقلّان حضورا عن ابن سينا والرازي، كما أن المتنبي وبشار وابن عربي والأصفهاني ليسوا أقل أثرا من كتب الفقه والحديث.
التراث كله هو تراثي: بعقلانيته ولا عقلانيته، بجماله وقسوته، بفقهه وفلسفته، بعبادته وشعره، بزهده وعبثه، بصرامته ومرونته، بظلامه وأنواره، بجدّه ولهوه، بحكمته وخرافاته، ببطولاته وهزائمه، بآماله وخيباته، لأنه بمجموعه هو الذي صاغ التجربة الحضارية التي أنتمي إليها.
ولهذا فإن التعامل الإيجابي مع التراث يبدأ بالاعتراف بهذه الشمولية، لا بتمزيقه وانتقاء ما يناسب أهواءنا، ولا بتقديس بعضه ونبذ بعضه الآخر.
حدثني صديق ذات مرة وقال: لماذا تهتم بالتراث العربي والإسلامي، وهو لم يخلّف لنا إلا العنف والتطرف؟ فقلت له: إذن تريدني أن أتخلى عن التراث كله؟ فهل أتخلى عن قيس وليلى وشعر المتنبي وأغاني زرياب وألف ليلة وليلة؟ وهل أُلغي إبداعات ابن الهيثم والخوارزمي والإدريسي؟ قال: لا، لا أقصد هذا، وإنما أعني شيئا آخر. قلت له: لكن هذا هو التراث أيضا. إنه إبداع متصل من الفقهاء والمحدّثين والأدباء والفلاسفة والعلماء. وإذا كان لديك موقف من أحكام فقهية معينة في سياقات مخصوصة، فهذه جزئيات صغيرة لا يجوز أن تحدد موقفا كاملا من تراث ممتد عبر قرون، أنتج حضارة عالمية.
إن جزءا من إشكاليات البعض اليوم أنهم يحاكمون التراث من خلال جزئيات وأحكام متفرقة، إما مما ورد في الماضي، أو مما استعادته جماعات معاصرة وأساءت توظيفه. وهكذا تختزل الذاكرة الحضارية في شذرات منتزعة من سياقها، بينما التراث أوسع وأغنى بكثير.
قد لا نستطيع أن نختار تراثا على مقاسنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نقرأه: هل نراه عبئا متناقضا يشتتنا، أم نراه فسيفساء ثرية تمنحنا هوية أوسع؟
الانتماء إلى التراث لا يعني أن نكرّر أخطاءه أو أن نلوّنه بلون واحد، بل أن نعترف بأنه هو الذي صاغ وعينا، وأنه لم يكن يوما مجموع جزر متباعدة، بل إطار حضاري موحّد تداخلت فيه كل العلوم والمعارف. الخوارزمي في الرياضيات، والبيروني في الفلك، والفقهاء في المعاملات، والمحدّثون في النقد والرواية، كلّهم كانوا في مركب واحد، تسيره حاجة حضارية واحدة، وتجمعه هوية واحدة.
قد لا نستطيع أن نختار تراثا على مقاسنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نقرأه: هل نراه عبئا متناقضا يشتتنا، أم نراه فسيفساء ثرية تمنحنا هوية أوسع؟ إن إدراكنا لهذه الوحدة الكامنة في صميم التناقض هو الذي يمنحنا اليوم القدرة على التعامل مع التراث بإيجابية، وهذه الرؤية في النظر إلى تراثنا تساعدنا على الخروج من مأزق الغرق فيه والصراع حوله، وتحرّرنا من أسر الماضي حتى لا يتحول إلى أزمة متجددة، بل إلى رافد للحل، وطريق للإلهام لبناء مستقبل لا ينغلق على ماضيه ولا يقطع الصلة به، بل يستوعبه بوصفه ذاكرة حيّة وهوية ممتدة.