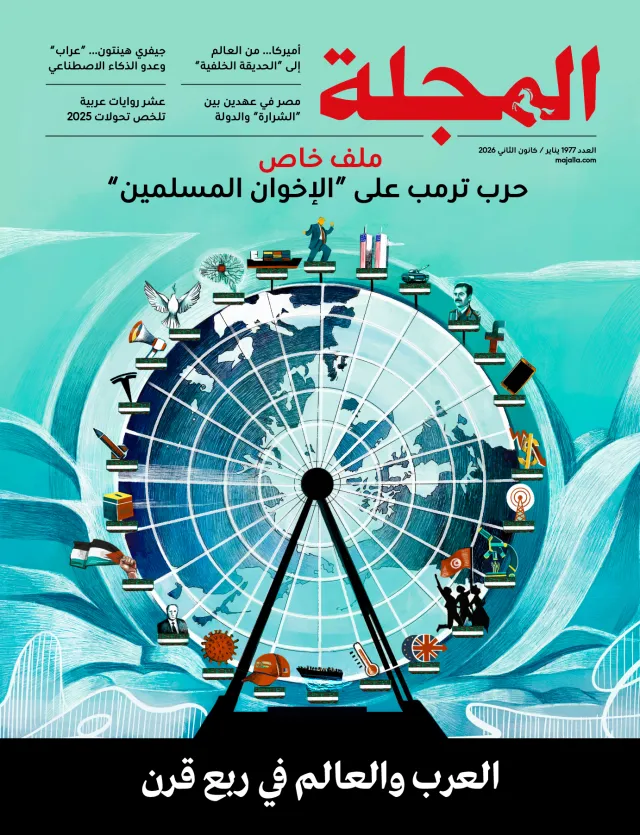لم يكن عند قدماء العرب قوانين مكتوبة، ولا مؤسسات تجمعهم تحت سقف واحد، بقدر ما كانوا يجتمعون حول صوت يجلجل في الفضاء، شعرا وخطابة. فكانت الكلمة عندهم عقدا وميثاقا وسيفا، ومن هنا برزت الخطب بوصفها أصوات العرب التي شكلت وجدانهم منذ ما قبل الإسلام وإلى وقت قريب، خاصة حين كان يجتمع أهل اللغة سنويا في سوق عكاظ بالطائف، من اليوم الأول من ذي القعدة إلى العشرين منه، وفي سوق ذي المجاز في شرق مكة، أيام ذي الحجة، يبيعون البضائع، ومن ثم يرتفع صوت الفصحاء وفي مقدمهم الشعراء، ليصبح السوق مجمعا أدبيا ولغويا، بجانب الرزق.
وقد ارتفع يوما صوت قس بن ساعدة الإيادي (القرن السادس الميلادي)، في عكاظ وكان على ظهر جمل أحمر، وخطب خطبته الشهيرة، فهز الحشد بأقواله العميقة، وبإيقاع سجعي، وإيجاز حكمي، ومنذ ذلك الحين أصبح العرب يقلدون خطبته التي تعد من أقدم الخطب المحفوظة، التي تدعو إلى الوحدة بين قبائل جزيرة العرب، والتفكر في الموت والبعث، حيث يستهلها: "أيها الناس، اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت..."، إلى نهاية الخطبة.
ومن يطلع على خطبة قس بن ساعدة كاملة، يجد أنه لم يكن يخاطب قبيلة بعينها، فالإنسان هو الحاضر في وجوده وكيانه، وفي ضعفه ومصيره، وهو يواجه الموت والبعث. أي لم تكن كلماته وعظا عابرا، بل جرس إنذار روحي ووجودي، وهذا يثبت أن العرب امتلكوا حس الخطابة الروحية والوجودية والوحدوية منذ زمن بعيد، بالإضافة إلى النزعة العربية الأولى نحو الإيجاز اللغوي، من أجل الحفظ والإنشاد، كالعبارات القصيرة السريعة والسهلة، في جمل مستقلة تنتهي بمعنى كامل، انتهاء بالبعد الخطابي الخاطف والمباشر، أمام جمهور مختلف في سوق وحركة.
منذ ذلك الوقت والأثر البلاغي يمتد، ولم تتغير الخطبة في أبعادها الوحدوية وإن أصبحت بعد الإسلام دعوية وإرشادية وتبليغية، كما في زمن الخلفاء الراشدين، بعد الصلاة وفي الجمع والأعياد، وإن تحول مكان الخطبة من منبر السوق بين القبائل، إلى منبر المسجد والدين. وأصبحت الخطبة أداة سياسية، كما في زمن الدولة الأموية، مثل خطبة البتراء الشهيرة، لزياد ابن أبيه في البصرة، والمشهورة لأنه بتر مقدمتها، ليباشر بها فورا، إلى خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي الذائعة الصيت، التي اتسمت بالشدة: "إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها". وقد استخدم العباسيون الخطبة السياسية كأداة، ليبرز الخطباء صوتا للدولة، وتبقى الخطابة في المجالس، مع مزيج من العلم والسياسة، أو الأدب والسياسة..
من يقرأ التاريخ العربي والإسلامي، يجد كيف برزت خطب جمعت البلاغة العميقة بروح الدين، وكيف اختلط التأثير الديني بالسياسي
وهكذا، فإن من يقرأ التاريخ العربي والإسلامي، يجد كيف برزت خطب جمعت البلاغة العميقة بروح الدين، وكيف اختلط التأثير الديني بالسياسي، وكيف أصبح ذلك من أسس فن الخطابة، كما في الخطب الأندلسية المرتجلة، مثل خطبة طارق بن زياد: "البحر من ورائكم، والعدو من أمامكم". ويمتد تأثير الخطابة عبر القرون حتى العصر الحديث، وبالتحديد في القرن التاسع عشر الميلادي، لتشتهر خطب جمال الدين الأفغاني، بمبادئها النهضوية الحديثة ودعوتها للوحدة ومناهضة الاستعمار، وكانت تمتاز بالبلاغة والفكر الإصلاحي، ومن بعده خطب الشيخ محمد عبده، التي كان يعالج فيها قضايا التعليم والعقل والدين، متميزة بالبيان والتنوير وفكرة الوحدة.
وتظهر فكرة الوحدة في خطب القرن العشرين من جديد، مع سعد زغلول الذي ألهبت خطبه ثورة 1919، ضد الاحتلال البريطاني في مصر، وخطب شكيب أرسلان في لبنان، التي ركز فيها على الوحدة، متسائلا: لماذا تأخر العرب والمسلمون؟ فكان له أثر في الوعي النهضوي العربي، ومثله خطب عبد الكريم الخطابي المعادية للاستعمار في الريف المغربي، والحبيب بورقيبة في تونس ممهدا الاستقلال، والملك فيصل بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وخطابه عن فلسطين.
دعوة هؤلاء للوحدة، جعلت أصوات العرب تعلو، منذ قس بن ساعدة ودعوته إلى الوحدة، وكذلك خطب سحبان وائل، الذي اشتهر بالارتجال وسعة الحجة، وخطبة هانئ الشيباني يوم ذي قار، إلى خطب العصر الحديث، في منابر الساحات.
لم تكن الخطب يوما مجرد كلمات محصورة في إطار ديني أو سياسي، بل كانت روحا تعكس حاجة العرب إلى القول الحاسم
الخطابة مثل الشعر، "أعسر من قلع ضرس" كما قال الفرزدق، وبالتالي فإن إعادة إحياء الخطب الوحدوية، بنصوص بليغة وعبر وسائل الإعلام، وعبر خطباء وبلغاء ومؤثرين، ضرورة في زمننا، فللكلمة صليل يوازي صواريخ هذه الأيام، إذ لم تكن الخطب يوما مجرد كلمات محصورة في إطار ديني أو سياسي، بل كانت روحا تعكس حاجة العرب إلى القول الحاسم، وصوت له جوهره يوجه الجموع إلى الاتحاد والسلام.