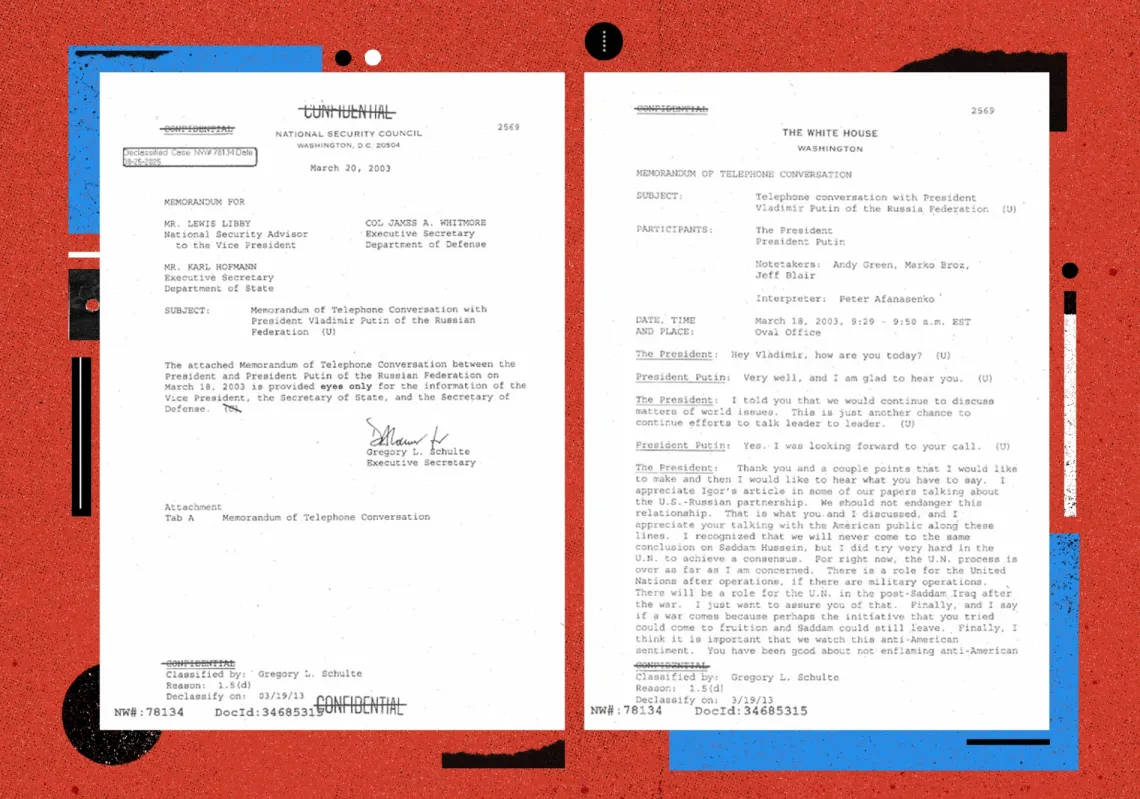حين نتأمل خريطة الأرض من الأعلى، لا يطالعنا اللون الأزرق وحده باعتباره رمزا للمحيطات والبحار، بل يفرض الأخضر نفسه بامتداد الغابات التي تغطي نحو ثلث سطح اليابسة. هذه الغابات ليست مجرد أشجار متراصة أو مساحات من الأخشاب، إنها "رئة الكوكب". فذلك الكائن الحي الهائل الذي يمدنا بالأوكسيجين، ويحافظ على توازن المناخ، ويختزن في ثناياه تنوعا بيولوجيا لا يزال العلماء عاجزين عن الإحاطة بكل أبعاده. فالغابة هي بنك الجينات الأعظم، والمختبر الطبيعي الأضخم، والمأوى الأخير لملايين الكائنات التي لولاها لانقرضت من زمن بعيد.
ومع ذلك، فإن هذا التراث الطبيعي يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة. فحرائق الغابات المدمرة التي تتكرر كل صيف، وإزالة الأشجار على نطاق واسع لصالح الزراعة أو العمران، وانتشار الآفات والأمراض بفعل تغير المناخ، تتضافر لتضع الغابات أمام اختبار وجودي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يخسر سنويا ما يقارب عشرة ملايين هكتار من الغابات، أي ما يعادل مساحة دولة صغيرة متوسطة الحجم، وهو نزيف أخضر إذا استمر في هذا المعدل فسيغير وجه الكوكب خلال عقود قليلة.
في مواجهة هذا الخطر، لجأ العلماء والبيئيون إلى أدوات متنوعة: من التشريعات الدولية واتفاقيات المناخ، إلى حملات التشجير وإدارة المحميات الطبيعية. لكن التحدي الأكبر ظل ماثلا: كيف نفهم بدقة ديناميات الغابة المعقدة، ونتنبأ بما سيحدث لمجتمعاتها النباتية والحيوانية في المستقبل؟ وكيف يمكننا معرفة الأنواع الأكثر عرضة للانقراض أو التراجع قبل فوات الأوان؟
الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، فالأنظمة البيئية لا تخضع لقوانين خطية يمكن قياسها بمسطرة أو معادلة بسيطة. فكل شجرة في الغابة هي جزء من شبكة هائلة من التفاعلات، تتنافس على الضوء والماء والعناصر الغذائية، وتتأثر بجيرانها الأحياء والميتة، وتخضع لتقلبات الطقس والمناخ، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط بشرية متزايدة. وأي محاولة لفهم هذه الشبكة تتطلب عقودا من الرصد الميداني الدقيق، وهو جهد يتجاوز إمكانات كثير من فرق البحث حول العالم.
هنا يطل دور العلم الحديث بما يمتلك من أدوات رياضية وتقنية جديدة. ففي السنوات الأخيرة، تزايد الاهتمام بما يعرف بنماذج التنبؤ البيئي، وهي نماذج رياضية أو حاسوبية تحاول محاكاة سلوك الغابة عبر جمع معطيات ضخمة وتحليلها. لكن معظم هذه النماذج كانت محدودة القدرة، تعتمد أساسا على بيانات مناخية أو تعداد للأشجار دون أن تأخذ في الاعتبار البعد الجيني الخفي الذي يشكل "الذاكرة التطورية" لكل نوع.
جاءت الدراسة الحديثة التي أنجزها فريق بحثي من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين بالتعاون مع جامعة ولاية أوريغون وجامعة ولاية يوتا، ونُشرت نتائجها في مجلة "ساينس". هذه الدراسة، التي يمكن اعتبارها خطوة ثورية في علم الإيكولوجيا، قدمت نموذجا جديدا قادرا على التنبؤ بدقة بمستقبل الغابات، ليس عبر عقود طويلة من الرصد فحسب، بل بالاستناد إلى مزيج مبتكر يجمع بين التعداد الميداني للأشجار والبيانات الجينومية المستخلصة من عينات وراثية.
الفكرة الجوهرية بسيطة بقدر ما هي عميقة، فإذا كان لكل نوع نباتي تاريخ مكتوب في جيناته، فإن قراءة هذا التاريخ يمكن أن تكشف عن أسرار بقائه أو تراجعه في بيئة معينة. وكما أن "الصندوق الأسود" يحتفظ بتفاصيل رحلة الطائرة، فإن الجينوم يحتفظ بقصة النوع في الغابة، فكيف يتكاثر، وكيف يتكيف، وما احتمالات استمراره في المستقبل.