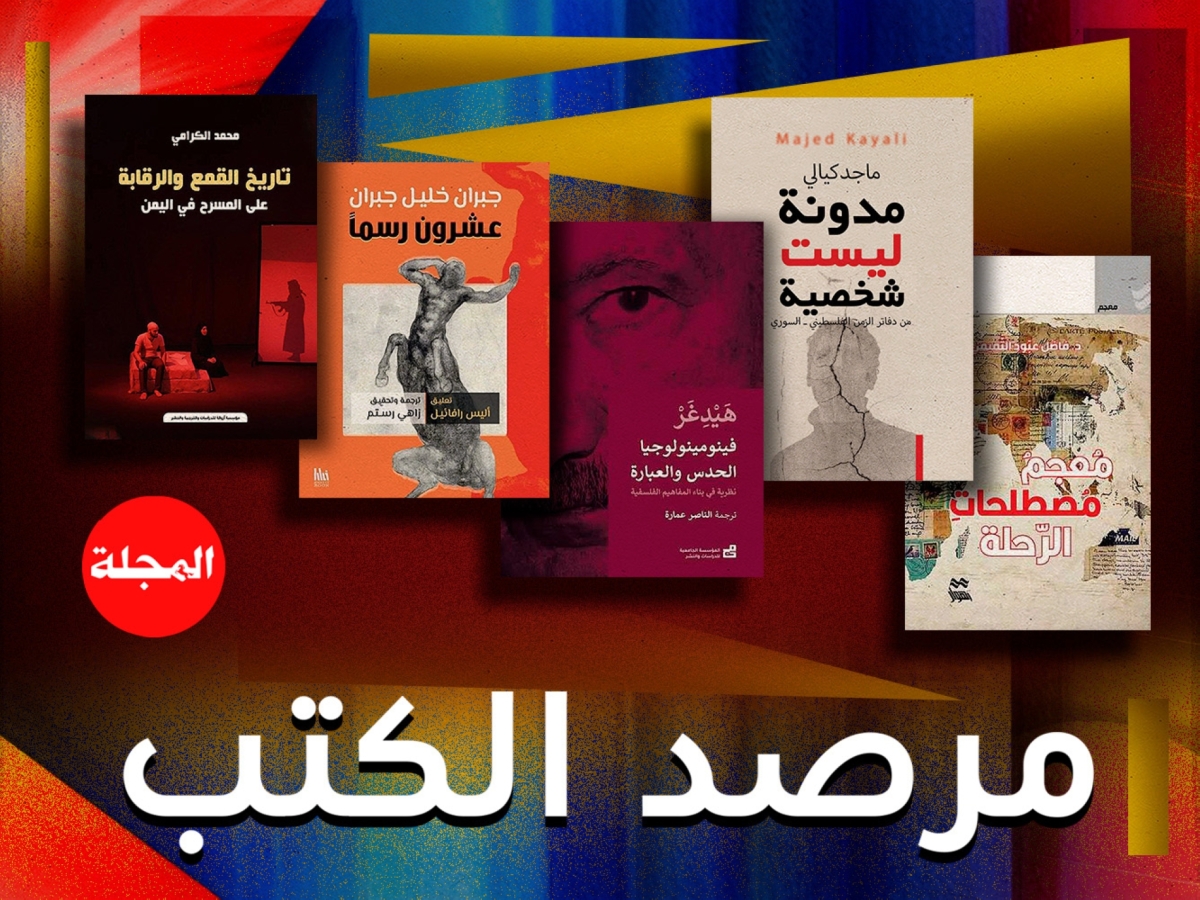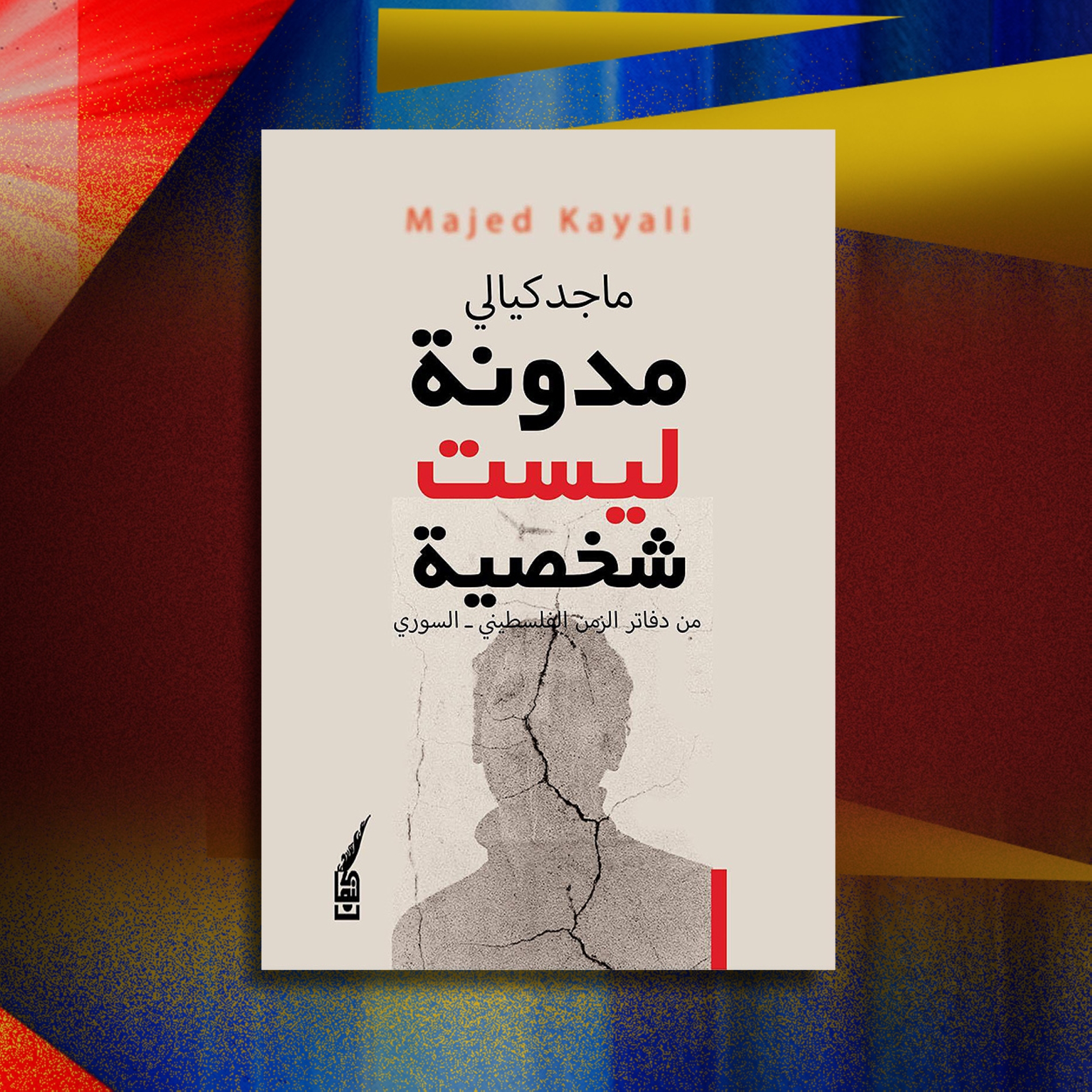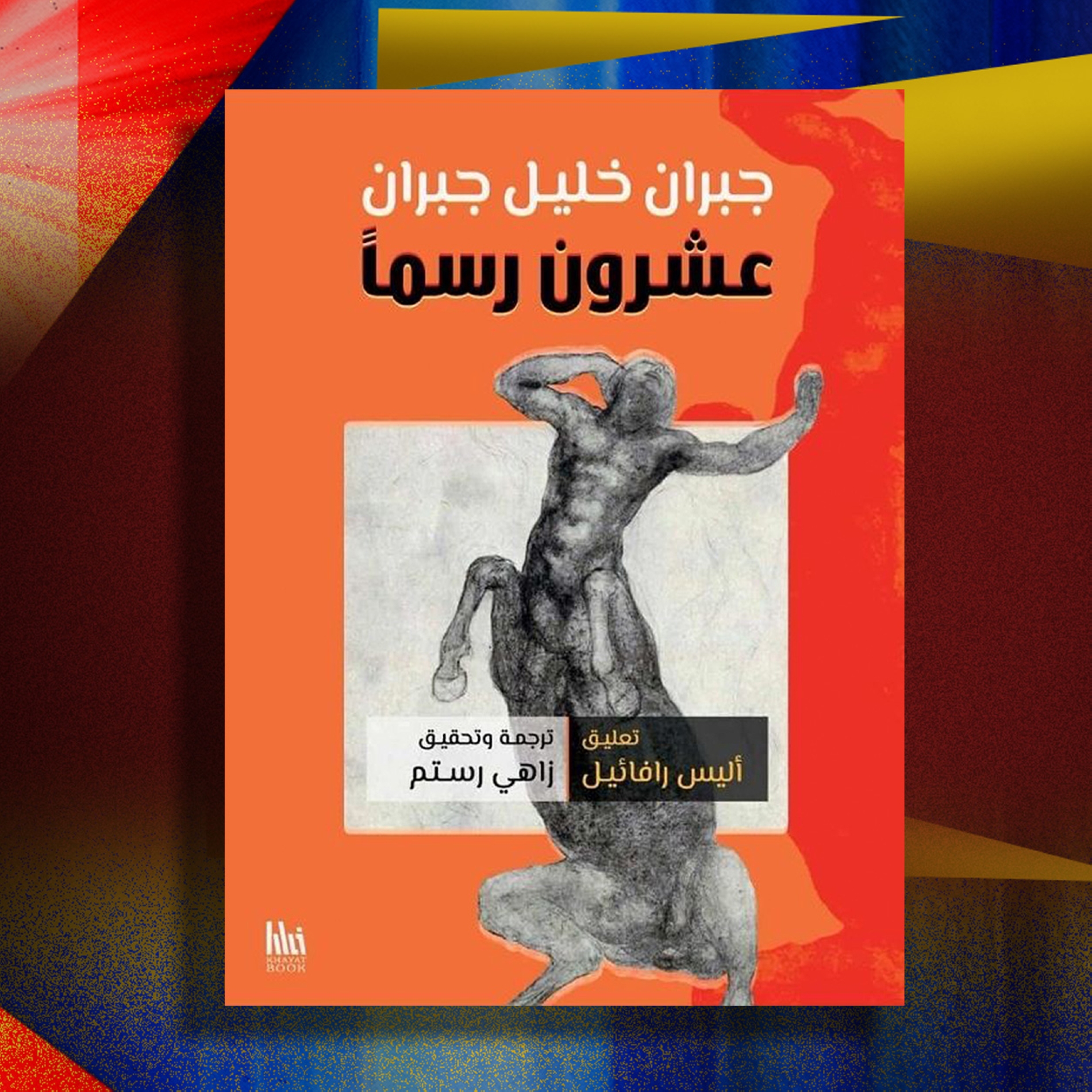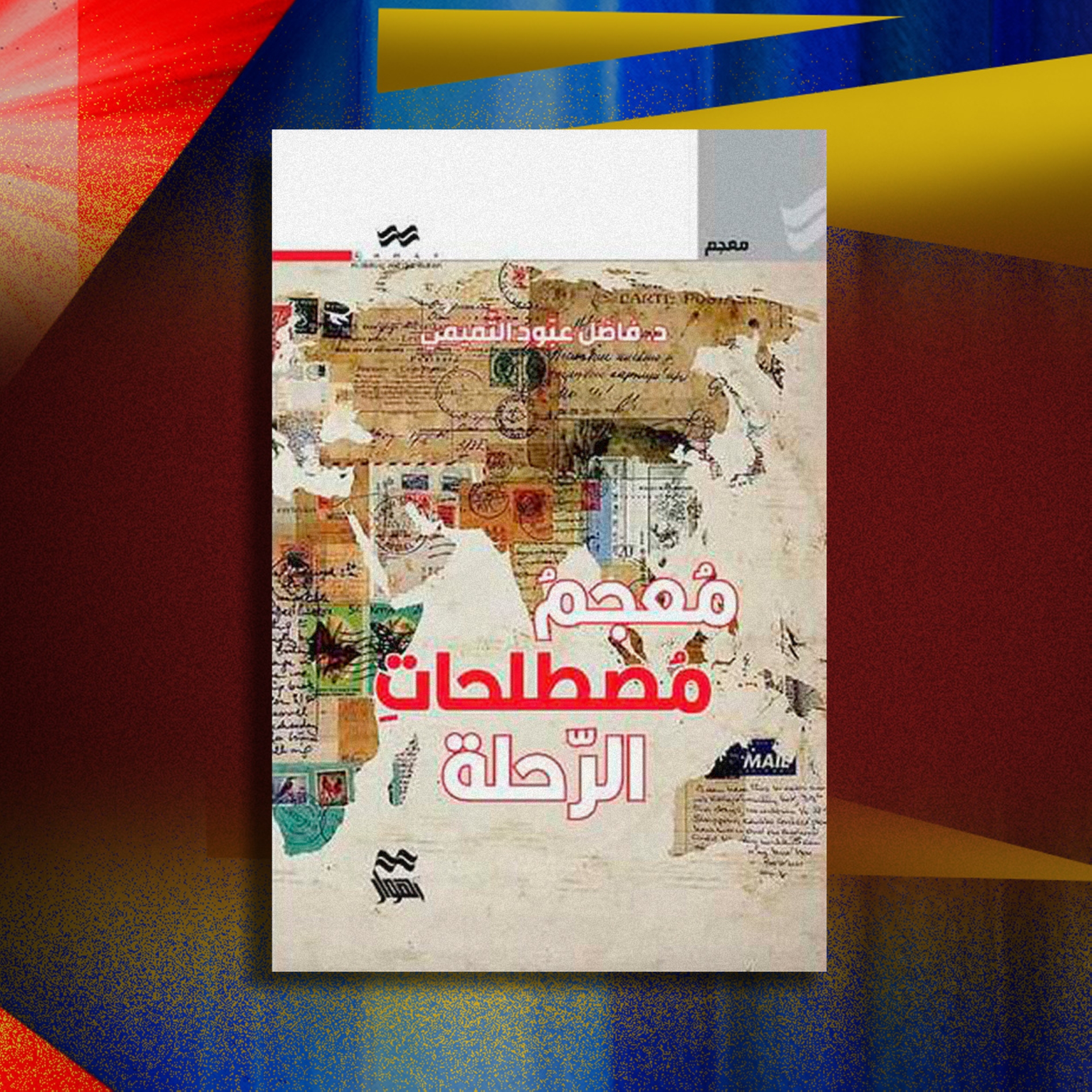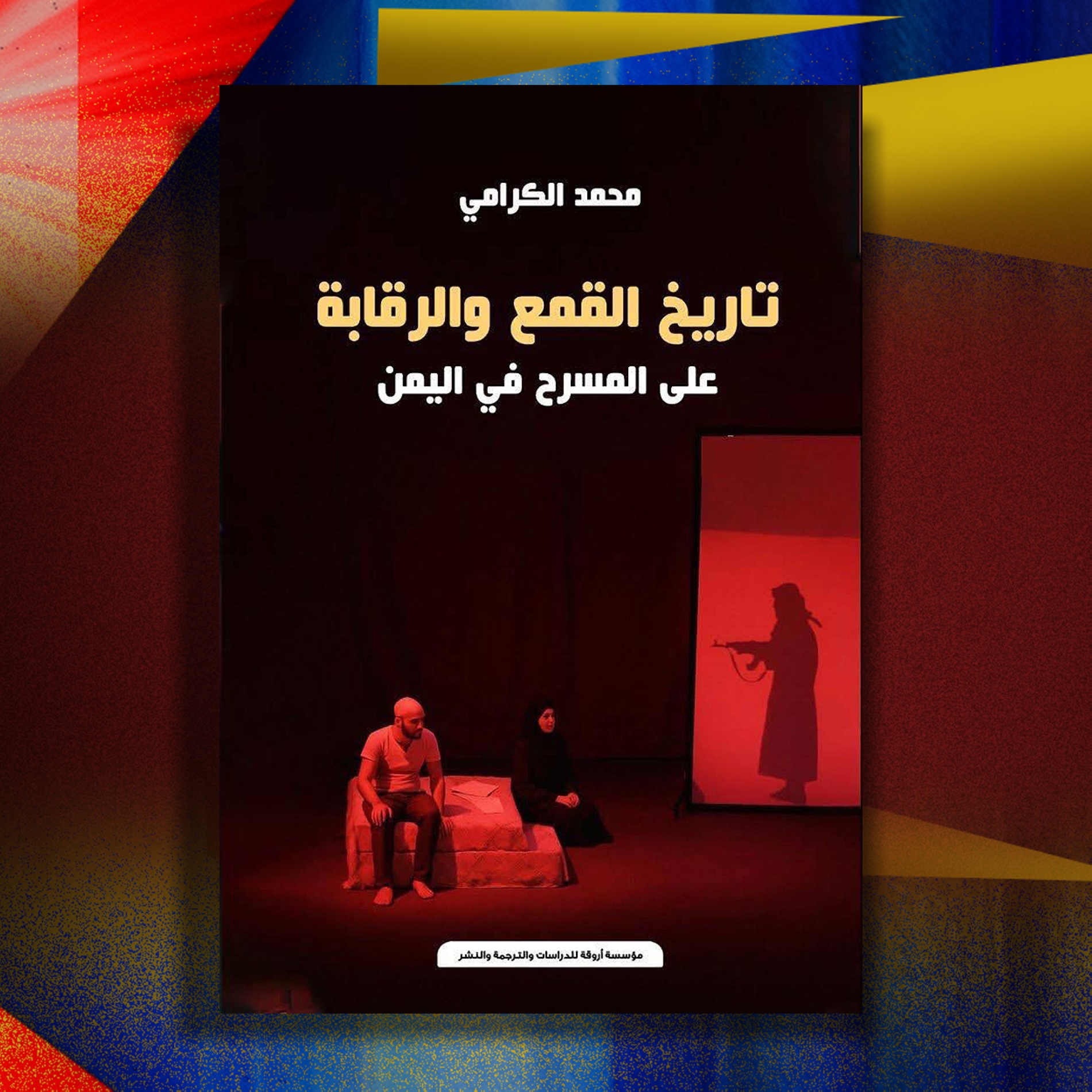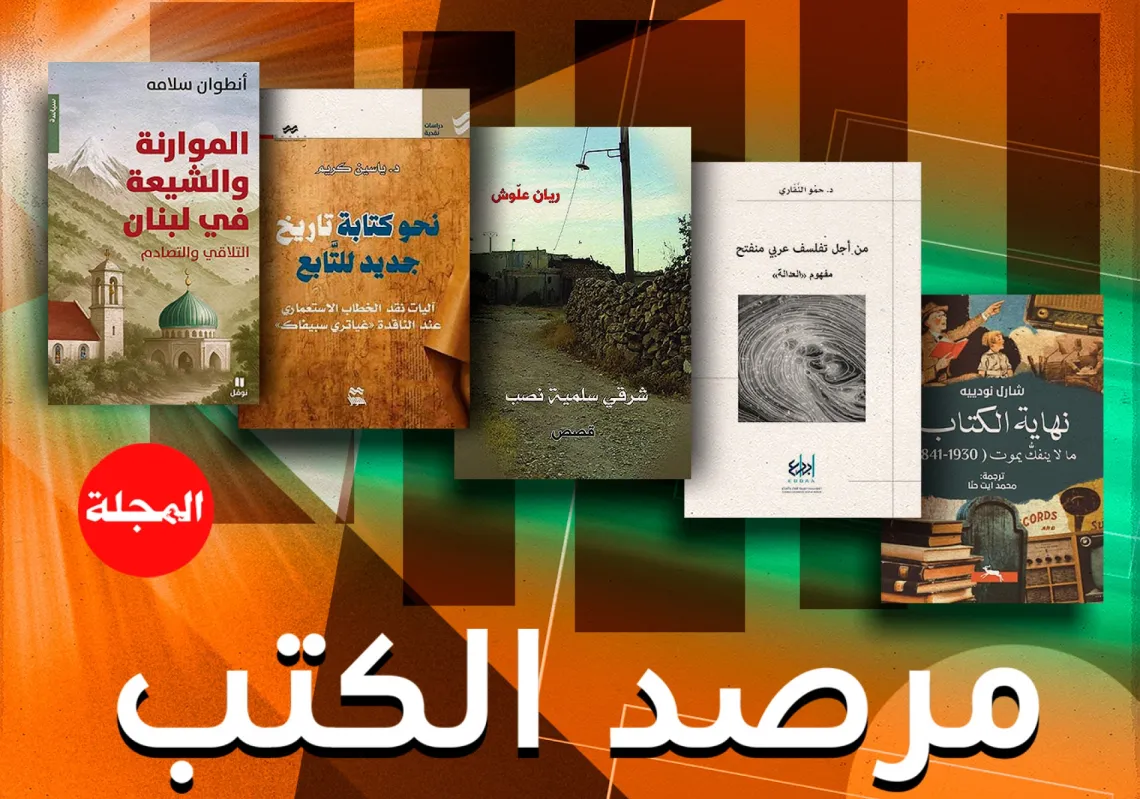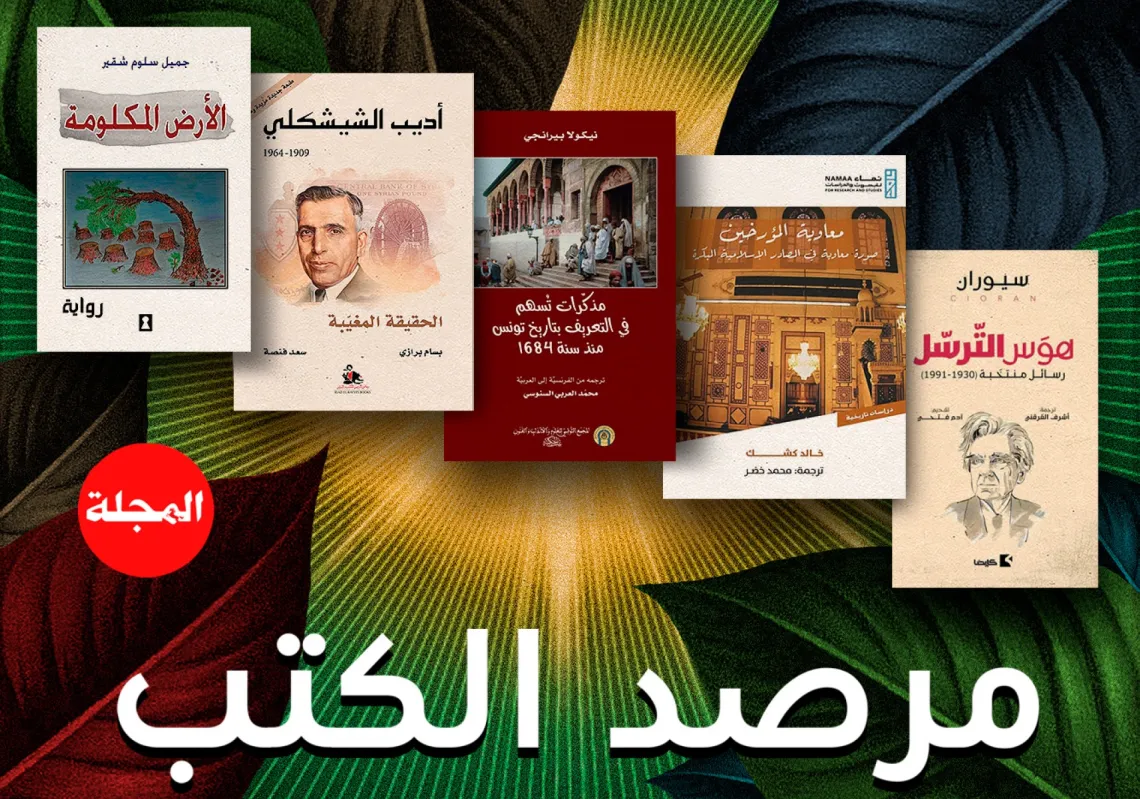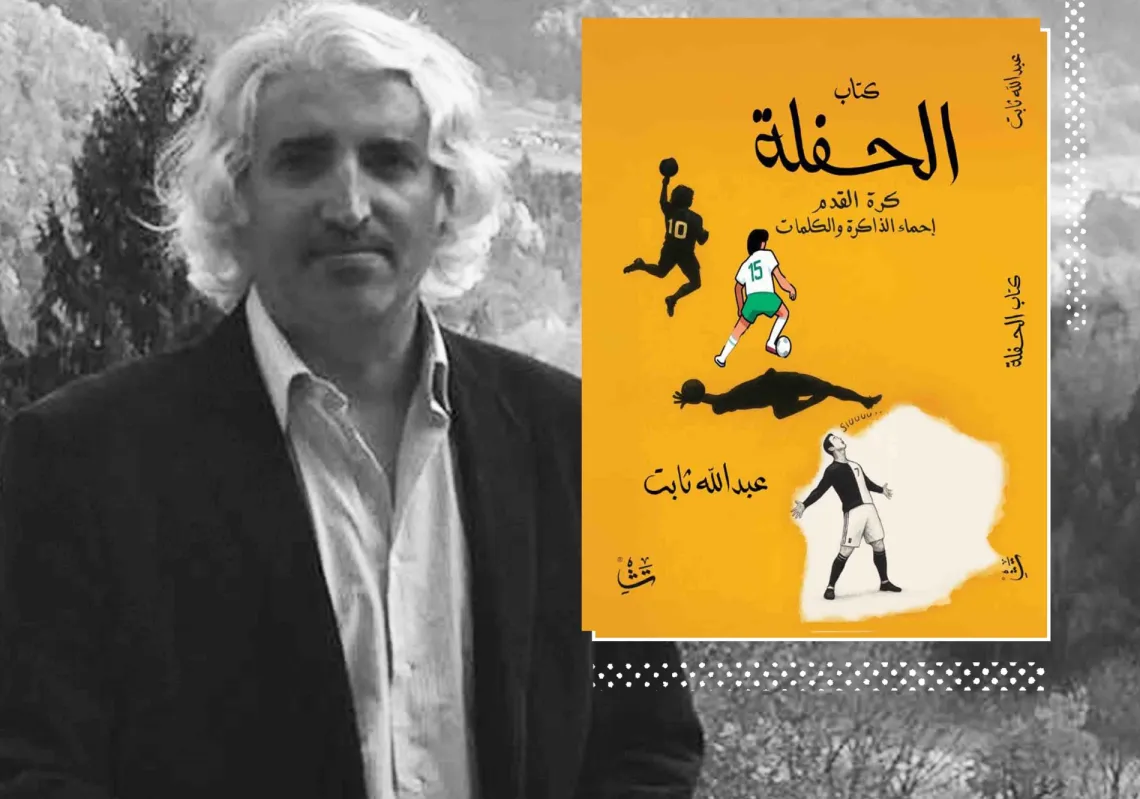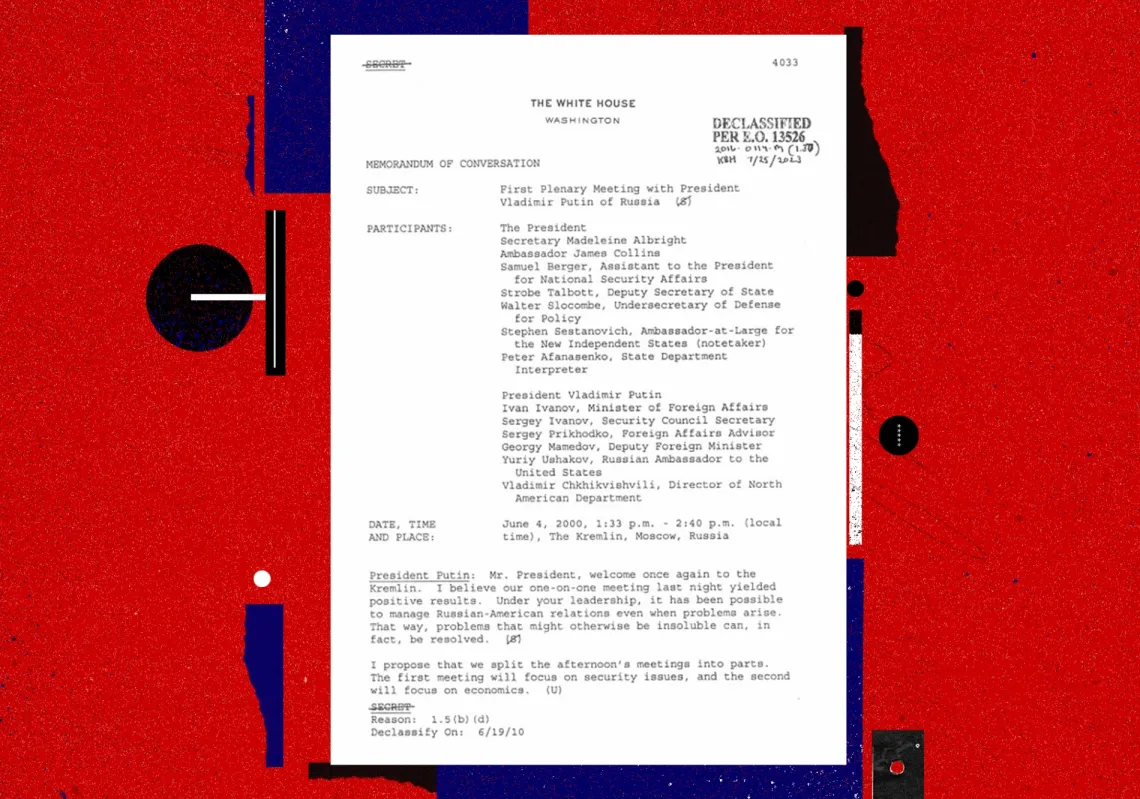نتعرف من خلال هذه الزاوية إلى أحدث إصدارات الكتب العربية، في الأدب والفلسفة والعلوم والتاريخ والسياسة والترجمة وغيرها. ونسعى إلى أن تكون هذه الزاوية التي تطل كل أسبوعين مرآة أمينة لحركة النشر في العالم العربي.
الكتاب: مدونة ليست شخصية – من دفاتر الزمن الفلسطيني – السوري
الكاتب: ماجد كيالي
الناشر: دار كنعان للدراسات والنشر- سوريا
في كتابه "مدونة ليست شخصية – من دفاتر الزمن الفلسطيني – السوري" يقدم الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي سيرة يمكن وصفها بالتأملية ممتدة على 247 صفحة موزعة على خمسة أبواب، تشكل لوحة بانورامية لتجربة جيل كامل عاش تراجيديا النكبات الفلسطينية والعربية، وتقاطعاتها مع المسارات الفردية والسياسية والفكرية.
يروي كيالي في سيرته هذه، بدايات تشكل وعيه الوطني والسياسي، من تجربة اللجوء والنشوء في بيئة فلسطينية – سورية، مرورا بانخراطه في صفوف حركة "فتح" في الأردن، وصولا إلى مرحلة النشاط السياسي في الثانوية، ثم تبلور موقف نقدي من داخل الحركة نفسها، قبل أن تصدمه تجربة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. يؤرخ لرحلة وعي ونقد في آن واحد، بين الالتزام والانكسار، وبين الحلم الثوري وصدمات الواقع التي يبدو أنها لن تنتهي.
يستعيد الكاتب ذاكرة المكان والهوية، متخذا من مدينة اللد رمزا لجرح مفتوح في الذاكرة الفلسطينية، بين مدينة الولادة الضائعة وحنين العودة المستحيلة. بعد ذلك يتحول السرد إلى تأمل ثقافي عميق، يرثي فيه كيالي الكتابة نفسها في زمن الخسارات، ويستعيد علاقته بالكتب بوصفها وطنا بديلا وذاكرة مقاومة، لا تقل أهمية عن البندقية أو المخيم.
يكتب كيالي بوعي المنفي الذي لا يستقر إلا في الكلمة، ويسجل سيرة إنسانية متوترة بين الانتماء والاغتراب. تتقاطع في ذاكرته بلا توقف مشاهد المنفى مع مشاهد التنقل المستمر بحثا عن معنى الوطن والذات. ويختتم بصفحات مؤثرة يكرسها لوجوه وأسماء من رفاق دربه ومسيرة النضال والفكر، من ماجد أبو شرار إلى سلامة كيلة وميشال كيلو وفيصل الحوراني، وغيرهم ممن تركوا بصمتهم في التجربة الفلسطينية – السورية الحديثة.