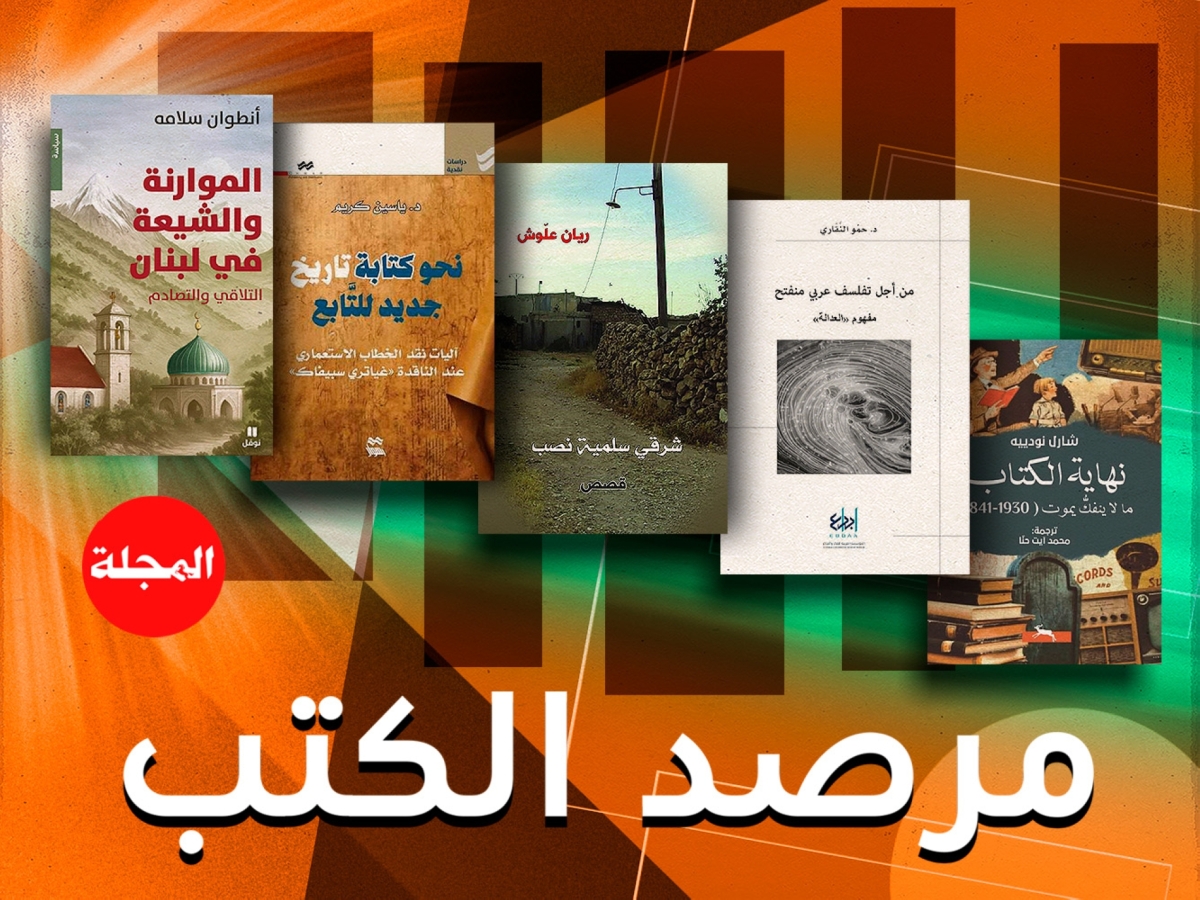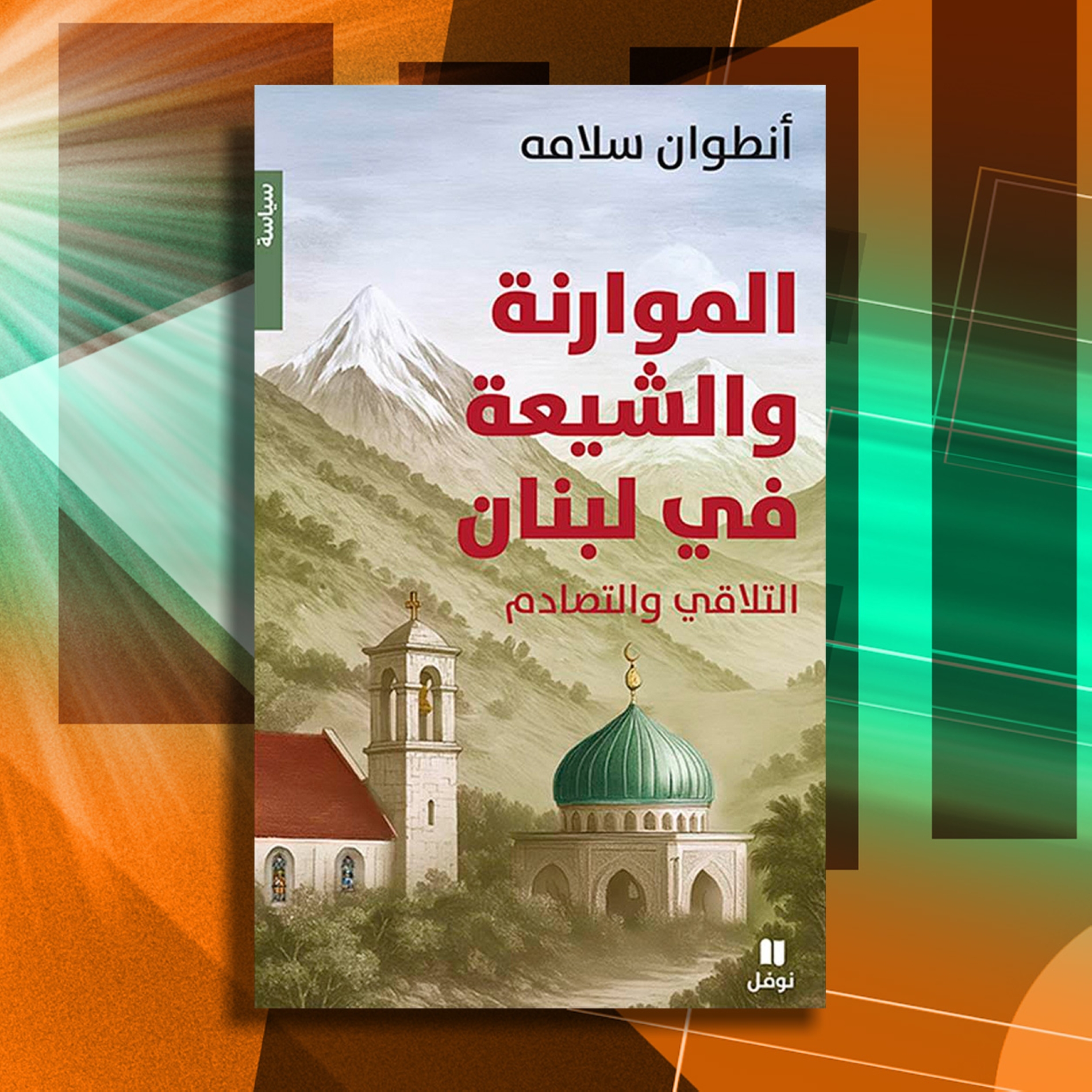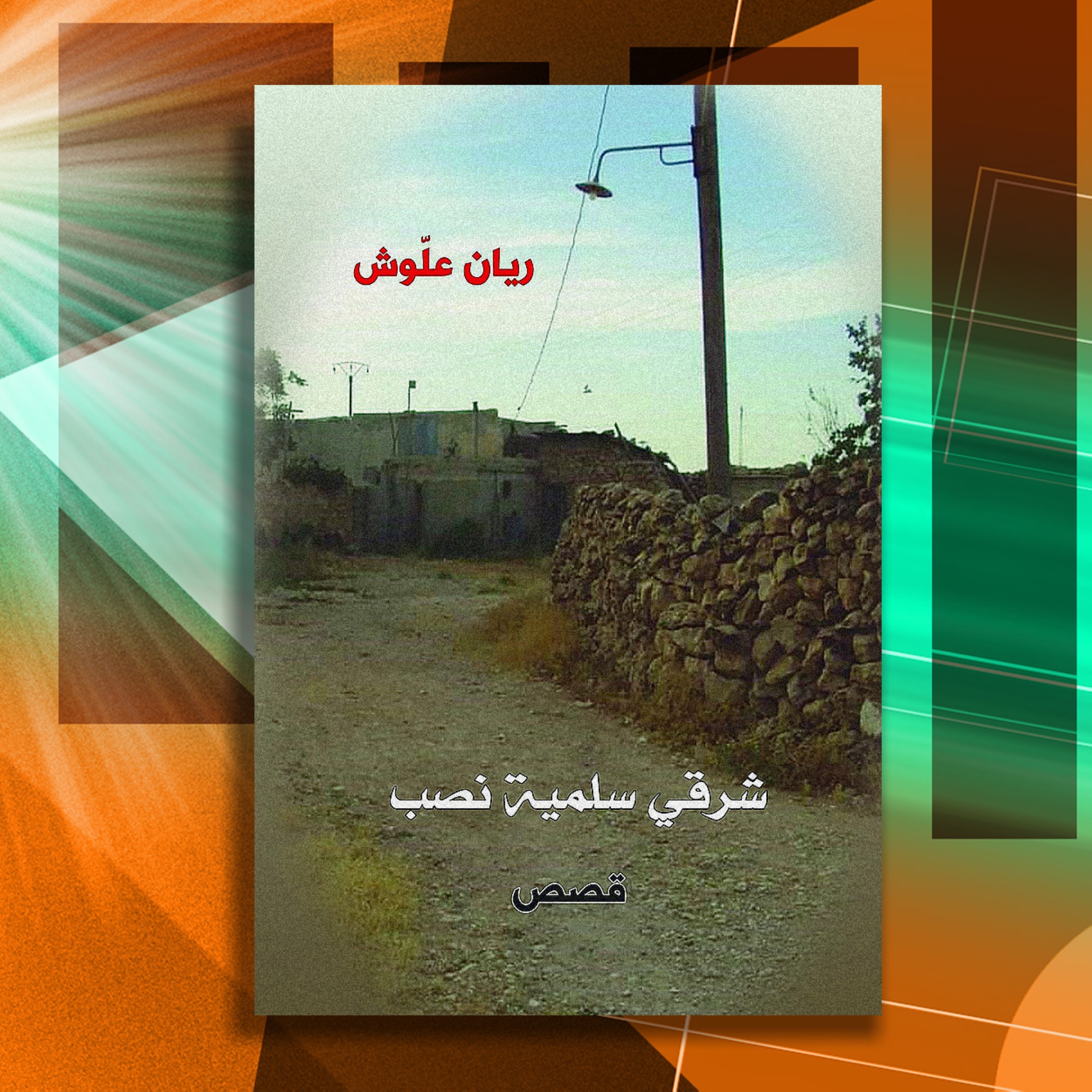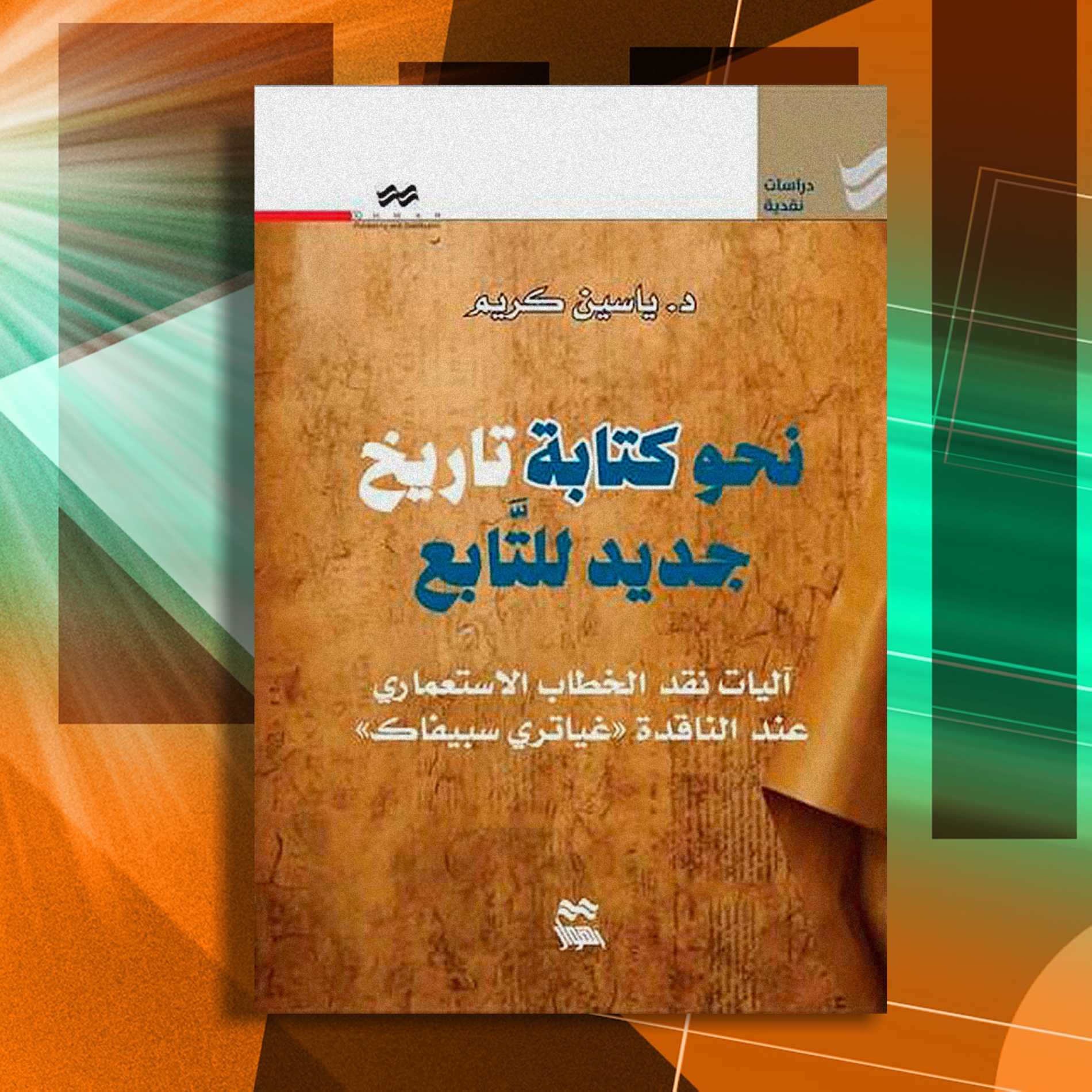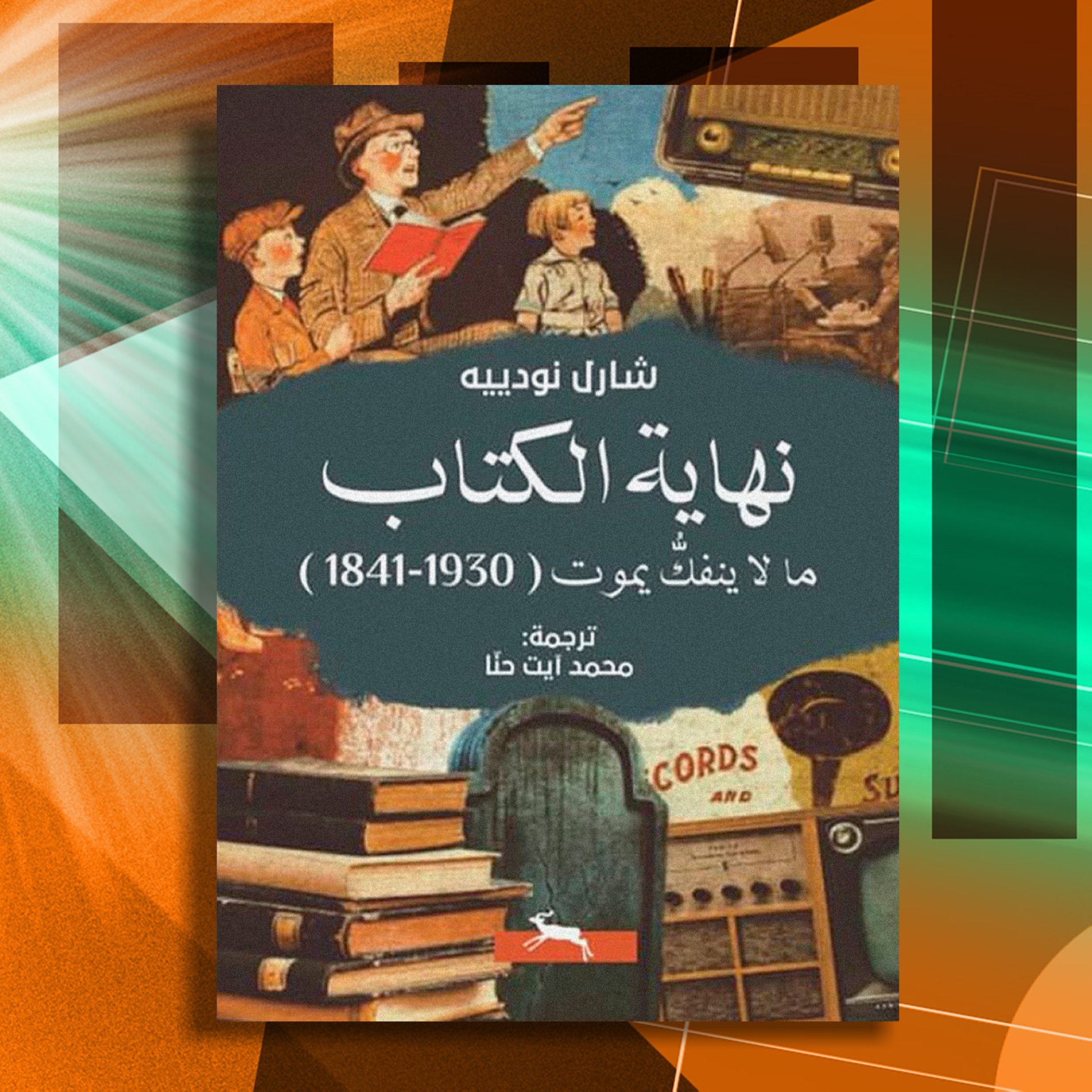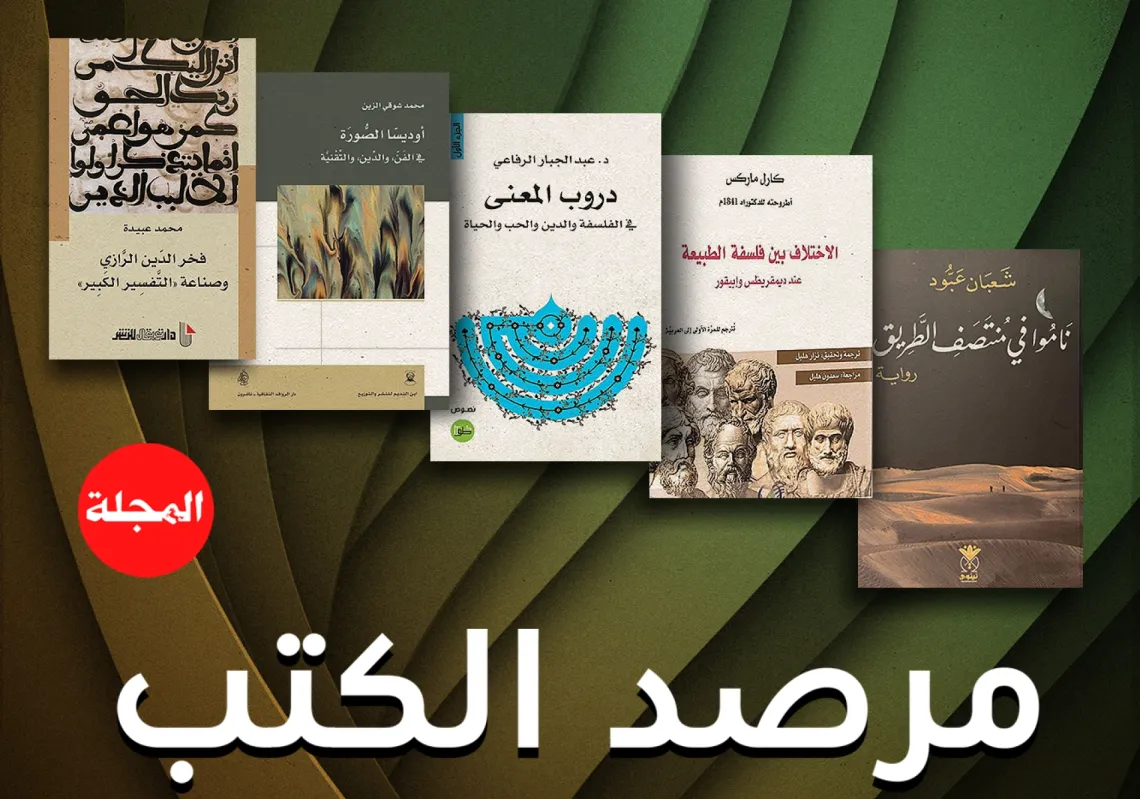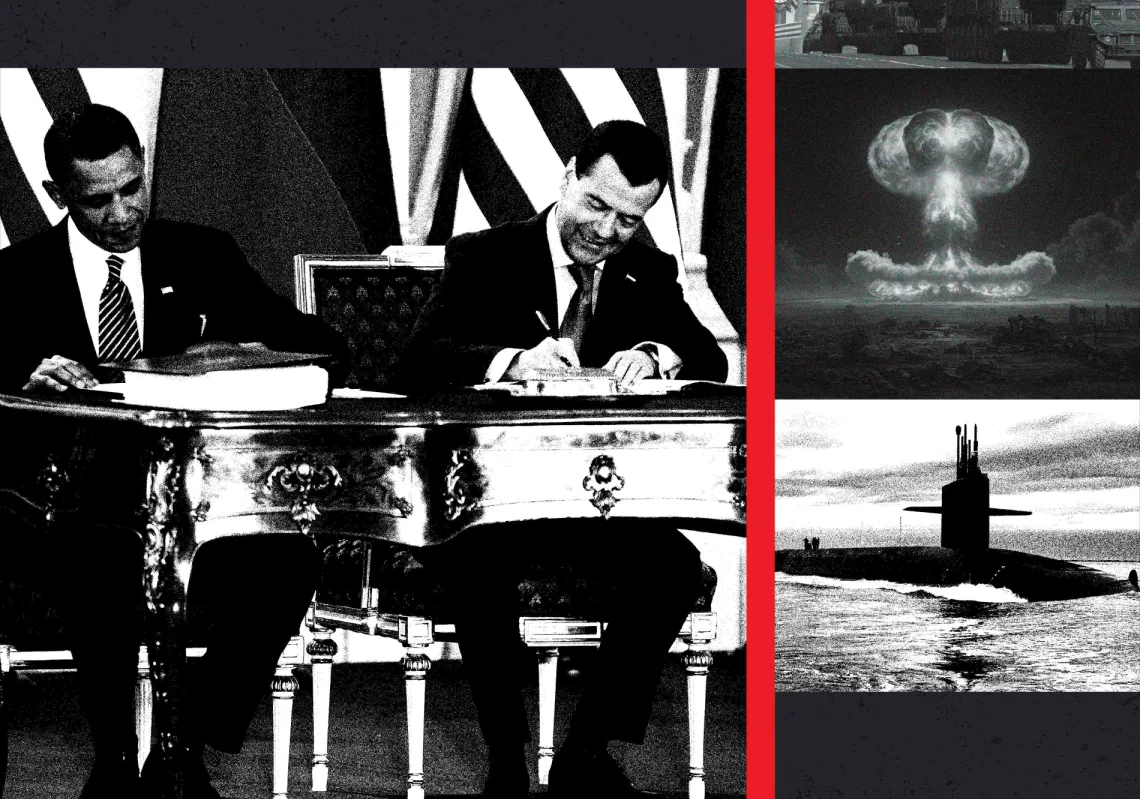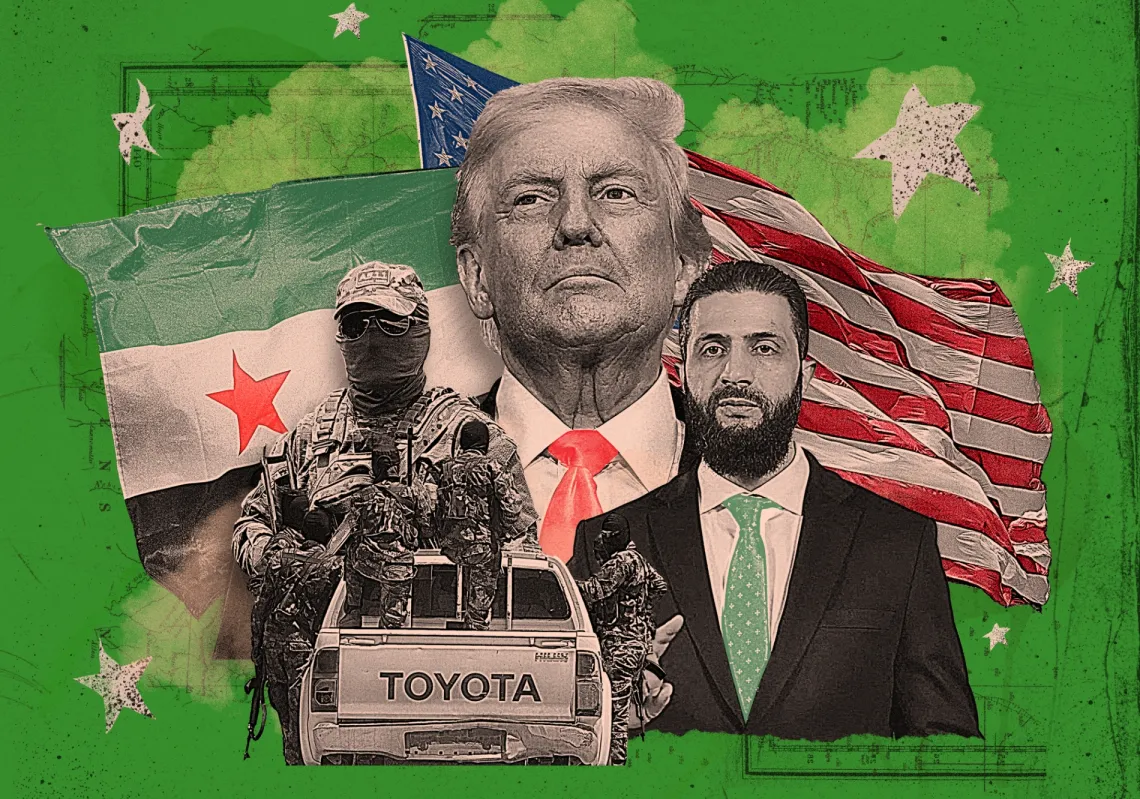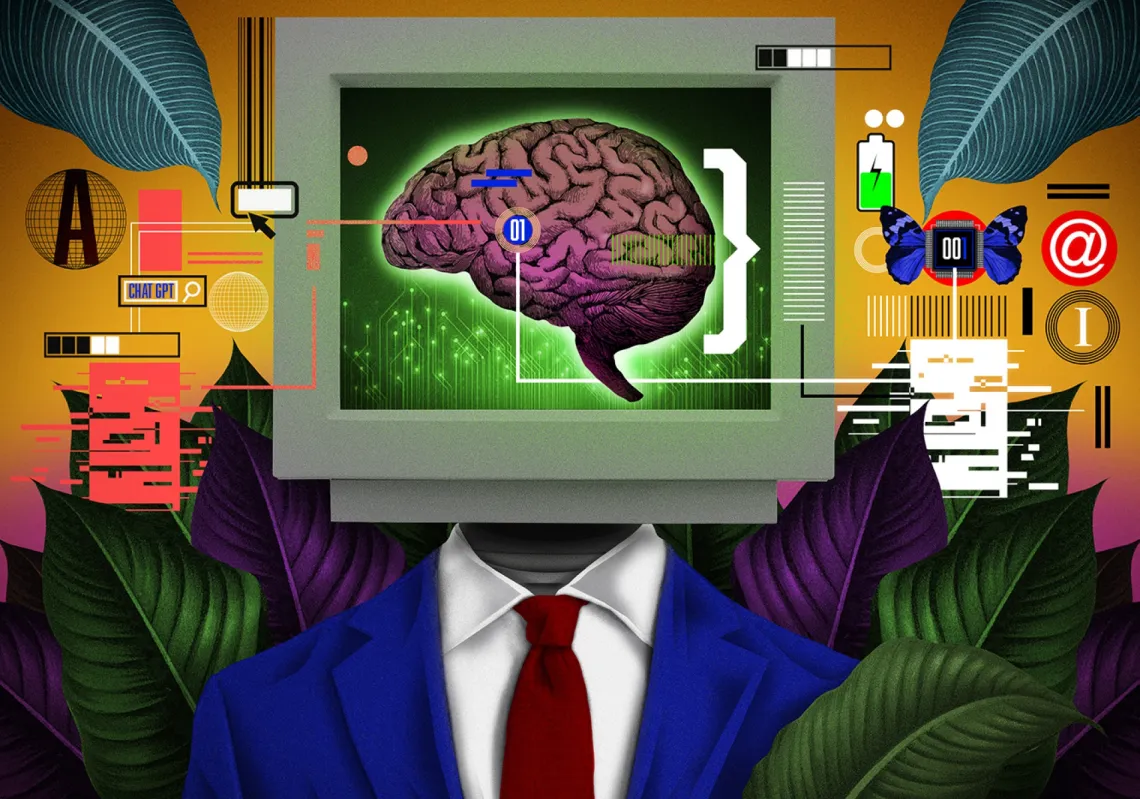نتعرف من خلال هذه الزاوية إلى أحدث إصدارات الكتب العربية، في الأدب والفلسفة والعلوم والتاريخ والسياسة والترجمة وغيرها. ونسعى إلى أن تكون هذه الزاوية التي تطل كل أسبوعين مرآة أمينة لحركة النشر في العالم العربي
الكتاب: الموارنة والشيعة في لبنان - التلاقي والتصادم
الكاتب: أنطوان سلامة
الناشر: دار نوفل – هاشيت أنطون - لبنان
يخوض الكاتب اللبناني أنطوان سلامة في كتابه "الموارنة والشيعة في لبنان - التلاقي والتصادم" في واحد من أكثر الملفات حساسية وإشكالية في التاريخ اللبناني الحديث، وهو العلاقة المعقدة بين الطائفتين المارونية والشيعية، التي قال إنه "صُدم" بما انطوت عليه تلك العلاقة من تصادم وتقاطع وتقارب وتباعد، بما أفضى إليه ذلك من انعكاسات سياسية واجتماعية وثقافية امتدت على مدى قرون.
الكتاب الضخم هذا هو نتيجة بحث تاريخي واجتماعي فكك الكاتب من خلاله العلاقة بين "جيلين في اتجاهين" كما أطلق عليهما في الفصل الأول، وذلك في إشارة إلى الطائفتين اللتين كانتا ركيزتين أساسيتين في تكوين الكيان اللبناني، حيث انطلقت كلتاهما من تجربة مختلفة في مقاومة السلطة المركزية من جانب، وفي بناء الكيانية اللبنانية من جانب آخر.
ينطلق سلامة من قراءة تاريخية تمتد من العصور الوسطى حتى الزمن الراهن، أي إنه يغطي خمسة قرون، ويستعرض كيف تشكلت العصبيتان المارونية والشيعية جغرافياً وسياسياً وديموغرافياً ودينياً، وكيف واجهت كلتا الطائفتين تلك الظروف، وكيف حافظتا على تماسكهما الداخلي عبر سرديات تاريخية خاصة، ومرجعيات دينية، ووجهات نظر متقابلة حول الدولة والسلطة والعلاقة مع الخارج، ما جعل اللقاء بينهما في لحظات تاريخية مختلفة من التاريخ محفوفا دائما بالخطر وبالهواجس والمصالح المتعارضة. لكن ذلك لا يعني أنه قدم سردا قائما على الصدام بشكل دائم، بل إنه توقف في محطات عديدة عند مساحات التلاقي بينهما، خصوصا في مراحل قيام الكيان اللبناني وتكوينه الدستوري في بدايات القرن العشرين، وكذلك خلال فترات التعاون السياسي- وإن كانت محدودة- التي حاول فيها الطرفان إيجاد أرضية مشتركة في مواجهة التدخلات الإقليمية.