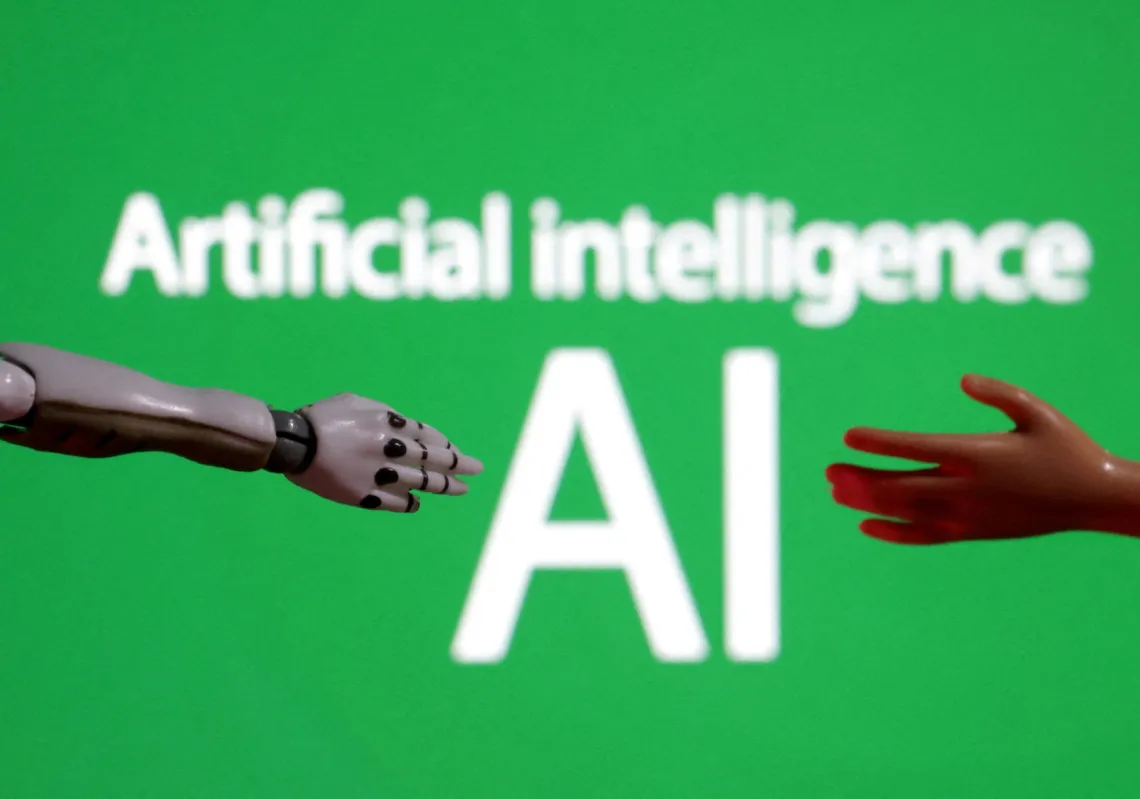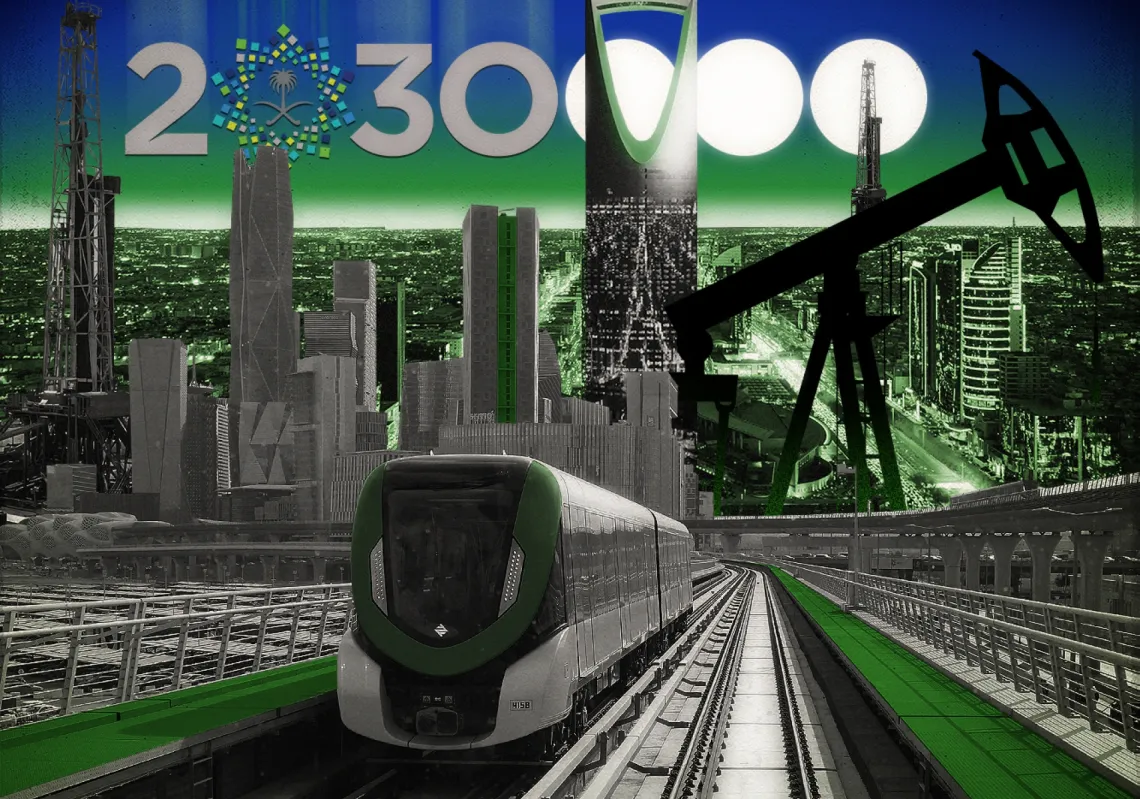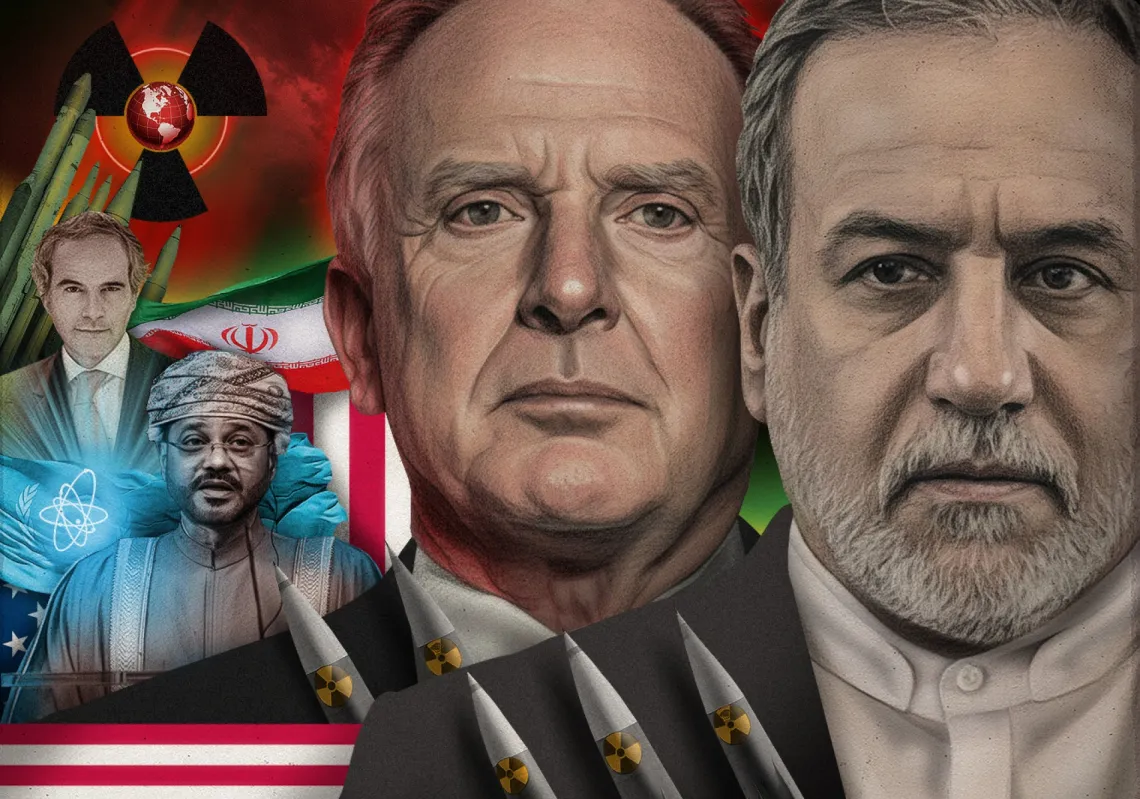هو ذا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين يشرف على نهايته، فيما تتبدل ملامح السياسة العالمية مبتعدة كل البعد عمّا كانت عليه يوم استقبلت الشعوب الألفية الجديدة في ساحات العالم.
بالنسبة لكثيرين، خصوصا في الغرب، مثّل عام 2000 ذروة التفاؤل بالديمقراطية الليبرالية، قبل أن تهتز تلك الثقة تحت وقع صدمات كبرى مثل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والأزمة المالية العالمية، وصعود الشعبوية اليمينية. أما في نظر آخرين، لا سيما في أجزاء من الجنوب العالمي، فقد حملت الأعوام الخمسة والعشرون الماضية تحوّلا حظي بالرضا، إذ انزاحت موازين القوة الدولية عن الهيمنة الغربية التي أعقبت الحرب الباردة.
لكن إلى أي حد تغيّر العالم حقا؟ بالمقارنة، شهدت أرباع قرون سابقة تحولات أعمق وأكثر جذرية. فالحقبة الممتدة بين 1975 و2000 شهدت انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتهاء الحرب الباردة، وسقوط الشيوعية كأيديولوجيا، وبروز عالم أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة ونظام الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية. أما الربع الأول من القرن العشرين، بين 1900 و1925، فقد حمل بدوره تحولات بنيوية هائلة، ودشّنت الحرب العالمية الأولى عصر الحروب الشاملة، وأفرزت دولا قومية جديدة من أنقاض الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية المجرية والعثمانية، كما شهد العالم للمرة الأولى وصول الشيوعية إلى السلطة.