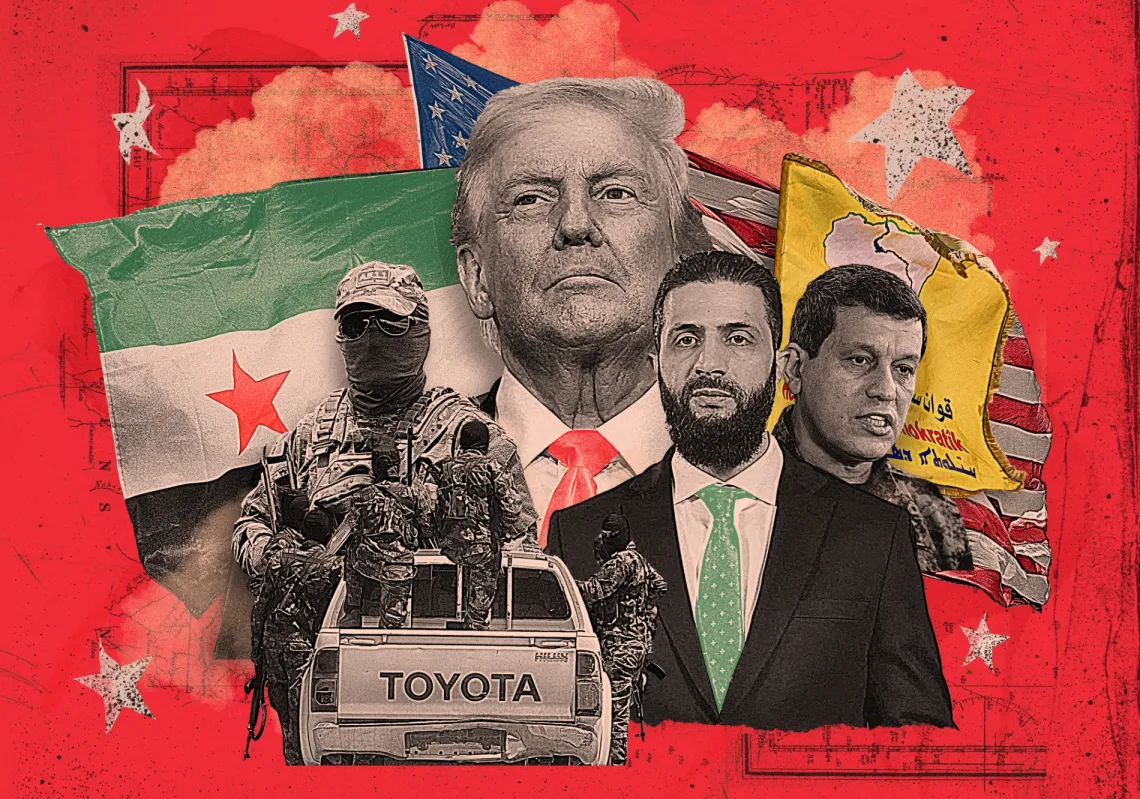في سيرة القاص والشاعر الفلسطيني طه محمد علي (1931-2011)، كما يسردها الكاتب عامر حليحل في نص مسرحي يعود إلى سنوات خلت، تفاصيل حياة إنسان "عادي"، كان يحلم بأن يشيد بيوتا ومتاجر في قريته صفورية في قضاء الناصرة، وأمضى حياته بعد ذلك، في حنين مسترسل إلى تلك القرية التي هجّر منها مع أهله في 1948 ولم يكمل عامه السابع عشر، عندما استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي، ليفر مع عائلته حينذاك إلى جنوب لبنان، وليعود متسللا إليها، بعدما قرر والده أن لا عيش لهم في لبنان.
العمل المسرحي الذي أعده وأخرجه المخرج المسرحي الفلسطيني المقيم في برشلونة محمد بيطاري (مع سوسانا برانكو مساعدة مخرج، ونيوس بالبيه تأليف موسيقي)، ضمن سلسلة عروض مسرحية فلسطينية حملت عنوان "برشلونة تنادي فلسطين"، على خشبة المسرح الوطني الكاتالاني، يظل أمينا لنص حليحل، وما التقشف الذي نراه على الخشبة، مع ممثل وحيد وبضع حقائب سفر، وبضعة كراس، سوى من قبيل إبراز الحكاية، حكاية الشاعر، بوصفها قادرة على النهوض بذاتها، دونما إبهار بصري، ولا إسراف ميلودرامي، وكأن الهدف في نهاية المطاف، ليس تقديم طه محمد علي بوصفه منتميا إلى جيل "شعراء المقاومة الفلسطينية" على ما نجد وصفه أحيانا، إلى جانب محمود درويش وسميح القاسم وعز الدين المناصرة وغيرهم، بل بوصفه إنسانا فلسطينيا، تتشابه حكايته وتتقاطع مع حكاية كل فلسطيني طرد من أرضه وأمضى حياته بعدئذ يعمّر تلك الأرض في مخيلته ولغته.
صوت الشاعر
صوت الشاعر الذي يصلنا عبر الممثل الإسباني السبعيني القدير لويس ماركو مجروحا مكسورا، وفي بعض الأحيان ساخرا بمرارة، وفي أحيان أخرى حانقا غاضبا، لا يبحث عن أسطرة المأساة الفلسطينية، وإن كان لا مفر من ذلك في نهاية المطاف، بقدر ما يسعى إلى تحويل ما لا يصدّق في تلك الحكاية، أصلها وفصلها مع الاحتلال والتهجير والاستيلاء على الأراضي، إلى حكاية سائرة أقرب إلى منطق الحكايات الشعبية، كتلك التي يرويها المسنون الفلسطينيون لأحفادهم في مخيمات اللجوء. وإذ يحمل الممثل أوراقه على الخشبة ويقرأ للجمهور النص الذي كتبه حليحل، فلكأنه يكسر لعبة الإيهام المسرحي. فالممثل هو الممثل، والخشبة خشبة، والشاعر الراحل هو الشاعر الراحل، وليس للرؤية الإخراجية لمحمد بيطاري أن تمضي أبعد من ذلك. فهو يريد منا أن نستمع إلى الحكاية، واعين تماما لتلك المسافة بين ما نسمعه وما نراه، وبين الواقع الفلسطيني المتعدد الطبقات والبالغة تعقيداته غالبا حد الاستحالة التامة.