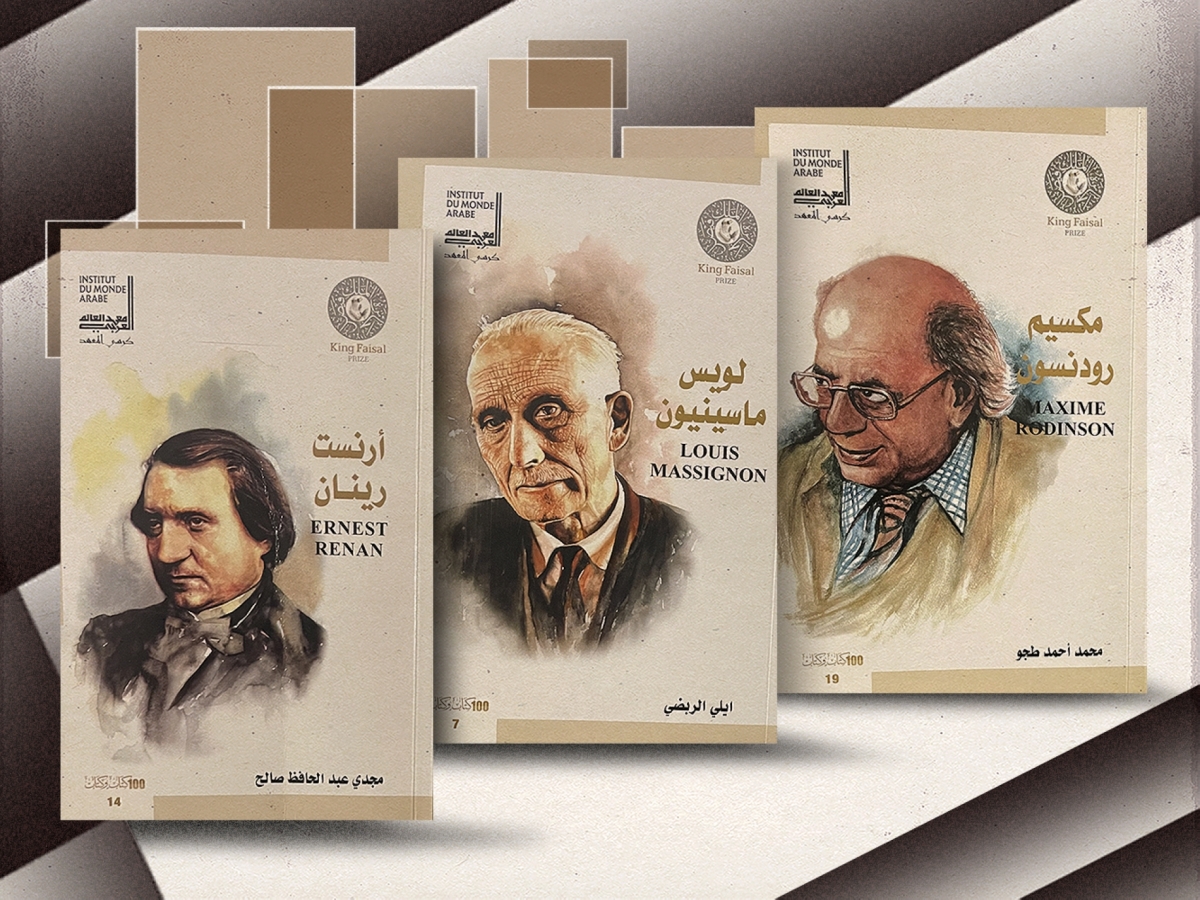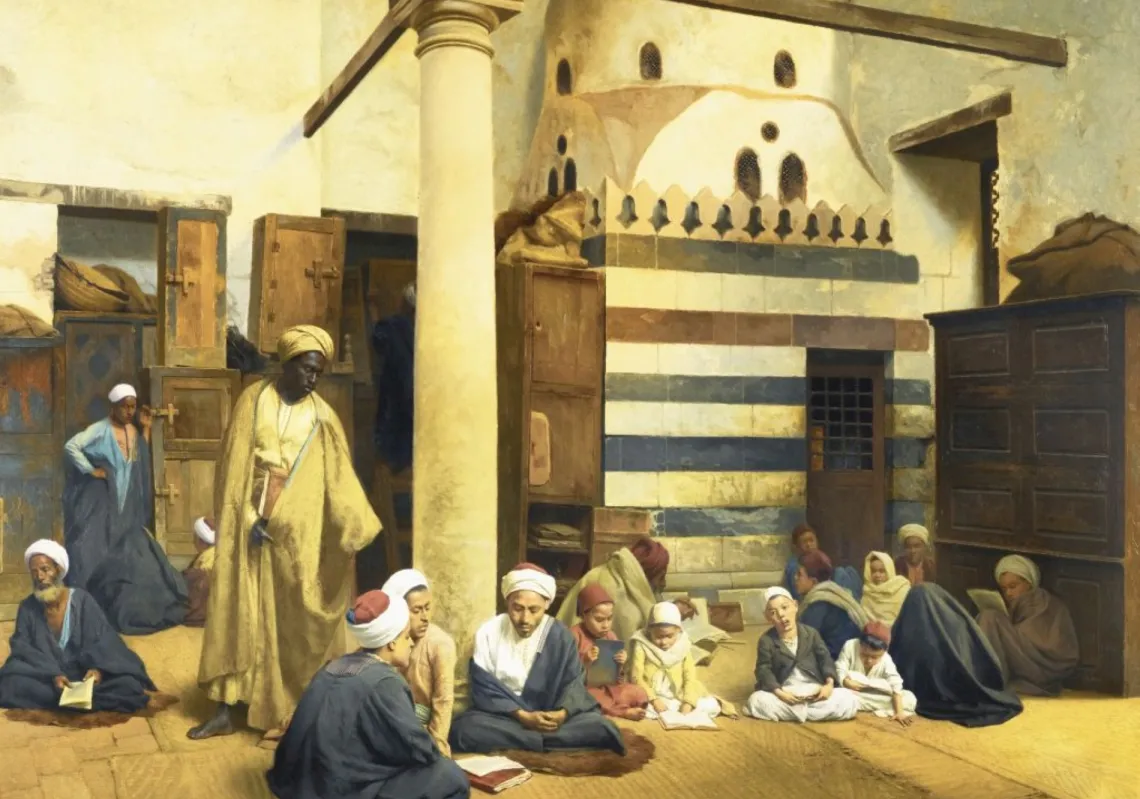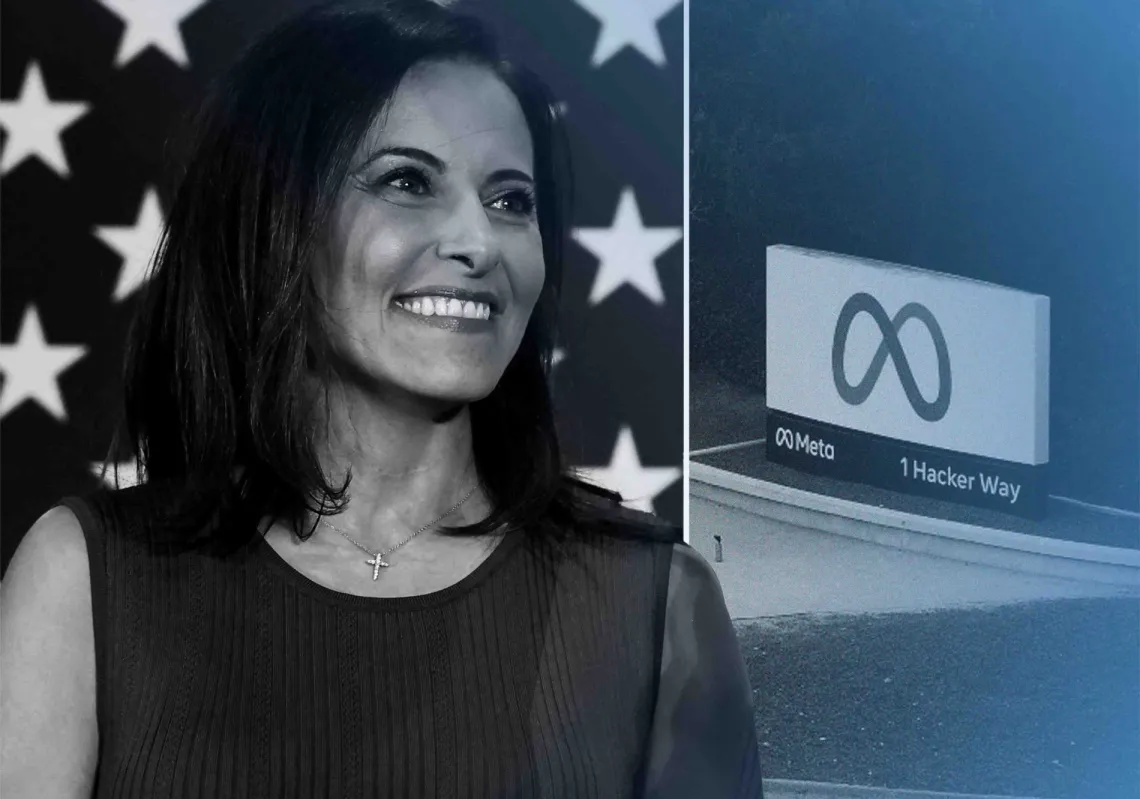قبل أن يغادر الكاتب والناقد السعودي معجب الزهراني منصبه كمدير عام لمعهد العالم العربي في باريس ترك أثرا مميزا، في إدارته، من خلال إصدار سلسلة كتب بعنوان "ألف كتاب وكتاب"، بالتعاون مع جائزة الملك فيصل العالمية، لذا قدّم مع الأمين العام للجائزة عبد العزيز السبيل لهذه السلسة.
يتمثل المشروع في اختيار شخصيات فكرية وأدبية وفنية وبحثية للتعريف بها، منها ستون شخصية عربية للكتابة عنها باللغة الفرنسية، وأربعون شخصية فرنسية للكتابة عنها باللغة العربية. ومن بين الشخصيات الفرنسية المهمة التي كُتب عنها، ثلاثة من كبار المستشرقين هم إرنست رينان ولويس ماسينيون ومكسيم رودنسون.
تظاهرات ضد رينان
يعدّ إرنست رينان (1823- 1892) أحد أبرز المستشرقين المهتمين بالثقافة العربية والإسلامية، إذ جاء في مرحلة تؤسس لمنهجية علمية حديثة في دراسة الأديان واللغات الشرقية، ولذا تبوأ مركزا مرموقا في عصره، سواء في عضويته في الأكاديمية الفرنسية أو في الجوائز والسجالات التي دارت حول أطروحاته.
الأكاديمي المصري مجدي عبد الحافظ صالح أشار في كتابه التعريفي "إرنست رينان" إلى محطات عدة أثرت في حياة رينان، منها دراسته للتراث الغربي بروح نقدية ميّز فيها بين الجوانب التاريخية والأسطورية في المصادر الدينية، وهي الروح النقدية التي التزمها في دراسته للتراث الإسلامي. فمن أطروحاته المثيرة للجدل قوله إن من المستحيل أن يكون كتاب التوراة "موحى به، وذلك باعتماده على براهين تاريخية" وفلسفية. كما أنه حين عُيّن عام 1852 أستاذا لكرسي اللغة العبرية بالكولاج دي فرانس طُرد منها بعد زمن قصير "لأنه تجرأ وتحدث عن المسيح بعبارة: المسيح هذا الإنسان الرائع. وهو ما اعتبرته الكنيسة ورأسها ومناصروها تطاولا منه لا يغتفر"، بل إن تظاهرات خرجت ضده بعد أن أطلق عليه البابا لقب "المجدف الأوروبي".
وأدى ذلك إلى انتشار أطروحاته في مختلف المجالات، فقد كان "مؤرخا ولغويا وعالما بالأديان والآثار الشرقية، علاوة على تخصصه في تاريخ اللغات والشعوب السامية، مما جعل منه أيقونة عصره ونموذجا فريدا ومثاليا للمثقف الموسوعي في القرن التاسع عشر".