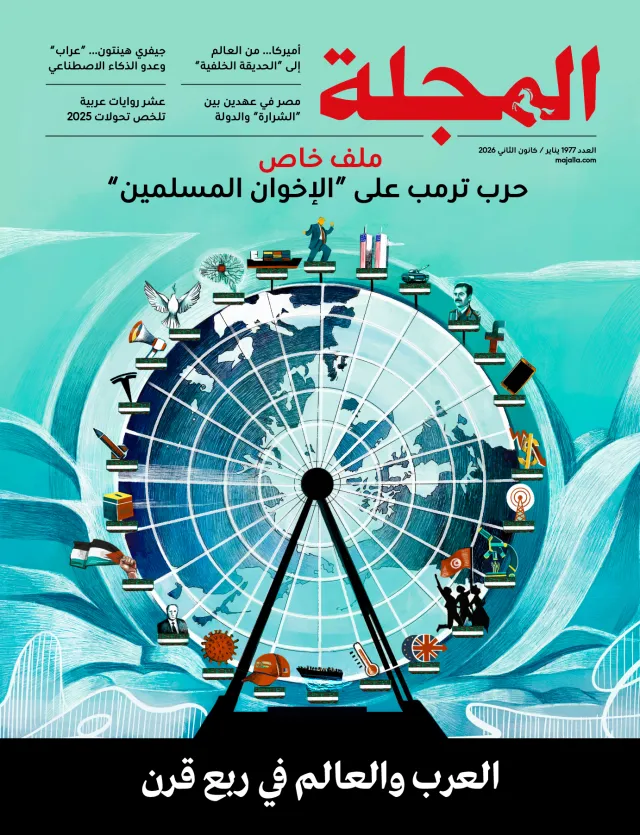في أي مجتمع نابض بالحياة، يظل المعنى ناقصا مهما بدا مكتملا ما لم يعبر أولا من خلال عيون كاتب يلتقط التفصيل المهمل، ويوقظ فيه السؤال الغائب، لأن الكاتب- وتحديدا كاتب الأدب- لا يكتفي بسرد ما حدث، بل يعيد ترتيب الفوضى بلغة لا يملكها إلا الكُتّاب الجادّون الذين يسهمون بكتاباتهم في توثيق مراحل عصرهم بأساليب متعددة، ويؤثرون في المجتمع، باعتبار أن الأدب يسهم بدور كبير في بناء المجتمعات وتوسيع مداركها ومصادرها التثقيفية وبغياب أركانه ورواده تسقط أحد أعمدة بنائه مهما سعت التقنيات بأشكالها الحديثة إلى استبدالهم.
إن حضور الكاتب في المشهد الثقافي والاجتماعي لم يكن يوما ترفا نخبويا، أو نشاطا هامشيا يقبل التوقف متى ما أراد، بل ضرورة خلّاقة تفرضها تحولات العصر، ويغذيها التزام داخلي لا يشترط منصبا أو تصفيقا، أو جائزة أو تكريما.
إنه ضرورة لا تولد من ضغط الخارج، بل من استشعار مسؤولية الكلمة، وسُلطة الفكرة، وقدسية لا يمكن الخلاص منها، لهذا على الكاتب أن لا يهرب، وأن لا يكتفي بدور الشاهد المحايد، فتاريخ المبدعين لا يكتب نفسه، بل يُكتب بمن حضر، لا بمن امتنع أو انصرف.
ومن لا يشارك في تدوين زمنه كما يجب، سيجده لاحقا مكتوبا بعيون أخرى، وعلى هيئة قد لا تمثّله ولا تشبهه. لذلك عليه أن يستشعر مسؤوليته الفكرية تجاه لحظته، لأن تخليه عنها يفتح الباب واسعا أمام ضجيج عابر لا يُبقي من المعنى شيئا.
الغياب في لحظات التحوّل الكبرى ليس حيادا بل فراغ يُملأ وغالبا بأصوات لا تزن الكلمة ولا تعي تبعاتها
قد يغيب الكاتب عن مشهده وهو في أمسّ الحاجة إليه، ينسل منه في ذروة الأحداث، وأكثر اللحظات اشتعالا بالأسئلة: فما الذي يحدث له؟ هل هي خيبة أصابته؟ أم تآكل داخلي؟ هل جاء انسحابه كاحتجاج صامت؟ وهل يملك الكاتب، وهو المحمّل بكل هذا العبء الوجودي، رفاهية الغياب أصلا؟ هذه التساؤلات وغيرها تفتح الباب لنقاش أعمق حول توازنات الدور ومبررات التواري، وحول معنى ونوع الغياب نفسه في حياة محاطة بالموهبة والقدرة والقيمة والفردانية.
تتباين أسباب الغياب وتتعدد، وفي كثير من الأحيان تبدأ القصة من الداخل: من إرهاق فكري لا يُرى، أو خيبات متراكمة تُطفئ جذوة القلب. ثم هناك العوامل التي تأتي من الخارج، والتي لا تقل قسوة عن سابقتها كتغيّر البيئة الثقافية، وتحوّلها إلى فضاءات استهلاكية سريعة، تحتفي بالصوت المرتفع أكثر من الرأي العميق. فضاءات قد تتسابق فيها الآراء على حساب الأفكار، وتُقصى فيها لغة التأمل لحساب الإثارة المسطّحة... وبمثل هذه البيئات وغيرها قد يشعر الكاتب الحقيقي الجاد وكأنه بات غريبا عن الساحة التي كان يوما أحد بُناتها متحولا بغيابه إلى أرشيف لا يُستعاد، لأنه لم يمنح نفسه فرصة البقاء في الذاكرة عبر الاستمرار. فهل هزم من تلقاء نفسه؟ أم هزمته أشباح علينا اتهامها لتبييض هزيمته أمام ذاكرتنا التي تتعطش لأدبه.
إن المشهد لا يعرف التوقف، ومع الوقت لن يعترف بالمتوقفين ولا ينتظر أحدا ليلحق به. فالعالم يتحول في كل لحظة، والقيم تُعاد صياغتها، والأفكار تُختبر من جديد. وفي خضم هذا الحراك، لا يُطلب من الكاتب أن يكون حاضرا بمقالة أو كتاب فحسب، بل بروحه ورؤيته ولو من خلف سطور صامتة، لأن الغياب في لحظات التحوّل الكبرى ليس حيادا بل فراغ يُملأ وغالبا بأصوات لا تزن الكلمة ولا تعي تبعاتها.
وما تجدر الإشارة إليه أن كل الأسماء المستترة خلف ظروفها وصمتها المأهول بالأذى النفسي لا يمكن استعادتها يوما بالتساؤل عنها في الندوات، أو بإشارة طفيفة في مقالات وإنما عبر خلق بيئة ثقافية حقيقية، ليست موسمية ولا نخبوية، بيئة تسمح للكاتب أن يعبّر، باتفاق أو اختلاف، أن يُخطئ ويُخطّئ.. بيئة تمنح البقاء وبذات التوقيت تهتم بالاستعادة.
ولعل ما يحتاجه معظم الكتّاب اليوم هو إيمان كامل بدور الكاتب لا كزينة ثقافية، بل كعنصر جوهري في تشكيل الوعي العام، ومناخ ثقافي يرى في الكاتب شريكا في التنمية، ومستشارا في الإعمار الذهني لا مجرد هامش فكري على أطراف المشهد يستعان به لإدارة ندوة حوارية حول أديب آخر راحل أو صامت منذ سنين.
إن الدور الذي يقوم به الكاتب هو مسؤولية وجدانية ومجتمعية، لا يحملها إلا من اختار أن يكون شاهدا ومشاركا في آن. لذلك، فإن وجوده في قلب مجتمعه ليس خيارا هامشيا، بل حاجة ملحة. وعليه بات من الضرورة أن يكون لكتّاب الأدب الإبداعي الجادّين أصحاب المشاريع الأدبية المستمرة جمعيتهم التي تسهم في مراجعة الناتج الكتابي، يمارسون من خلالها دور الخبراء بعدما أنهوا جميع تجاربهم الإبداعية والفكرية، جمعية تحافظ عليهم من الاندثار والتلاشي وتساندهم في مرحلة الصمت أو التقاعد الإبداعي للبقاء على قيد الكتابة وتنمية موارد الأدب.