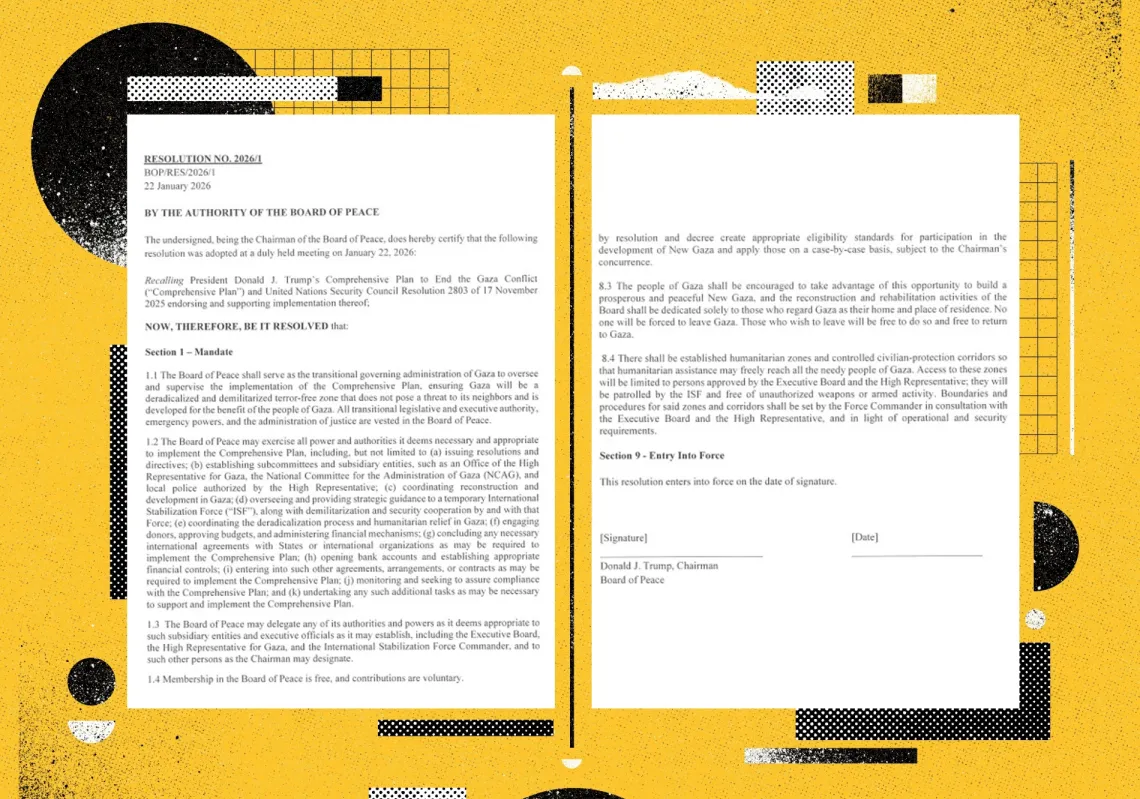ابتداء من شهر يونيو/ حزيران الماضي، تشهد سماء لبنان تقاطعا غريبا، وإن ليس بالجديد، بين الحرب والفن. تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للبنانيين لم تمنعهم الحرب الإيرانية - الإسرائيلية عن المضي قدما في أجوائهم الترفيهية، من غناء ورقص.
لو قدر لمؤلف موسيقي أن يستلهم مقطوعة، من التشكيل البصري، الناري والدخاني، الذي احتل عمق السماء اللبنانية، على مدى أيام، وتمكن الناس من معاينته بالعين المجردة، لتوصل ربما إلى تدوين نوتات نادرة، عنوانها "رقصة النار"، تتلوى الإيقاعات لولبية على سلالمها، كحركة الصواريخ الباليستية، هابطة تارة في اتجاه حيفا أو تل أبيب، أو وافدة تارة أخرى الى الغرب الإيراني. ستكون مثل مقطوعة منظومة على "مقام حربي" يمد خطوطا أفقية حتى الحدود الجوية، يصعد إلى عمق الفضاء، ثم يهبط عند المستويات الجنوبية حيث يتلاقى بخطوط أخرى، أو ينفجر قبل ذلك مخلفا شررا يمس النفوس. بينما اللامبالون (أو لنقل متبعو نهج الواقعية السوداء) مستمرون في رقصة، يحب الشعب اللبناني، الذي أنهكته الحروب، أن يطلق عليها اسم "انبعاث الفينيق"، في إحالة مستمرة على تاريخ حضارته القديمة، المجيدة والمندثرة.
يندرج "الرقص تحت الصواريخ" ضمن أقصى الصور الوجودية العدمية التي أظهرتها بعض أفلام سينما هوليوود، بدءا من نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورا بحقبة الحرب الباردة، وصولا الى الاجتياحات الكبرى وحروب نهاية الألفية الماضية، وهي لطالما ألهمت مخرجي الافلام، خارج أميركا أيضا، وكذلك منتجي المحتوى على منصات التواصل خلال الربع قرن الماضي.
تلك العدمية، التي ترفد التصرفات العبثية، هي جزء من التاريخ المديد للبنان المحاصر بسردية الحروب والافتقار الى الأمن، ورغبة البقاء بالرغم من كل شيء.
الحفر في نظرية قديمة جديدة
في مواجهة هذا الشعور القاتم، القادر على شل أي صيروة إبداعية، ورمي أي صانع فنون في غياهب الإحباط، يبدو أن مجموعة منوعة من المشتغلين في الموسيقى المعاصرة، التقتها "المجلة" على امتداد الأطياف اللبنانية، آثرت التحرك على مستوى فني وجودي مغاير تماما للسائد.
قرر هؤلاء، أفرادا ومجموعات، أن ينتقلوا الى ما بعد محاولة تقصي الفهم الواعي والتحليل والترقب، التي لم تؤدّ خلال عقود مضت سوى إلى هدر طاقة أصحابها، في بلد لا تتغير فيه الأشياء بسهولة. وجدوا ضالتهم، للإجابة عن الأسئلة التي تؤرقهم، داخل أنماط موسيقية يمكن وصفها بالبدائية، تتضمن تجارب صوتية وأداءات استلابية، وتخاطب غرائز أولية، متمحورة حول طلب الشعور بالأمان في مواجهة التهديد الشائع بـ"القنص" و"التلاشي".