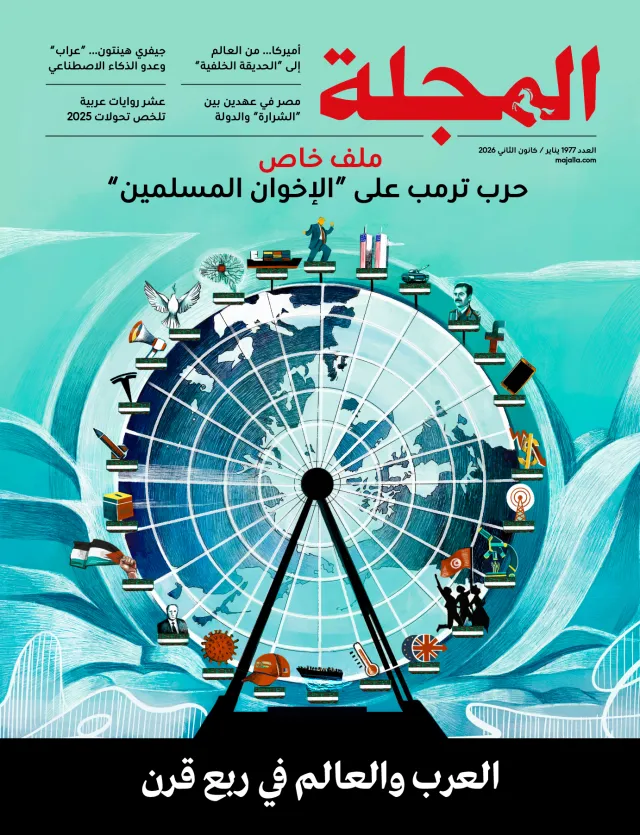إنها حنة آرندت، التي فارقت العالم قبل 50 عاما، الصوت الفلسفي والفكري الفريد، الذي خاض المعارك الأيديولوجية والقضايا الأساسية التي شهدها القرن العشرون، وهيّأت نفسها وبكل الأسلحة الثقافية والسياسية والفلسفية والفكرية، لتواجه بنقدها، مجمل الظواهر والأفكار الجاهزة أو العمومية، من أيديولوجية إلى ثقافية وفلسفية، فكانت بحق صوتا صارخا في بريّة هذا العالم المكتظّ بالتناقضات.
تركزت جهود آرندت الثقافية والسياسية، بل ملامح فلسفتها السياسية، على تفكيك الأنظمة الشمولية، ولاسيما على النظامين النازي والستاليني، على الرغم من تناقضهما البنيوي، إذ رأت أن هذه الأنظمة أكبر خطر يهدّد البشرية، مشيرة إلى أن المبدأ الذي يوجه العلاقات بين الأفراد والسلطة في هذه الأنظمة هو الخوف، فضلا عن القوانين الأيديولوجية، قوانين "التفوق الطبيعي" في الحالة النازية على وجه الخصوص، الهادفة بمجملها إلى تشكيل إنسان فريد من نوعه، خاضع بصورة آلية، دون ترك المجال لأي فعل يتعارض مع الأيديولوجيا ومصالح صنّاعها.
لا يفوتنا في السياق العربي الإشارة إلى دعم آرندت لهجرة اليهود إلى فلسطين في ثلاثينات القرن الماضي، لكنها في المقابل وقفت ضد تقسيم فلسطين، وضد إقامة دولة يهودية، إذ رأت أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بحقوق الفلسطينيين، ودعت إلى دولة ثنائية القومية، يهودية وفلسطينية، إلا أنها قدمت دعما غير مشروط لإسرائيل خلال حربي 1967 و1973. فيمكن القول إن موقفها نابع من موقف أوروبي تقليدي كان يرى بضرورة حماية اليهود بعد ما تعرضوا له خلال الحقبة النازية، وفي الوقت نفسه فقد تنبّهت إلى مخاطر قيام دولة يهودية، وهي المخاطر التي يراها الجميع في أيامنا هذه ماثلة للعيان.
رغم أنها أيدت إسرائيل في حربي 1967 و1973، فقد تنبّهت إلى مخاطر قيام دولة يهودية، وهي المخاطر التي يراها الجميع في أيامنا هذه ماثلة للعيان
ركزت آرندت على الكثير من المسائل وأبدت رأيها بشفافية وواقعية مثل مسألة الإعلانات التجارية، حيث رأت في كتابها "الشرط الإنساني" أن هذه الإعلانات تمثل خطرا لا يقل جسامة عن الدعاية السياسية، ففي حين تؤدي هذه الأخيرة إلى خلق "عالم وهمي" يُفرض على المجتمع، فإن الإعلانات تؤدي إلى خلق "عالم وهمي" للسلع، يؤدي بدوره إلى الاستهلاك الجماهيري الذي يشوّه مفهوم العمل وتجعل الإنسان مستهلكا دائما بدلا من أن يكون فاعلا ومبدعا.
وتطرقت آرندت، بعمق، إلى الأيديولوجيا الفكرية التي ترى فيها مزيجا من العنف الذي يحتقر الحريات العامة والتنوع البشري، ولا يُنظر عبرها إلى الشعب سوى على أنه كتلة متوحدة، كتلة يمكن عبرها فبركة الإنسان والتاريخ شرط تحطيم كل محاولة مقاومة. وهنا بالذات ترى أن النخب السياسية والفكرية الشمولية لا تؤمن عموما سوى بالتطرف الفكري الذي يجافي أبسط أنواع الفكر.
وإذا كانت التكنولوجيا اليوم تهيمن على مفاصل الثقافة والاقتصاد، فإن آرندت كانت من أوائل من نبّه إلى مخاطرها، عندما اعتبرت أن التكنولوجيا لم تعد فقط نتاج جهد واعٍ لخدمة الإنسان ليبسط قوته المادية، وإنما يمكن أن تكون مفهوما بيولوجيا عرقيا يخدم الاتجاهات التوتاليتارية. وهي فكرة جديدة أهملها الكثير من الفلاسفة والمفكرين.
لكن مقاربتها الفلسفية، الخاصة والجريئة تجلت في كتابها "آيخمان في القدس: تقرير في تفاهة الشر"، بعد أن حضرت عام 1961 بتكليف من مجلة "نيويوركر"، محاكمة أدولف آيخمان الضابط النازي المسؤول عن تنظيم نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال، وخلاصة نظريتها في هذا الكتاب أن الأفعال الشريرة لا تصدر بالضرورة عن "أشرار" أو عن "وحش دموي"، وذلك بعد أن وجدت في آيخمان "رجلا عاديا محدود التفكير"، وأنه مجرد موظف نفّذ أوامر السلطة العليا. وهذا ما أشعل سجالا كبيرا في حينه، اتهمت فيه آرندت بأنها "يهودية كارهة للذات"، انطلاقا من أنها تبرر "جرائم آيخمان" وتنزع عنه صفة الشر، وهذا غير صحيح بطبيعة الحال، إذ إن ما ذهبت إليه آيخمان هو أن الشر يمكن أن يصدر عن أشخاص "تافهين" لا يتمتعون بالرؤية ولا المسؤولية الأخلاقية. وكم رأينا من نماذج كهذه حول العالم، لاسيما في أوقات الحروب.
اخترقت كل المدارس الفلسفية في القرن العشرين، بل رفضت تلك المدارس والنظريات الأيديولوجية، لأنها تنطلق من معطيات جاهزة
كما كانت آرندت من أوائل من توقف عند ظاهرة المهجرين واللاجئين، بل خصصت لهذه المسألة فصلا في كتابها "أصول التوتاليتارية"، ولا ننسى أنها هي نفسها كانت مهاجرة، فرت من بلدها ألمانيا إبان الحكم النازي، إلى فرنسا، ثم هاجرت من هناك إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن أزمة المهاجرين تكشف عن أزمة أعمق في النظام الدولي الحديث، فاللاجئون ليسوا فقط محرومين من حقوقهم القومية، بل إنهم محرومون من "الحق في أن يكون لهم حق".
وعلى الرغم من ثقافتها الفلسفية المؤسسة، صرّحت آرندت ذات مقابلة صحافية، بأنها "لا تنتمي إلى دائرة الفلاسفة"، مما حمل بعضهم على القول إن مؤلفاتها أقرب إلى النظرية السياسية منها إلى الفلسفة، لكنها في حقيقة الأمر أول مفكرة أنزلت الفلسفة من برجها العاجي، ومدارسها التجريدية إلى الواقع الاجتماعي السياسي، بل اعتبرت أن الفلسفة الغربية لم تكن بريئة تماما في سياق صعود الشمولية في القرن العشرين، وهذا يفسّر رفضها الانتماء إلى الفلسفة، استنادا إلى تأييد الفيلسوف مارتن هايدغر (عشيقها ومعلمها الأول) للنازية.
لكن الفيلسوف كارل ياسبرز اعتبر أن "النظريات السياسية التي كتبتها آرندت هي فعليا مقولات فلسفية، فالنظريات الفلسفية لا يمكن أن تخلو من عمق سياسي".
وبعيدا عن التصنيفات، فإن قراءتي لنصوصها عموما (وليس كل إرثها)، كانت متعة فائقة بالنسبة إليّ، فهي عالم ثري بالصدق والشجاعة والعمق والجدّة، اخترقت كل المدارس الفلسفية في القرن العشرين، بل رفضت تلك المدارس، والنظريات الأيديولوجية، لأنها تنطلق من معطيات جاهزة، بعيدا من الواقع.
حقا إنها امرأة حرّة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.