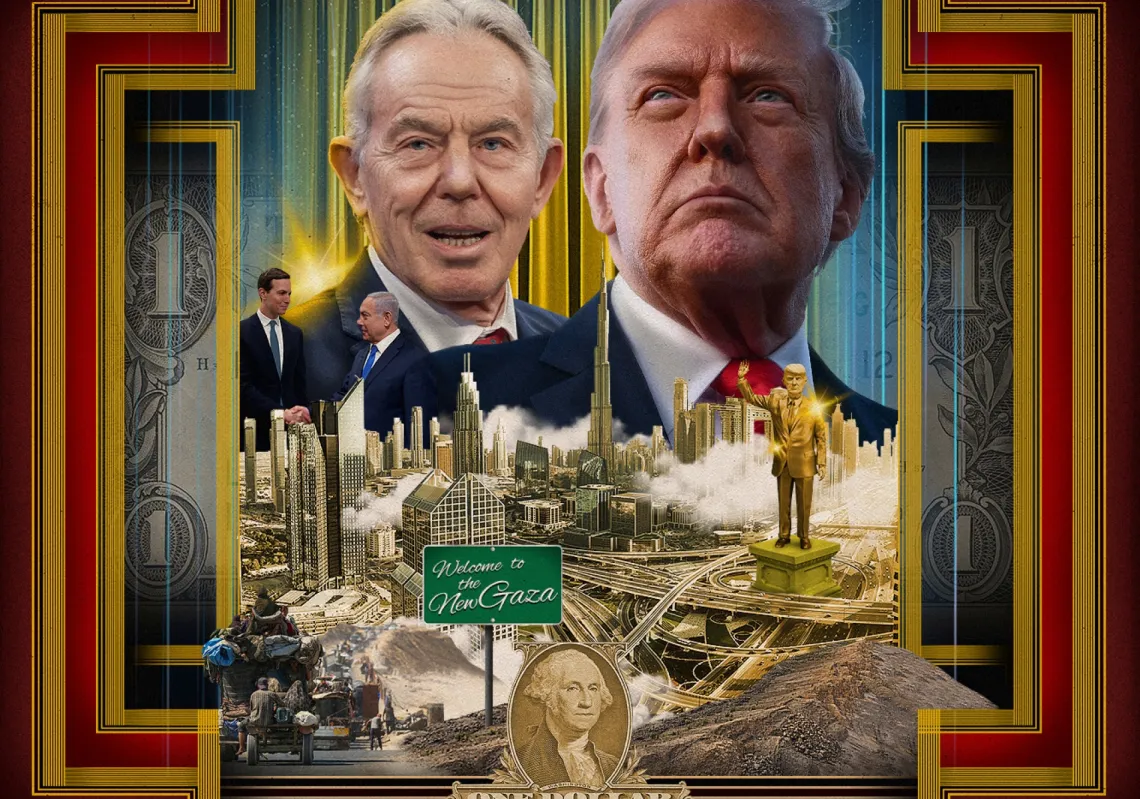مع الزخم الكبير الذي باتت تحظى به فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، يغيب عن إدراكات كثير من السياسيين والمهتمين، أن هذه الدولة كانت متاحة فعلا قبل حرب يونيو/حزيران 1967، أي طوال عقدين من النكبة، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية، التي كانت انطلقت قبل تلك الحرب، لم تطالب بإقامة دولة فيهما، الأمر الذي يبين حجم الأثمان والآلام والمعاناة التي دفعت في هذا الاتجاه، ويبين مدى قصور السياسات العربية التي تحكمت في هذا الموضوع، والذي أفاد إسرائيل.
وفي الواقع فإن فكرة الكيانية الفلسطينية، المتمثلة بدولة في الضفة والقطاع، لم تكن واضحة، أو ناجزة، طوال مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وعمرها ستة عقود، إذ شهدت الكثير من العثرات، والتحولات، وهو ما يمكن ملاحظته وفقا للتحقيب الآتي:
الحقبة الأولى، ويمكن تعيينها في العقد الأول من تاريخ نشوء "منظمة التحرير الفلسطينية" (1964-1974)، والفصائل الفلسطينية، بخاصة حركة "فتح"، ففي تلك المرحلة تم تحديد الهدف بـ"تحرير فلسطين"، ورفض كل مشاريع الكيانية الفلسطينية، أو مشاريع التسوية، التي لا تتطابق مع ذلك الهدف.
وقد يفيد لفت الانتباه هنا إلى أن هذه الحقبة يتوجب تقسيمها إلى مرحلتين متمايزتين، قبل هيمنة الفصائل على المنظمة (1964-1969)، وبعدها (1969-1974)، وأيضا، قبل احتلال إسرائيل للضفة وقطاع غزة (1967)، وبعدها.
هيمنة فكرة التحرير
معلوم أن "منظمة التحرير" تأسست قبل حرب يونيو 1967 على "الميثاق القومي الفلسطيني"، الذي نصّ على هدف "التحرير"، وأن "فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني"... وأنها "بحدودها... في عهد الانتداب وحدة إقليمية لا تتجزأ"... وأن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه"... وأن "الشعب العربي الفلسطيني معبّرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها."... وأن "تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه، مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقّه الطبيعي في وطنه".
وفي الحقيقة فإن تلك المبادئ ظلت هي المتحكمة، في الفكر السياسي الفلسطيني، كما تمثلت في مجمل قرارات دورات المجلس الوطني الفلسطيني، في المرحلتين المذكورتين (من الدورة الأولى إلى الدورة 11).
بيد أن ثمة ما يجب ملاحظته، في تلك الحقبة، هو حصول تغير جوهري في التفكير السياسي الفلسطيني، بنتيجة التداعيات الناجمة عن حرب 1967، وبعد هيمنة الفصائل على المنظمة، إذ تم تغيير "الميثاق القومي"، الذي بات اسمه "الميثاق الوطني"، وتاليا تبلور فكرة الكيانية الفلسطينية المستقلة، عبر حذف المادة (24) من "الميثاق القومي"، وعدم تضمينها في "الميثاق الوطني"، وهي كانت تنص على الآتي: "ﻻ ﺗﻤﺎرس المنظمة أﻳﺔ ﺳﻴﺎدة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ في المملكة اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ. وﻻ قطاع ﻏﺰة (التي كانت تدار من قبل مصر) وﻻ ﻣنطقة الحمّة (التي كانت تحت سيطرة سوريا)، وﺳيكون نشاطها ﻋﻠﻰ المستوى القومي اﻟشعبي في الميادين اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ والتنظيمية واﻟﺴﻴﺎﺳية والمالية".