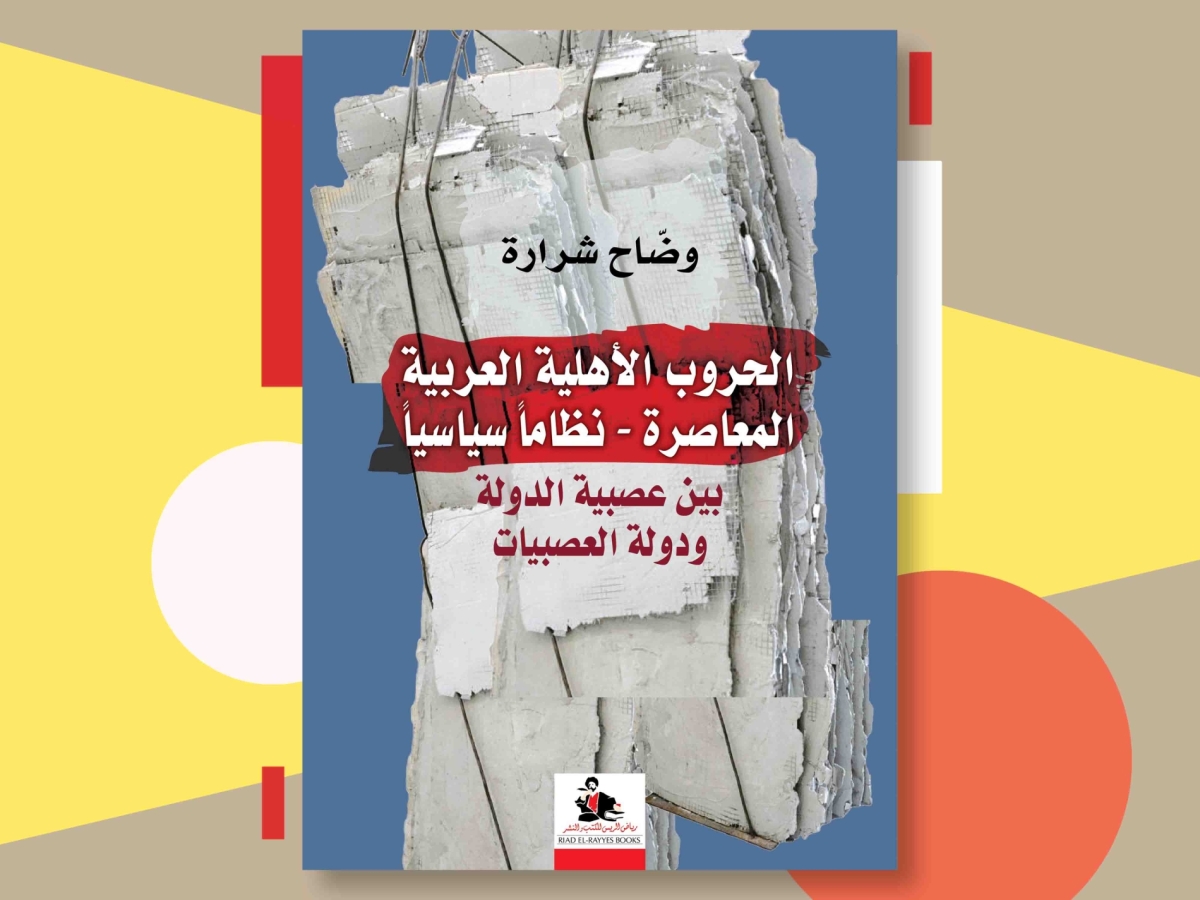لا يحاول كتاب "الحروب الأهلية المعاصرة – نظاما سياسيا" للكاتب اللبناني وضاح شرارة (رياض الريس للكتب والنشر) جرد الحروب الأهلية العربية، بقدر ما يسعى إلى إعادة تركيب المشهد من الداخل: كيف تتداعى الدولة حين تتحول إلى جهاز سلطوي منفصل عن المجتمع، وكيف تستيقظ العصبيات الطائفية والقبلية لتملأ الفراغ. الفصول هنا هي مرايا مختلفة لصورة واحدة، صورة الانهيار حين يفقد الناس ثقتهم في العقد السياسي الذي يربطهم بالدولة.
يبدأ الكتاب من سوريا، حيث تتفتت صورة "الدولة–الأمة" وتتحول إلى ولايات متنازعة، تصنعها أجهزة الأمن كما تصنعها الطوائف والانتفاضات. ومن هناك ننتقل إلى فلسطين حيث يختلط الصراع مع الاحتلال بنزاع داخلي لا يقل ضراوة، فتغدو غزة مختبرا لمعادلة السياسة والحرب معا.
يقف الفصل الثالث عند لبنان، حيث لا حرب تنتهي حقا: الرئاسات معلقة، والمجتمع أسير نظام طائفي يلتهم نفسه، بينما يقف "حزب الله" نموذجا لجهاز عسكري–اجتماعي يختزل الدولة في ذاته. أما الفصل الرابع فهو من حصة إيران، فهي الحاضر الثقيل في كل فصل تقريبا، لكن لها فصلها الخاص: بلد يختزن تناقضات الثورة والدين والدولة، من "سنة الدم" إلى احتجاجات الحجاب، ومن ظل الحرس الثوري إلى المجتمع الذي يرفض أن يختصر في سلطة واحدة.
بعد ذلك يتوقف شرارة عند العراق، بلد الازدواجيات: دولة تتفتت إلى دويلات وولايات، تغتالها القوى الصغيرة كما الكبيرة، حيث يتكرر مشهد "الكوميديا السوداء" للسيادة المستباحة. وينال السودان حصته من القراءة في الفصل السادس، إذ يدخل النص في تفاصيل جهازين توأمين يهيمنان على المجتمع، ليفضح كيف تتحول العاصمة إلى مسرح حروب دائمة، وكيف تنعكس أزمة الهوية على الخرطوم نفسها.
الفصل السابع يقف عند اليمن، مثال الحرب التي لم تعد تختزل في حدودها، بل انفتحت على البحر الأحمر وصارت جزءا من خريطة إقليمية أكبر. وأخيرا، يتناول الفصل الثامن المشرق ككل، فيقدم خلاصة شاملة: الحروب العربية جميعها ملبننة، أي أنها تكرر النموذج اللبناني بوجوه مختلفة، وتورث ما يشبه عدوى الانقسام المستمر.