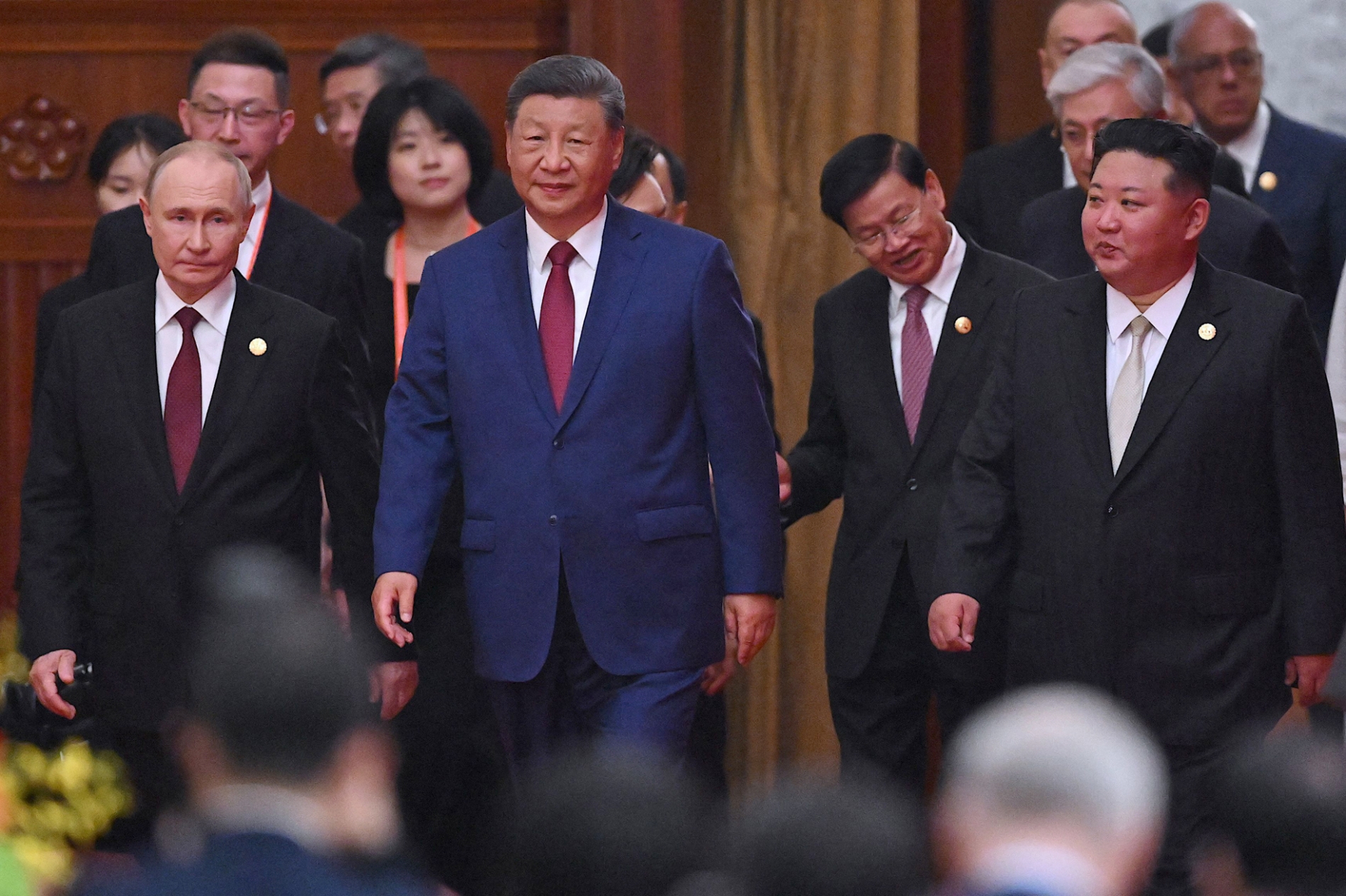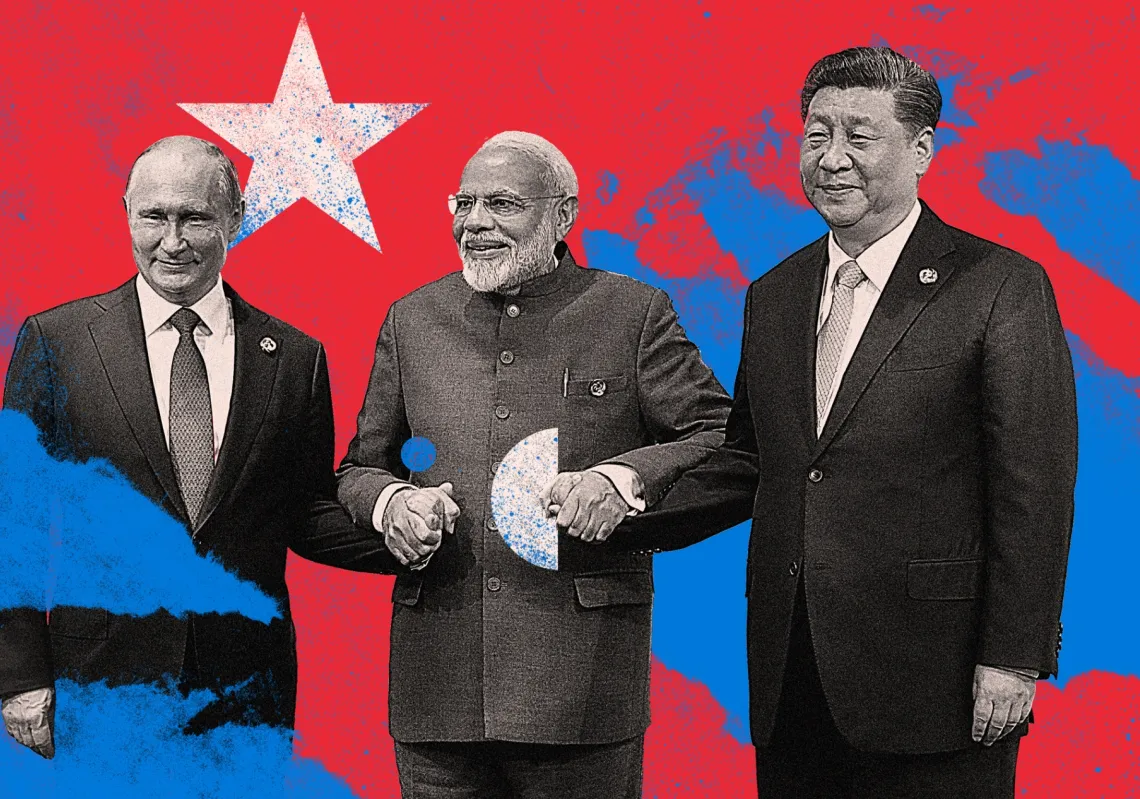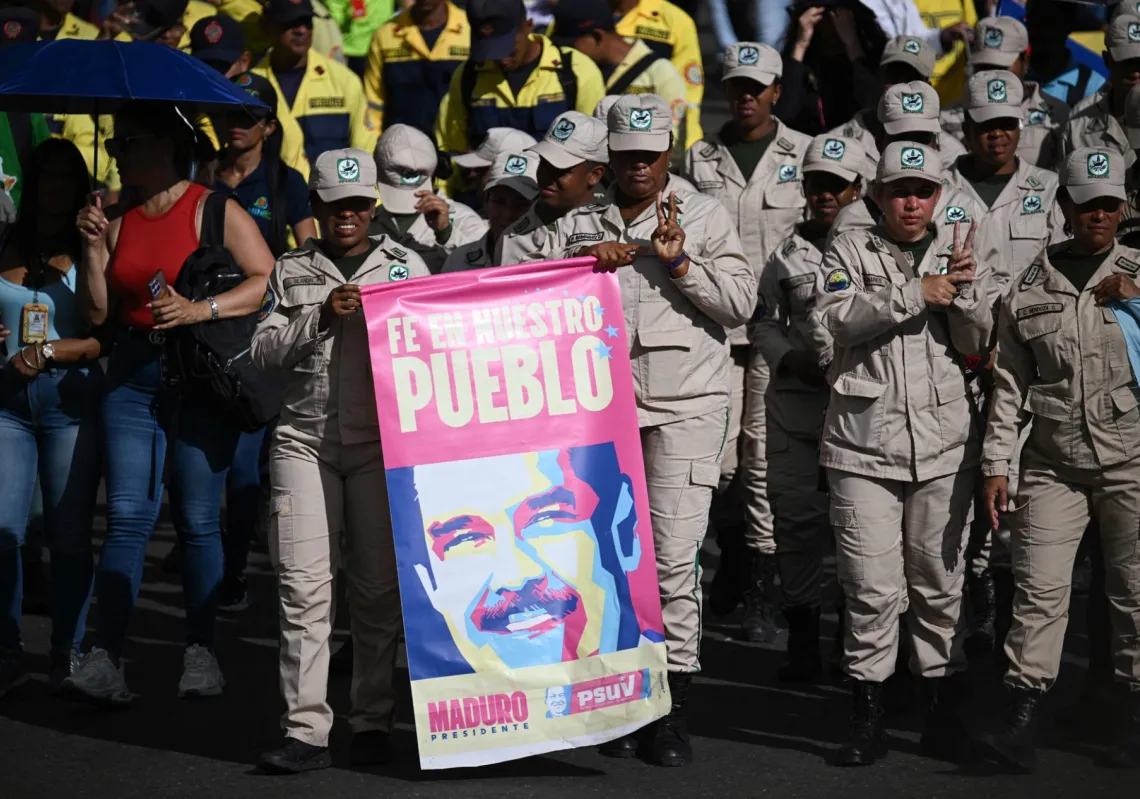لطالما شكل موضوع "الإنسان والزمن" محورا للتأمل في السياسة الدولية، ودار حوله عدد من الأسئلة التي أثارت فضول الباحثين والعامة على حد سواء.
ما العلاقة بين الفرد والعصر الذي يعيش فيه؟ هل يصنع الإنسان عصره، أم إن العصر هو من يصنع الإنسان؟ هل التاريخ قوة جبارة لا تقاوم، تفرز القادة الذين تحتاج إليهم؟ أم إن هناك لحظات فارقة يستطيع فيها شخص واحد، بقوة إرادته أو وضوح رؤيته، أن يمسك بدفة التاريخ ويغير مساره؟
الجواب ليس بسيطا، ولا ينحصر في أحد الطرفين. بل هو تفاعل معقد، آسر بين الاثنين، وغالبا ما يكون غير قابل للتنبؤ. إنها علاقة ديناميكية يتبادل فيها الأفراد والعصور التأثير والتشكيل، في عملية مستمرة من إعادة التعريف.
ولكي نقترب من الإجابة، لا بد من النظر في هذه العلاقة الدقيقة من خلال عدسة محددة: دور الشخصية في التاريخ السياسي.
قوة الشخصية التي لا تنكر
فلنبدأ بالإقرار بقوة الفرد التي لا يمكن إنكارها. فصفحات التاريخ تزخر بشخصيات تجاوزت حدود الزمان والمكان، وبدا وكأنها تعيد تشكيل مجرى الأحداث بإرادتها وطموحها ورؤيتها، بل وحتى بأخطائها الجسيمة.
تأمل الفراعنة والأباطرة القدماء: رمسيس الثاني، المحارب العظيم الذي وسع حدود الإمبراطورية المصرية، الملك الإله والبنّاء الجليل الذي نقش اسمه على الحجر ليبقى خالدا. وداريوس الكبير، الذي حكم إمبراطورية مترامية الأطراف.