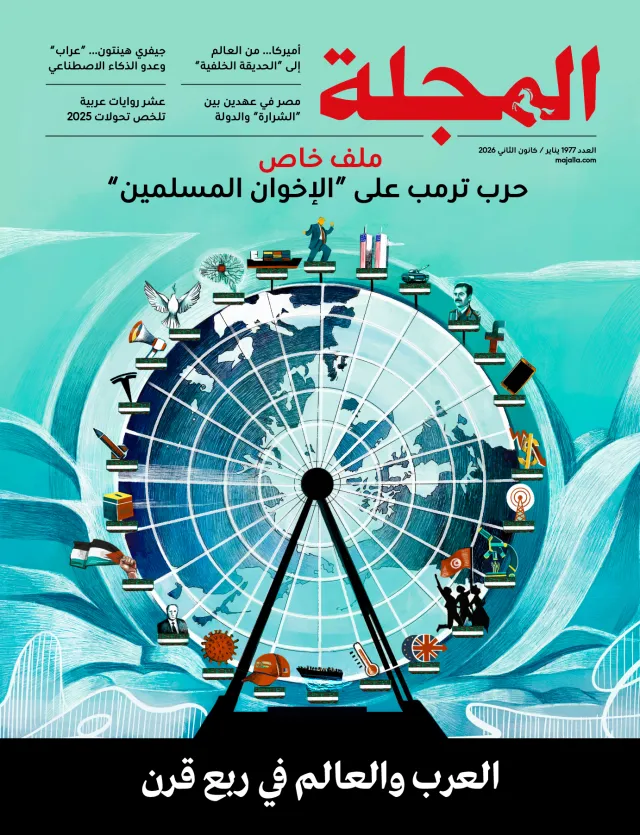ليست الحدود خطوطا ترسمها الخرائط فحسب، بل هي علامات مشتعلة في الروح، وجروح مفتوحة في جسد الهوية، منذ أن اكتشف الإنسان فكرة "ملكية الأرض" وأقام حولها سياجا سياسيا أو عسكريا، أصبحت الحدود أكثر من مجرد جغرافيا، صارت اختبارا للانتماء، ومجالا للصراع بين الذات والآخر، بين ما هو أنا، وما ليس أنا.
فمن يعيش في المدن الكبرى غالبا لا يشعر بوطأة الحدود، أما الذين يقطنون عند تخوم الأوطان، فهم الأكثر وعيا بها، هؤلاء ينامون على مسافة أمتار من الآخر، يتبادلون معه الأسواق والأغاني وربما الأنساب، ثم يستيقظون ليجدوا أن اتفاقية دولية جعلت بينهم وبين جيران الأمس خطا من الأسلاك أو نهرا محرم العبور، لذلك كثيرا ما تأتي أصوات الأدباء والفنانين في المناطق الحدودية محملة بالقلق والأسئلة، كأن الكتابة عندهم محاولة لرتق الهوية الممزقة بين جهتين.
تفرض الحدود سرديتين مختلفتين، عن المكان نفسه، فبينما يروي طرف التاريخ باعتباره حقا ثابتا، يراه الطرف الآخر اغتصابا أو نسيانا، ومن هنا يصبح الأدب الحدودي مساحة مقاومة للذاكرة الرسمية، إذ يسعى إلى استعادة القصص الشعبية والأساطير التي كانت تتنقل بحرية قبل أن تقيدها الجغرافيا السياسية، واللافت أن أبناء الحدود لا ينظرون إلى أنفسهم كضحايا فحسب، بل كجسور أيضا. هم يعيشون في أكثر من ثقافة، يجيدون لغتين أو أكثر، ويحملون في ذاكرتهم أهازيج مختلطة، هذه الهجنة قد تشعرهم بالريبة في نظر المركز، لكنها تمنحهم في الأدب طاقة هائلة على الإبداع، فالمسافة المزدوجة تمنح المبدع عينين: عين ترى الداخل بصفائه، وعين ترى الخارج بتجرده.
من هنا يصبح الأدب الحدودي مساحة مقاومة للذاكرة الرسمية، إذ يسعى إلى استعادة القصص الشعبية والأساطير التي كانت تتنقل بحرية قبل أن تقيدها الجغرافيا السياسية
ونجد للأدب العربي صدى لهذا الوجع، في بلاد الشام أو المغرب العربي أو الخليج العربي، حيث الحدود صنعتها اتفاقيات استعمارية أكثر مما صنعتها الجغرافيا، ليتجلى الإحساس بالانشطار. القبائل نفسها انقسمت بين دولتين، واللهجات تفرعت من جذر واحد، والأسواق التي كانت مفتوحة منذ قرون أصبحت تخضع لجوازات وتأشيرات، هذا التمزق انعكس على اللغة الأدبية، فامتلأت النصوص بالحنين إلى "الأرض المفقودة" أو "الأهل وراء الحدود".
وفي الأدب الأميركي، نموذج ألاسكا مثلا، أو المكسيكي عند الحدود الجنوبية، والحدود بين المدن العربية، كلها تعكس هذا التوتر، الكاتب هناك ليس مجرد راوٍ لحياة الطبيعة أو المدن، بل هو شاهد على عزلة مزدوجة، عزلة عن المركز السياسي في بلده، وعزلة أخرى عن الجار القريب الذي تمنعه الأسلاك، إلى الأساطير السياسية وحتى اللقاء الطبيعي.
هكذا يظهر في النصوص كثير من الصور الرمزية: الجدار، النهر، المعبر، الجبل، المضيق... بوصفها استعارات كبرى للانقسام الداخلي.
بلا شك يدرك سكان الحدود مدى تشابههم مع الجانب الآخر في هذه المساحة المحددة حيث كيفية تموضع النساء والرجال الذين يمارسون عيشهم وتمثيلاتهم على تغيير الحدود يوميا بعبورها، فالحدود بناء إقليمي، يحصل فيه نقل أحيانا ومن دون سيارة، لقرب المسافة، وهذا القرب من مفارقاته أن ينشأ إعلاميا بـ"نحن" و"هم"، بينما الممارسات اليومية توحي باللا حدود.
في المقابل، تسرد الروايات الأدبية الحدود بوصفها استكشافا للهوية الفردية والجماعية في مواجهة المكان والآخر، ونصوصهم هي بمثابة موضوع مركزي في تعريف الجغرافيا، بل وإظهار عدم التماثل بين الدول، والعلاقات المعقدة التي تربطها مع الجهات الفاعلة الأخرى التي تلعب دورا في مجال العمل العام، وخاصة الجيوب الإقليمية، بالاستيلاء على الأراضي، وهو شكل من أشكال السيادة التي يمكن أن تحدث دون الحاجة إلى نقل الحدود، فالحدود بطبيعتها على العكس تماما، نسيج في ثوب موحد ومنسجم.
تذكرنا كتابة الهامش دائما بأن الهوية أوسع من الخرائط، وأن الإنسان لا يختزل في جواز سفر، بل في ذاكرة تتخطى الحدود إلى الأفق المفتوح
هكذا يصبح الأدب الحدودي أدب هوية قلقة وواضحة، وأدب غني بالرموز، مع القدرة على كشف هشاشة "الخطوط"، فالحدود مهما اشتدت أسلاكها، تبقى قابلة للتساؤل، قابلة للاختراق عبر الحكاية والشعر والرواية والفن، لتذكرنا كتابة الهامش دائما بأن الهوية أوسع من الخرائط، وأن الإنسان لا يختزل في جواز سفر، بل في ذاكرة تتخطى الحدود إلى الأفق المفتوح.