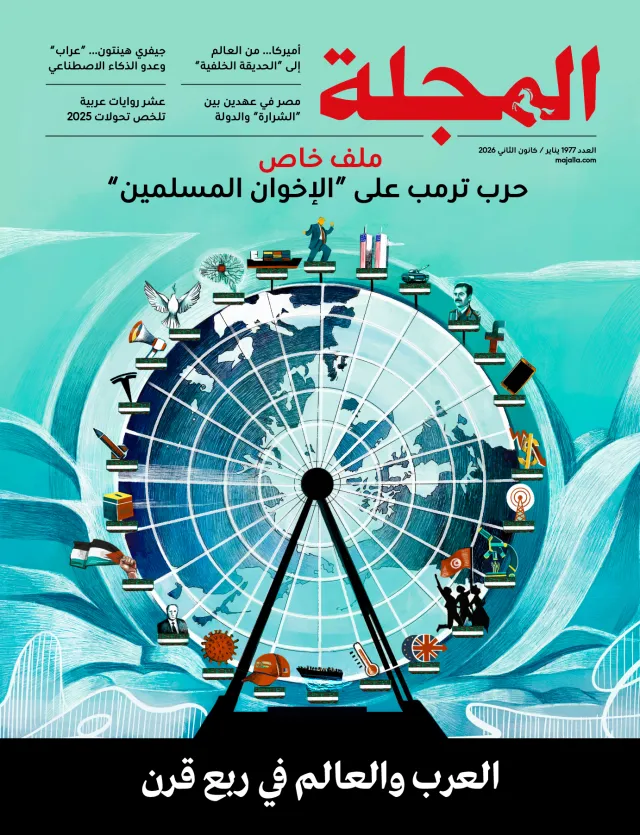في كل مقابلة صحافية أو ندوة أو حديث يطرح السؤال الدائم واللازب: "هل ثمة نقد عربي اليوم؟". السؤال هذا، متعدد الجوانب، يبدأ عمقا بمسألة اقتباس النقد العربي اتجاهات نقدية غير عربية، وينتهي بمصداقية النقد، مرورا بفاعليته. نظن أننا يجب أن نبحث أولا عن مكان النقد، أي المكان الذي تُمارس فيه الكتابة النقدية: الجامعات، المعاهد، المختبرات، المجلات المتخصصة، الصحف، المجلدات والكتب. من هذه الأمكنة، يمكن، وإن تقريبياً، تحديد ملامح هذا النقد.
المشكلة الأساسية الأولى التي يواجهها النقد عدم تواصل هذه الأمكنة التي يمارس فيها. وتاليا، عدم ترابط الظواهر النقدية المختلفة ومستوياتها وأنواعها ومفاهيمها. والنتيجة أن "لغات" نقدية عدة تتعايش معا، ولا تتلاقى، ولا تنصهر، ولا تغتذي من بعضها. وهذا ما يؤدي إلى تناثرها وتناكرها وتصادمها، بدل اكتمالها في بعضها.
في الجامعات، مثلا، وإذا أخذنا خريطة تقريبية لما يحدث في عالم النقد، هناك، نجد أول ما نجد، أن هناك غربة تاريخية، بين ما يجري في الساحة الأدبية والفكرية والفنية وما يسمى أكاديميا. هذه الغربة تتجلى في صور عدة منها تحصن الجامعات من خلال خضوعها لسياسات "الأنظمة" السائدة، بكل تابوهاتها التاريخية وغير التاريخية، ضد كل ما هو "جديد". والحكمة السائدة تكمن في إبعاد ما هو جديد وخطر ومغامر شعرا وفنا وفكرا، عن أبواب الجامعات "المصونة"، والتمسك بما هو "أمين"، و"سليم" و"معافى"، مما كرس تراثا أو مخضرما فالماضي يحكم "عقلية" و"منطق" وروح التعليم الجامعي عموما. وهذا يعني أن دور هذه الجامعات يكمن في "تلقين" "المعارف" والمعلومات وحتى المناهج تلقينا ببغائيا، منقوصا فيه النقد، ومقننة فيه التوجهات والمعلومات والمادة المدروسة نفسها. وإذا عرفنا أن وضع المناهج والبرامج يخضع، في أساسه، لظروف "سياسية"، وأحيانا "أمنية"، أو أيديولوجية، فسيتأكد لنا، كم أن "الانتقائية" التي تمارس، تبدو انتقائية مناهضة للروح النقدية الحقيقية الكامنة في حرية الاختيار، وحرية التناول، وحرية الممارسة.
النقد في الجامعات وفي المؤسسات ينفي النقد. لا نقد بلا حرية، ولا دور للنقد إذا حُصن القديم بروح القديم وحُورب الجديد باسم القديم نفسه
فالنقد في الجامعات وفي المؤسسات ينفي النقد. لا نقد بلا حرية، ولا دور للنقد إذا حُصن القديم بروح القديم وحُورب الجديد باسم القديم نفسه، وفي هذا تخلي الجامعات عن نفسها، وعزلها عن الحياة الثقافية والشارع الثقافي والهواء الثقافي. ولا نقول فقط إنها تصبح بلا دور وإنما يصبح دورها عنصرا سلبيا في تطور المجتمع من ناحية وتطور الظواهر الثقافية من ناحية أخرى، أي إنها تصبح عقبة في وجه تكامل هذه الظواهر وتأصيلها.
فعندما تستقيل الجامعات من دورها التأصيلي (الأكاديمي)، لما ينتج من شعر ومسرح وفنون أخرى وأفكار جديدة أو حديثة، فإنها تُفقد هذا الجديد المدى التاريخي الذي ينمو ويتجذر فيه، وتفقد هي تاليا، المساحة التي تحتضن فيها طموحاتها وامتداداتها إلى المجتمع والحياة والروح. وانقطاعها هذا يقوقعها ويجعلها دائرة مغلقة من التعصب البائد ومحاربة المستحدث، وعندها تصبح أكثر فأكثر عبئا، لا على النقد فحسب، وإنما على المجتمع أيضا.
إذ ماذا تنفع جامعة أو مؤسسة تنفصل عن احتمالات الواقع وعن سيرورته وعن أشكال تقدمه ومعاني هذا التقدم. الجامعات الأجنبية في أوروبا وفي أميركا، تلعب دورا محركا للاتجاهات والمدارس النقدية والفنية والأدبية كأنها مختبرات حية لكل الأفكار الحية والاقتراحات الجديدة: تدخلها في صلب مناهجها وفي صلب الممارسة التفكيرية لطلابها. بل يمكن القول إن معظم الاتجاهات النقدية الحديثة كالبنيوية والألسنية وتفرعاتهما، نَمَت وتطورت أبحاثها وتطبيقاتها في الجامعات وعلى أيدي مفكرين جامعيين كبار. فالنقد شكل من أشكال الإبداع، والإبداع بدوره شكل من أشكال النقد، واكتساب الحساسية النقدية هو اكتساب لحساسية إبداعية وتطويرها.
وهنا إما أن تشحذ الجامعات والمؤسسات هذه الحساسية النقدية، أو لا تكون، فالحساسية النقدية تصبح طريقة تفكير، وطريقة تلقٍ، وطريقة استيعاب، وطريقة مواجهة للنص، ويعني ذلك، في العمق طريقة اختيار، أي طريقة ممارسة حرية النقد، حرية قبل كل شيء، حرية تكسر كل سُقوف مفتعلة فوقها، سواء كانت سلطوية تاريخية أم سلطوية سياسية أو أيديولوجية أو طائفية والاقتراب من النص، أي نص، هو اقتراب بفضاء مليء بالاحتمالات، هو اكتشاف، والنقد أداة هذا الاكتشاف، لا يمكن أن يُقنَن سلفا وأبديا، بما هو جاهز ومفروض.
النقد في الجامعات وفي المؤسسات ينفي النقد. لا نقد بلا حرية، ولا دور للنقد إذا حُصن القديم بروح القديم وحُورب الجديد باسم القديم نفسه
الجامعات عندنا، باعتبارها (عموما) امتدادا لواقع المؤسسات السائدة، تحاول أن تمارس دور هذه المؤسسات كسلطة تحرس التابوهات التاريخية والخرافية، والأيديولوجية نفسها، وتحدد مسافة الحرية الممنوحة والمفترضة، وتحاصر دور العقل الناقد، المنقِب، الهاتك، المفكك، مكتشف العلاقات الدفينة والداخلية حتى أقصى حدودها "المحرَمة"، أو غير المحرمة. على هذا الأساس تبدو العلاقة بين المؤسسات والنص، علاقة مشوبة ومترددة وخائفة: حتى عندما تتبنى هذه المؤسسات الجامعية، نظريات واتجاهات نقدية وإبداعية جديدة، إنما تتبناها مجزوءة، مفصولة عن مناهجها الكلية.