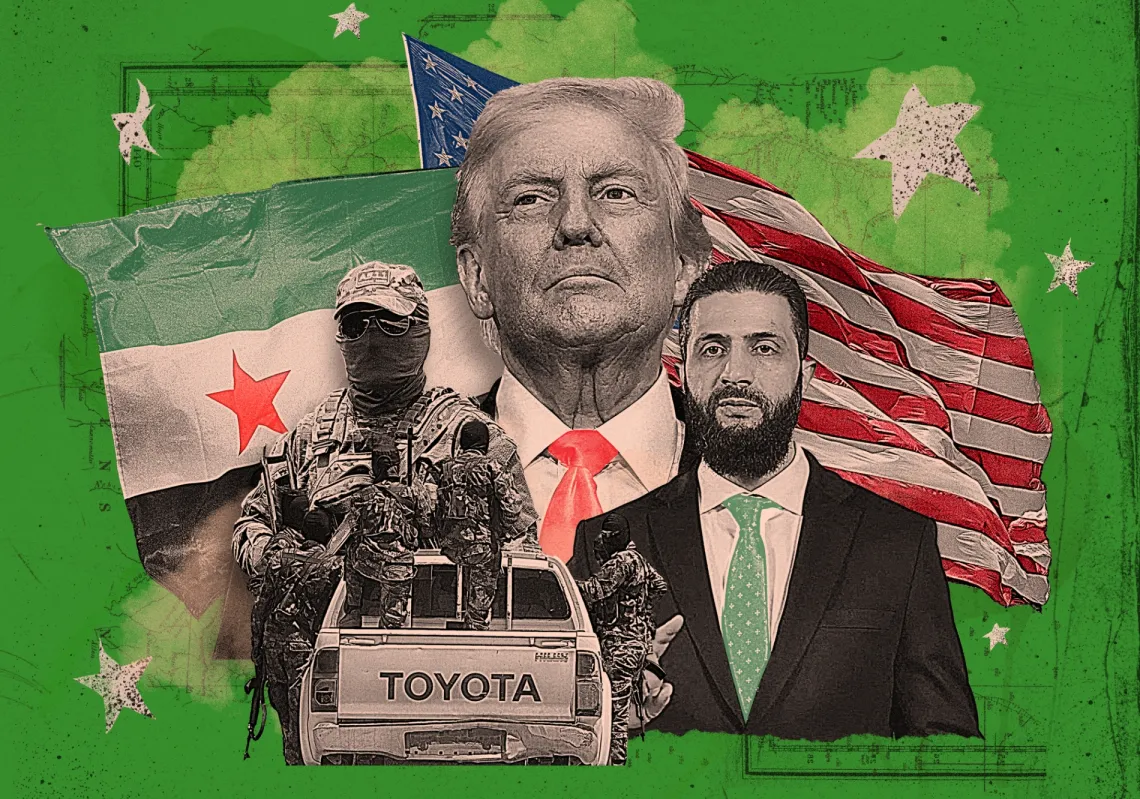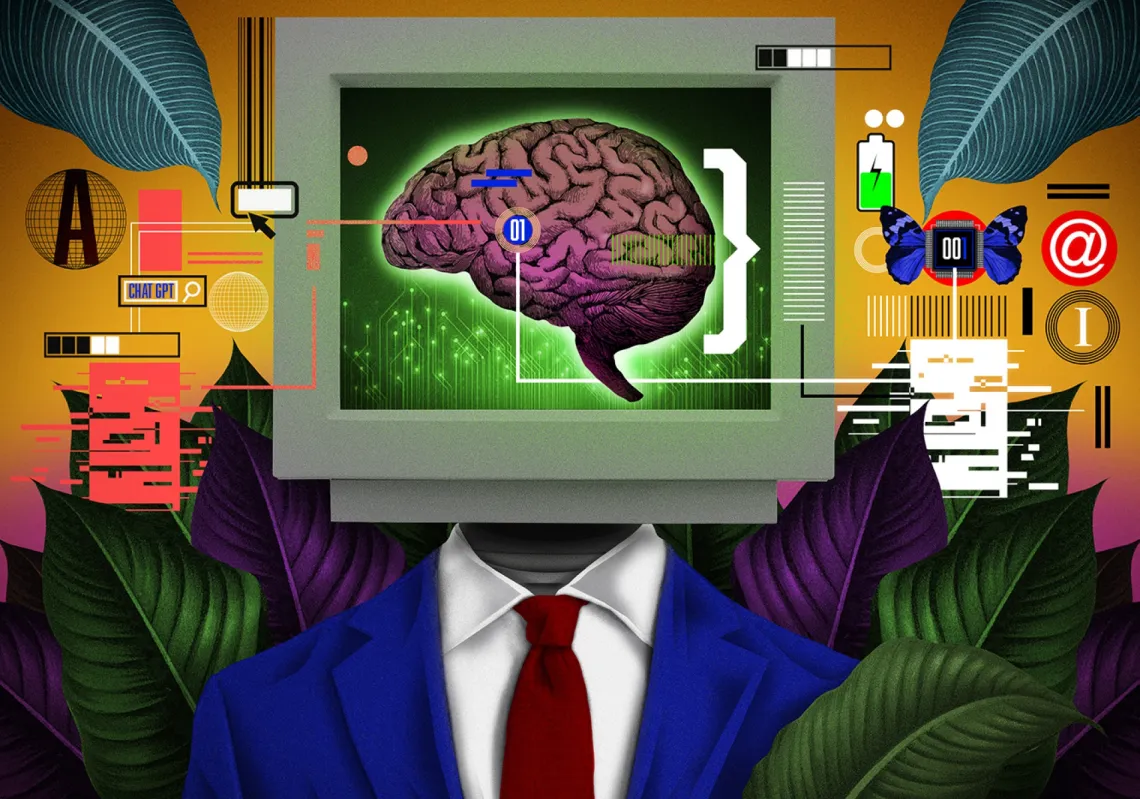غالبا ما تُعَد العقود الخمسة في تاريخ الأمم والشعوب رقما بسيطا بالنسبة لإطار زمني أطول. رقمٌ لا يؤثر بشكل جذري على قدرة تلك الكيانات على التطور والارتقاء والتعلم من التجارب والحروب السابقة، فعُمر البلدان يُقاس بالقرون وربما بالإنجازات العلمية والاقتصادية التي تُحققها.
في وضع لبنان وجمهوريته الفتية نسبيا، تُغادرنا اليوم الخمسون سنة الماضية، حيث يُصادف 13 أبريل/نيسان الحالي ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 1975–1990، والتي شكلت عبئا ثقيلا على نفسية، وذهنية وذاكرة شعب بأكمله- أو ربما شعوب- تَجهد في التذكّر وتتناسى خمسة عشر عاما من الاقتتال الأهلي. وهنا تتجلى المفارقة: إذ إن الحرب التي يُفتَرَض أن تكون عِبرة، تحولت إلى جرحٍ لا يُراد له أن يلتئم، ولا أن يُفتح.
تُصِرّ أكثرية الشعب اللبناني على رفض أهلية الحرب، وهم يعتبرون– ويؤكدون بشراسة– أن الأعوام الخمسة عشر من القتل والدمار كانت، كما خلّدها غسان تويني بعبارته الشهيرة، "حروب الآخرين على أرض لبنان"، ناسِبين السبب الرئيس وراء الحرب الأهلية إلى الوجود الفلسطيني– ممثلا في منظمة التحرير– التي استوطنت لبنان بعد اتفاقية القاهرة وأحداث "أيلول الأسود" في الأردن. إن تجهيل القاتل أو القتلة المَحليين ورفع المسؤولية اللبنانية عن الصراع من حيث المبدأ ليس خطأ جسيما لو اقترنت تلك النزعة باعتراف ضمني بالخلل البنيوي في النظام السياسي اللبناني، الذي صاغه الآباء المؤسسون لصيغة 1943، وما عُرف بالميثاق الوطني الذي ما لَبِث أن انهار ورُمِّم مرات عدة قبل أن ينهار بالكامل في 13 أبريل 1975 بعد حادثة "بوسطة عين الرمانة" التي شَكَلت الصاعق الأساس لبرميل من البارود، أو لربما براميل سياسية واقتصادية مخفيّة في أقبية الذاكرة اللبنانية الجَماعية.