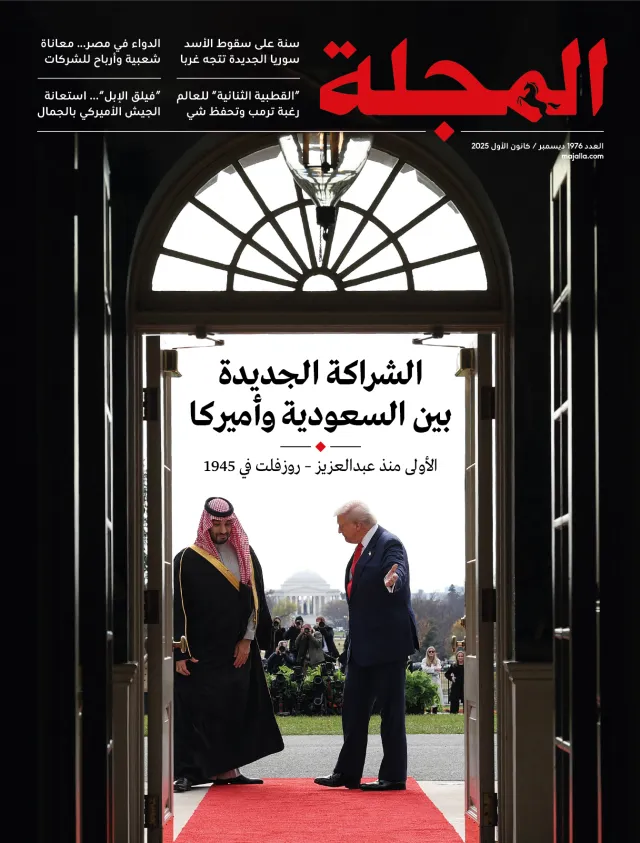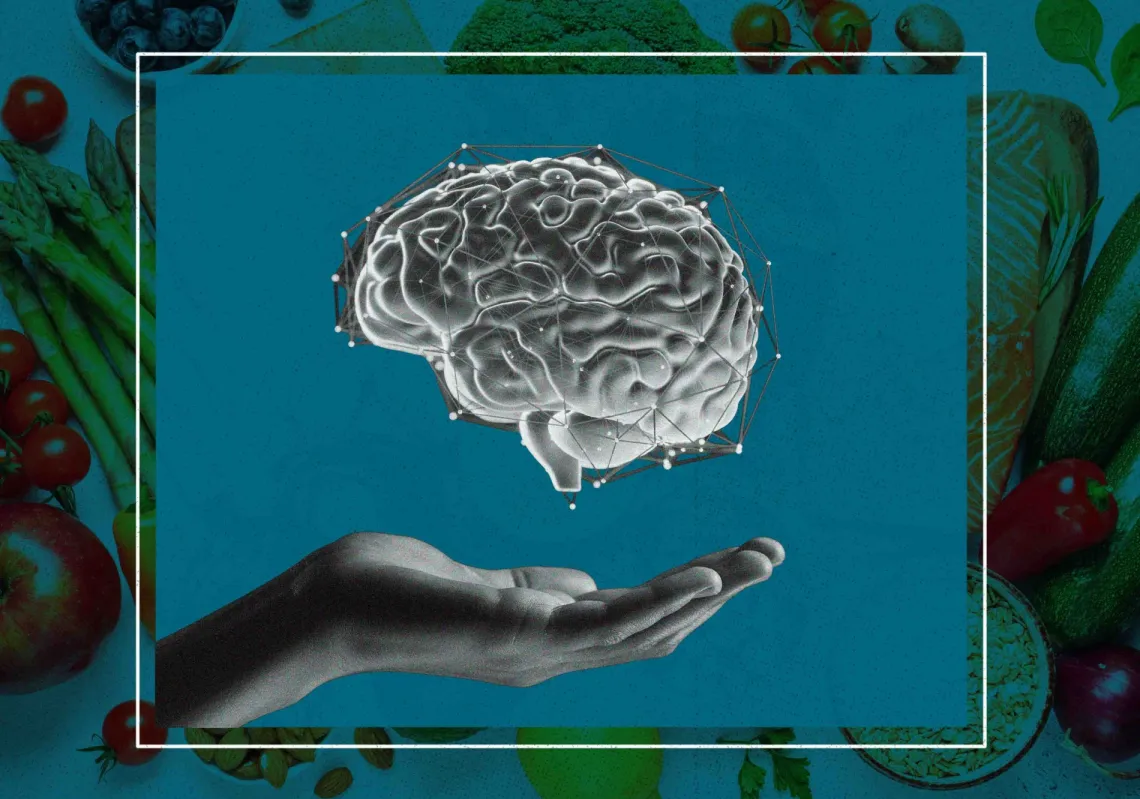من بيروت إلى متحف الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى روضة شقير (1916 - 2017)، المستوحد الساكن في حضن أجمة من صنوبر جبل لبنان على رابية أسفل بلدة رأس المتن، عبرنا طرقا متعرجة مهملة، ترك تآكل إسفلتها حفرا فيها وأخاديد. وقد نشأ على جنبات هذه الطرق عمران بري، فوضوي شرس، ويبدو بدوره مهملا وفائضا على الحاجة.
وهذا ما جعل الرحلة التي تستغرق أقل من ساعة في السيارة، متعبة مرهقة، هبوطا وصعودا من وادي لامارتين، الشاعر الفرنسي "المستشرق" المصاب بسحر الشرق أثناء إقامته بلبنان في أواخر القرن التاسع عشر، فقال إن ذاك الوادي أجمل مناطق هذه البلاد، قبل أن تصيبها لعنة يبدو أن لا شفاء لها منها. ففي ذلك الوادي حصد مسلحو حروب لبنان الأهلية في ثمانينات القرن العشرين عشرات القتلى ودمروا قريتين أو ثلاثا، ولا تزال ذكريات وآثار ذلك ماثلة هناك لم تندمل. وها لبنان كله يحتفي اليوم مسرورا بصيف مغتربيه الأسخياء العائدين لزيارة أهلهم وأصدقائهم، وللاستمتاع بأطباق المطبخ اللبناني الشهية التي صارت شهرتها عالمية، فيما ينحدر لبنان في اقتصاده ومستوى الحياة والخدمات والفساد السياسي والمالي والأخلاقي فيه إلى أسفل درك.
وفي هذا الصيف فتحت ابنة الفنانة الراحلة، الرسامة هلا شقير، متحف والدتها للراغبين في زيارته. وفي أناقته وتصميمه الطيفي وعزلته الصنوبرية، وكذلك في طبع زائريه الهادئين المترفين، وفي ذائقة من جمعت فيه أعمالها، بدا المتحف على نقيض مشاهد العمران والاجتماع اللبنانيين. وهي تلك المشاهد الغثيانية التي تصدم وترهق بفوضاها وعشوائيتها وصخبها حواس العابر على طول الطريق الجبلية إلى المتحف الجميل الأنيق. لذا احتاج الزائرون إلى وقت من الاستراحة الهادئة في فسحة ظليلة أمامه، لتبرأ حواسهم من "وعثاء" الطريق وإرهاقها بفنجان من القهوة المركزة، قبل دخولهم إلى متحف الفنانة الراحلة وحوارهم مع أعمالها، ومعها أيضا، مرفقا بشروح ابنتها التي تجمع كتابات على اعتبار والدتها "رائدة الفن التجريدي المحدث في الشرق الأوسط".
قرن الوعود الخائبة
عمرت الفنانة سلوى روضة شقير مائة سنة. لكنها لم تسأم الحياة والعمل والقلق، على خلاف قول الشاعر العربي "الجاهلي" في التصنيف المدرسي "الجاهل" والممجوج. وهو الشاعر الذي قال: "سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم". فحتى أواخر سني حياتها المائة، ظلت شقير على قلق، حسبما قالت ابنتها في لقائنا وإياها حول طاولة صممتها والدتها واستعملتها مع كراسيها في بيتها البيروتي. وها هي اليوم (الطاولة والكراسي) في متحفها، إلى جانب أصناف أعمالها الفنية الكثيرة التي استلهمت من الشعر العربي الكلاسيكي القديم الذي أحبته، شكل تدوين أبيات قصائده في كثرة من أعمالها الفنية النحتية الخشبية والمعدنية في عنوان "مثنويات"، من دون أن تغيب عن هذا العنوان أصداء شخصية جلال الدين الرومي الصوفي و"مثنوياته" الشعرية.