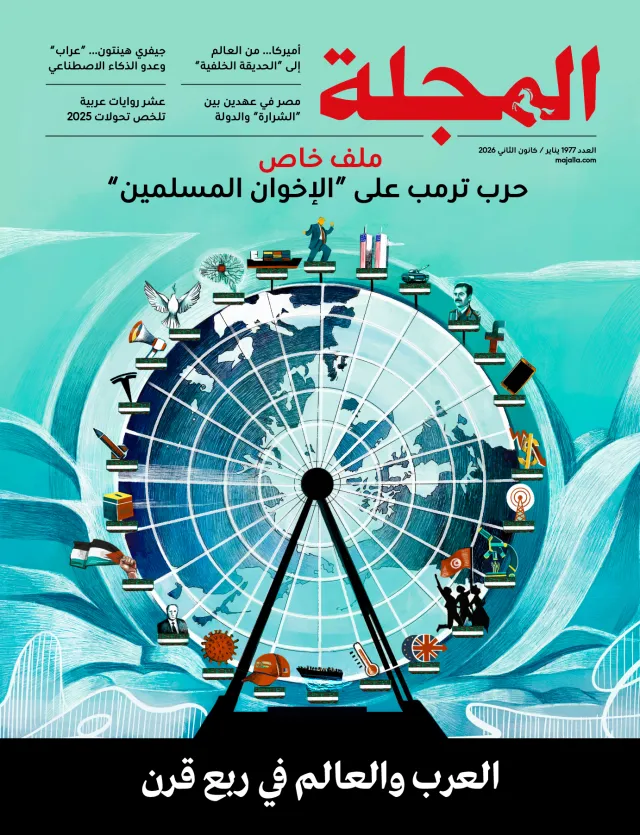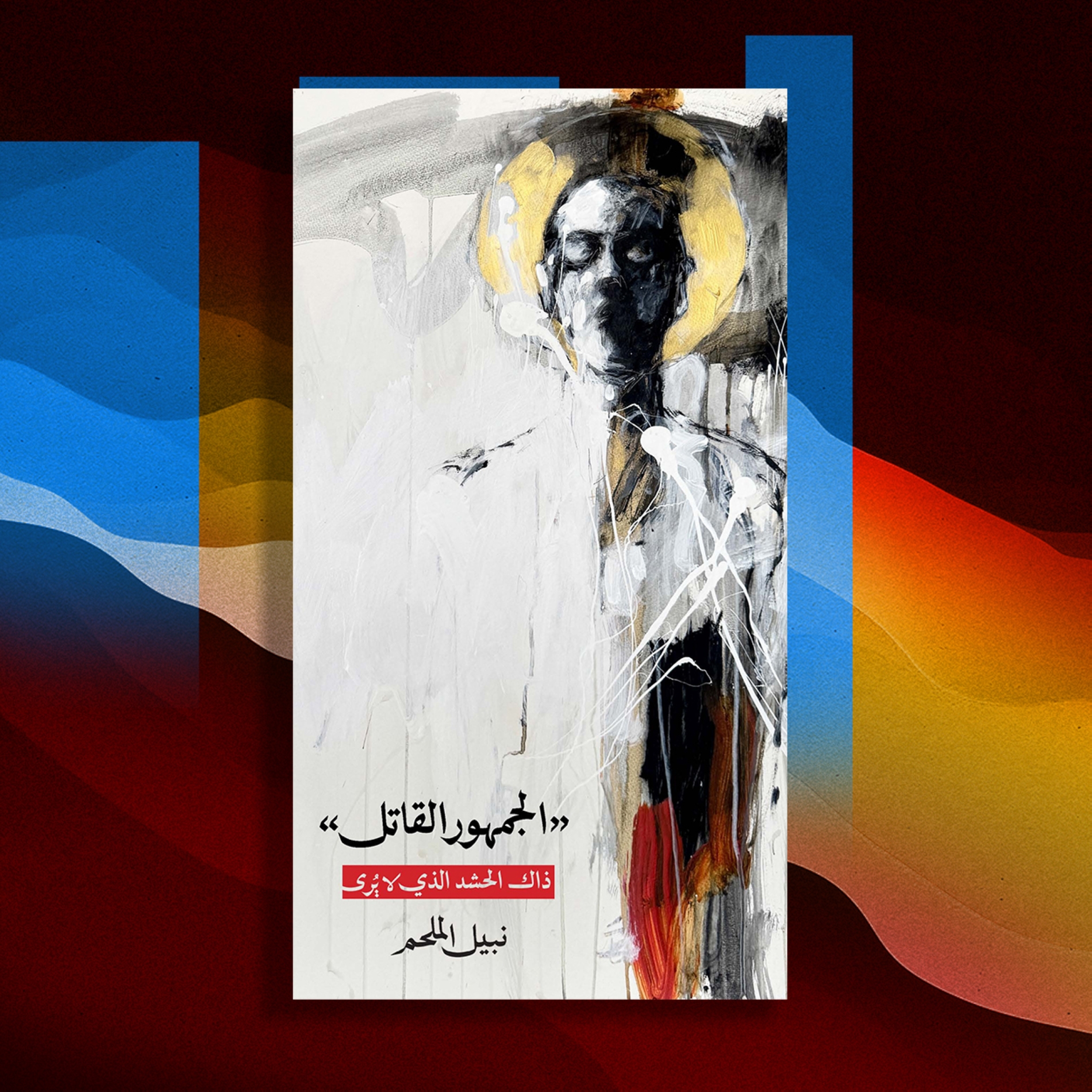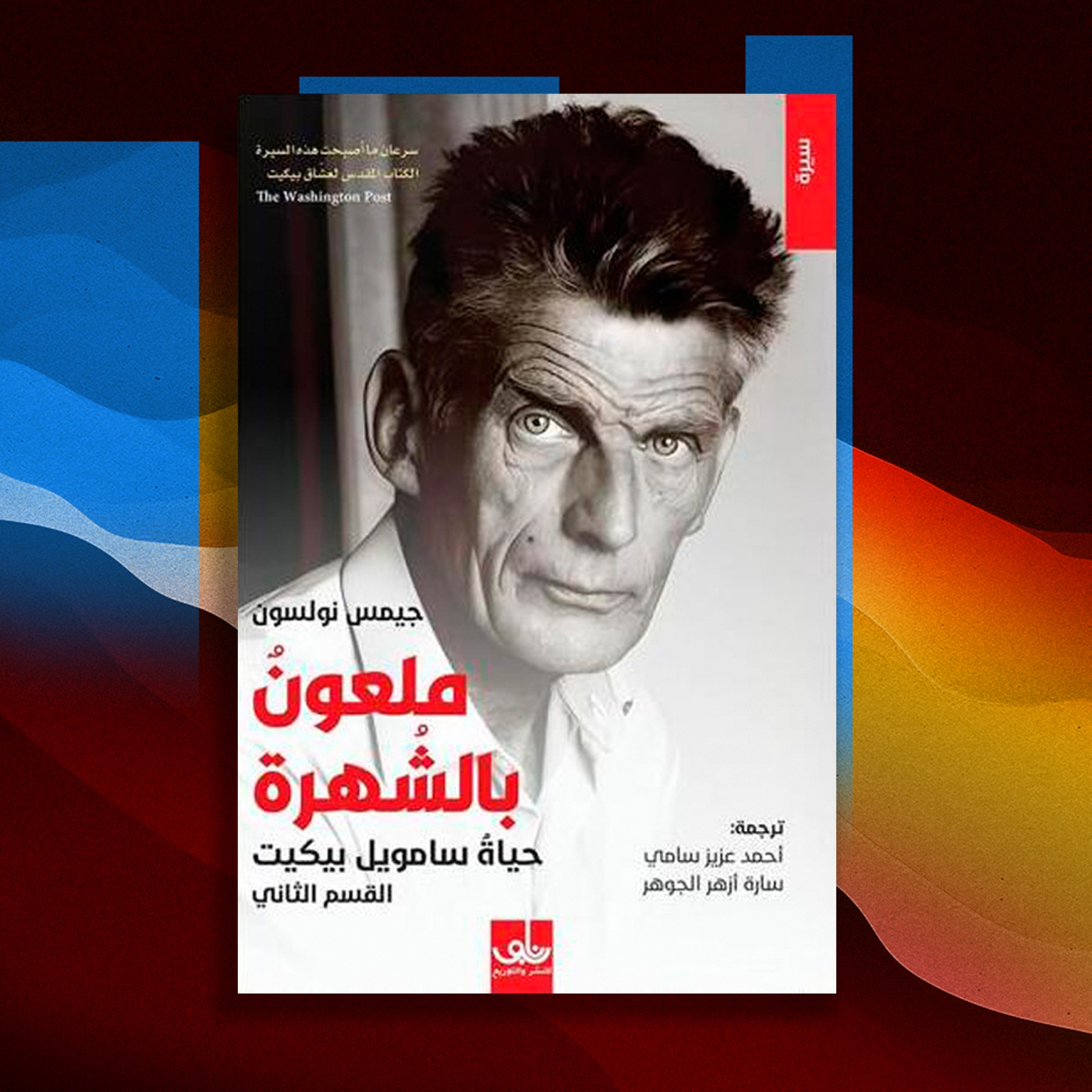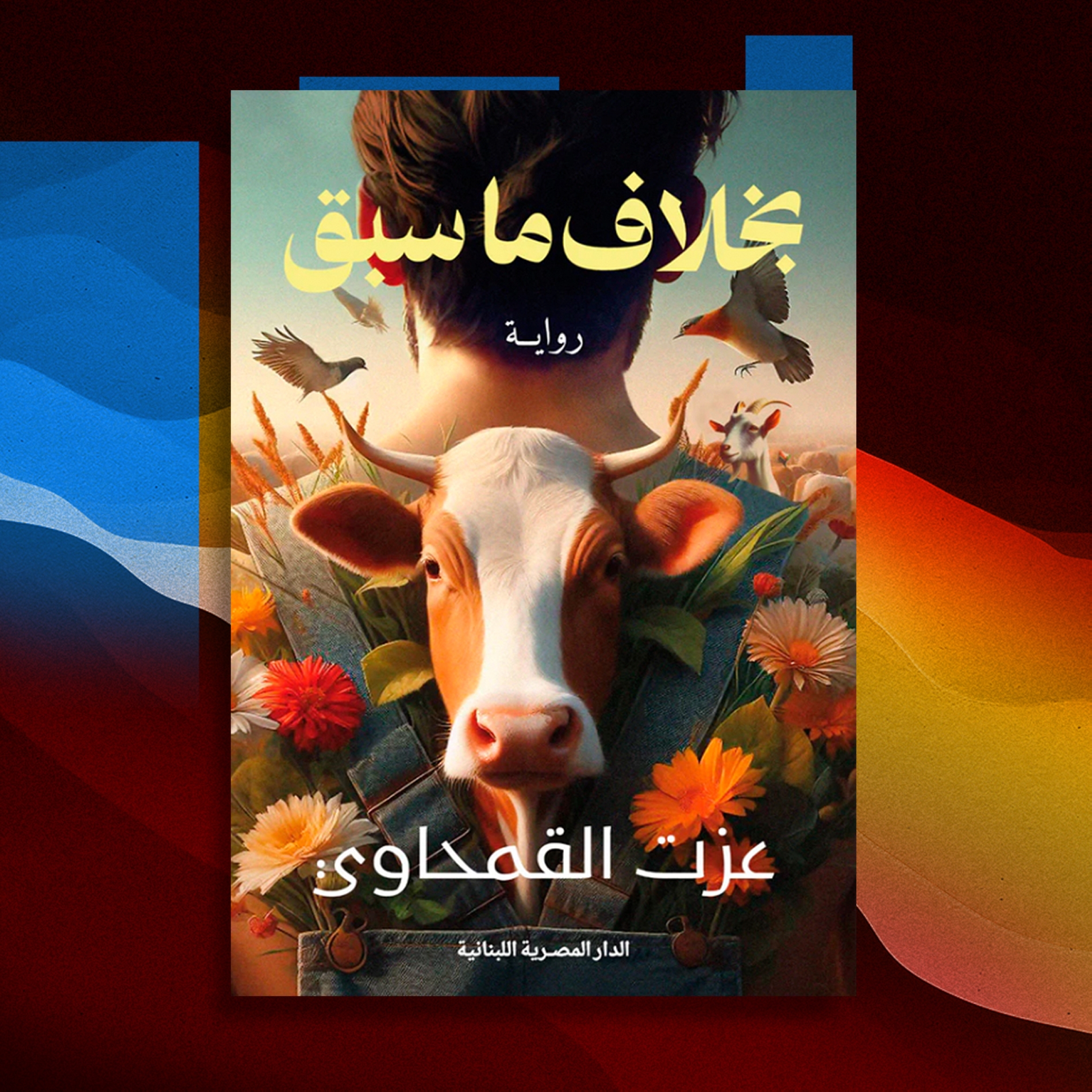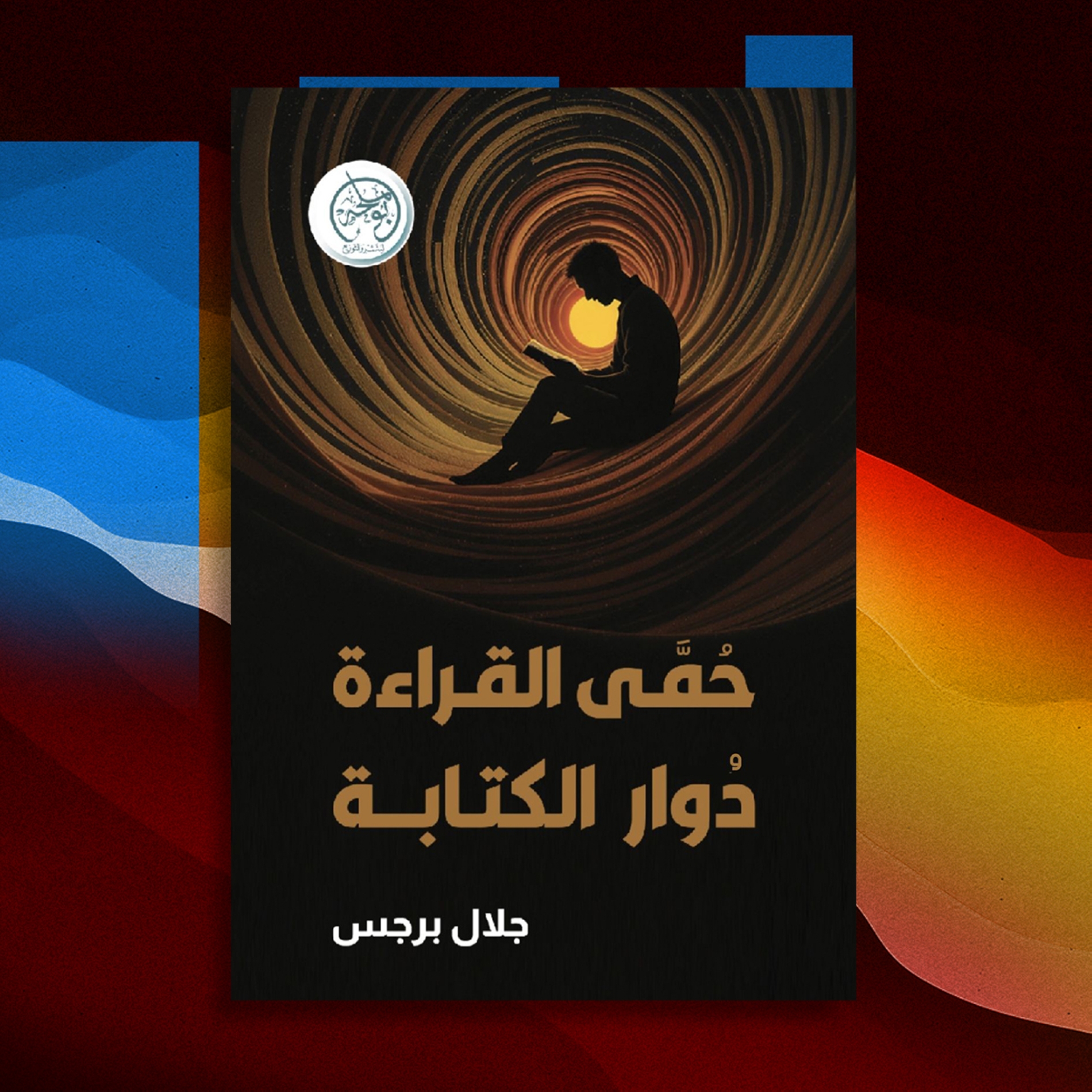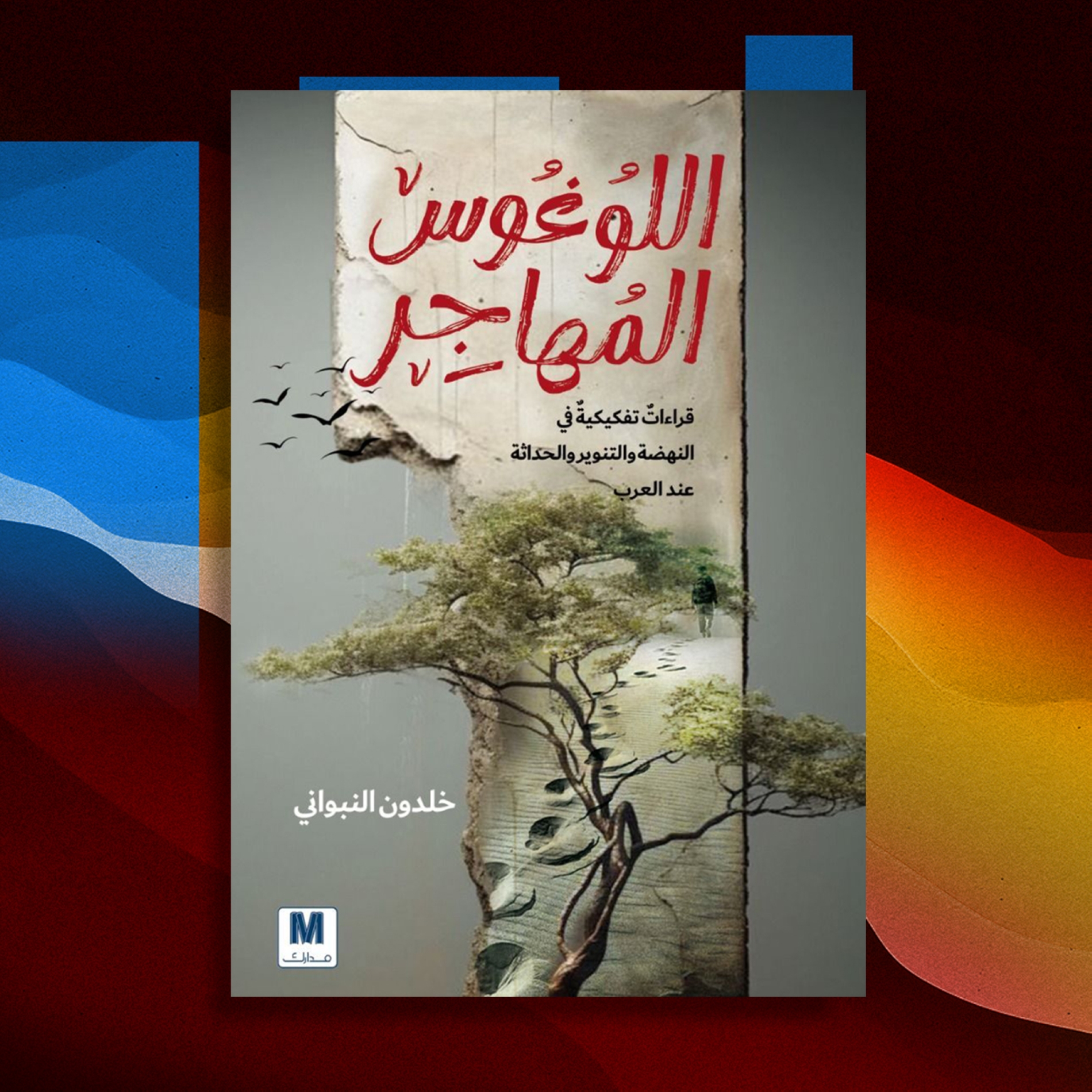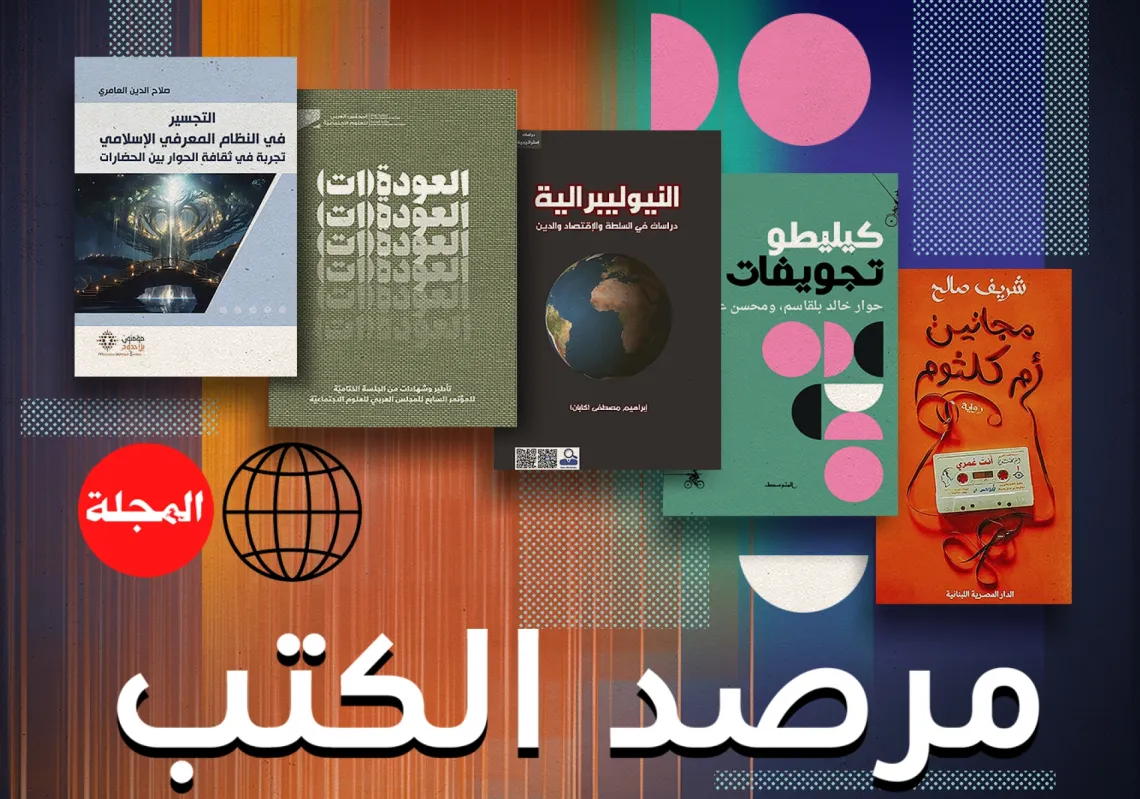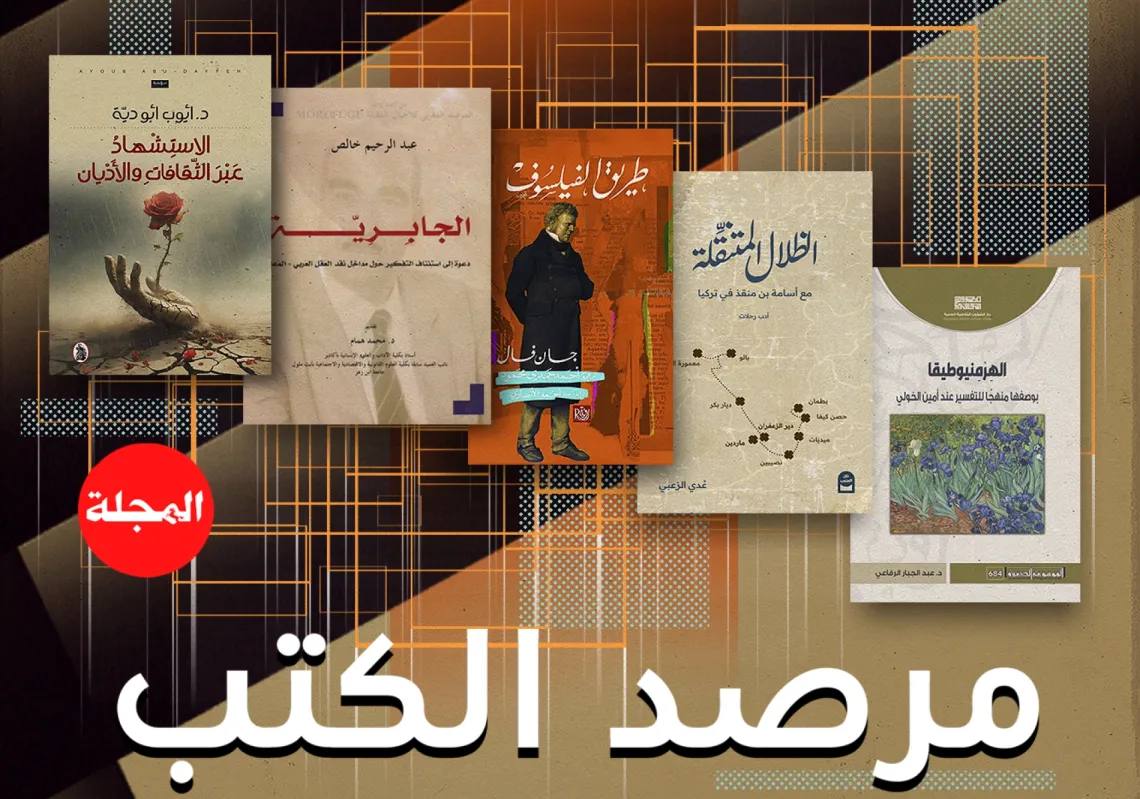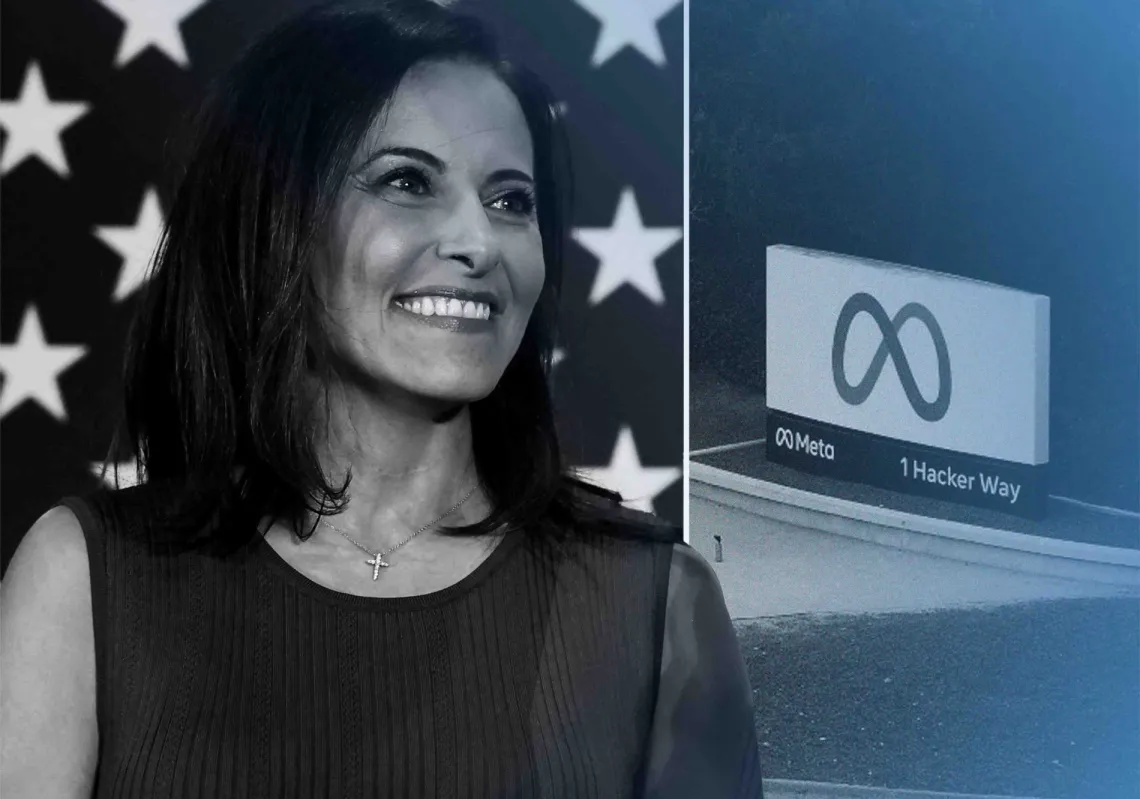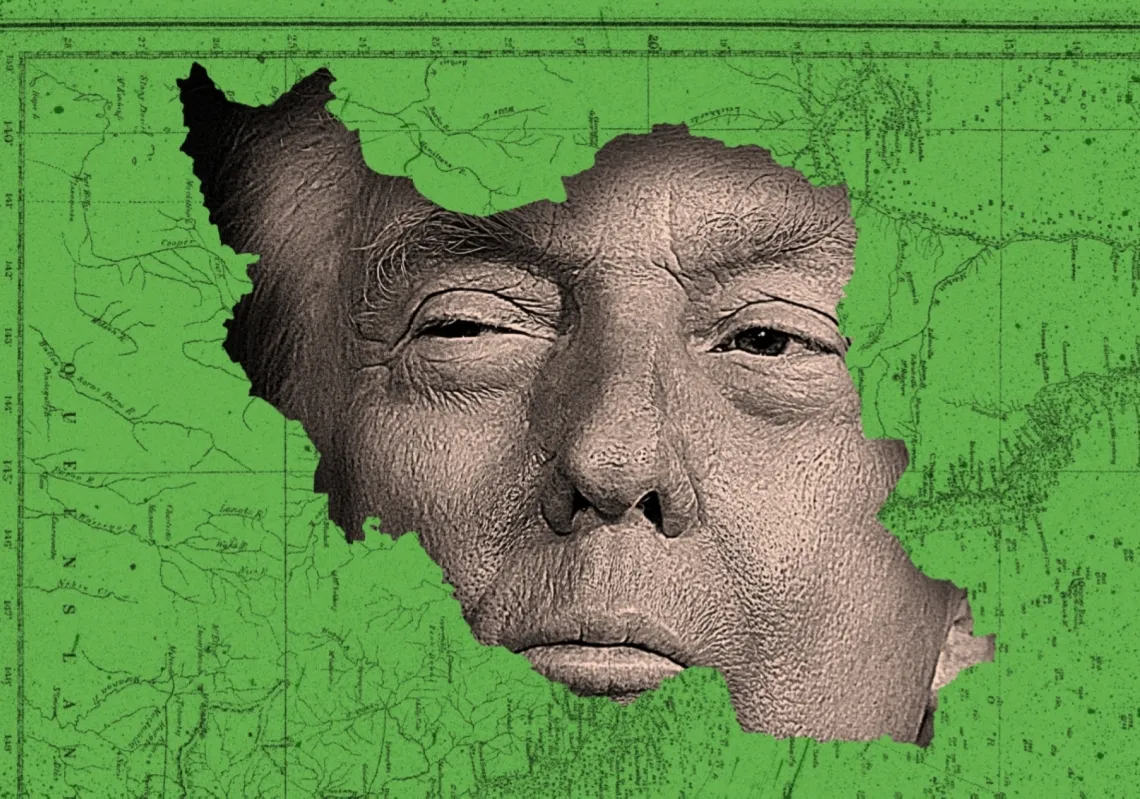نتعرف من خلال هذه الزاوية إلى أحدث إصدارات الكتب العربية، في الأدب والفلسفة والعلوم والتاريخ والسياسة والترجمة وغيرها. ونسعى إلى أن تكون هذه الزاوية التي تطل كل أسبوعين مرآة أمينة لحركة النشر في العالم العربي.
الكتاب: الجمهور القاتل – ذاك الحشد الذي لا يُرى
الكاتب: نبيل الملحم
الناشر: إصدار خاص
هذا كتاب من نوع خاص، يعتمد في طرح الأفكار ومناقشتها على التداعي وليس على منهج أكاديمي، ليس فيه أقسام أو فصول أو فهرس، بل بناء فكرته جملة جملة، وفقرة فقرة، حتى لما ينتهي القارئ من القراءة تكون قد اتضحت فكرته المركزية: كيف يتحول الناس إلى جمهور، ومن ثم إلى جمهور قاتل. كلمة "قاتل" هنا ليست مجازية، وليست رمزا عن أي نوع من أنواع القتل المعنوي أو النفسي وما إلى هنالك، بل القتل الفعلي، القتل الجسدي بالرصاص أو بالسكين أو بالحرق وما إلى ذلك. فهل القاتل هو جمهور أم فرد.
من خلال كتاب "الجمهور القاتل – ذاك الحشد الذي لا يُرى" للكاتب السوري نبيل الملحم يتوصل القارئ إلى أن العملية كلها تكمن في هذه الثنائية: جمور – فرد. حيث لا توجد فردانية في الجمهور، وبالتالي لا يوجد فرد، بل يرى الشخص نفسه ضمن الجمهور بوصفه جماعة، وهوية، بل أكثر، يجد نفسه ممثلا هوياتيا للكل. الفرد ينتمي إلى الشعب، والجمهور ليس شعبا، ومن هنا فالكاتب -كما يمكن الاعتقاد- لم يذكر في سياق الكلام عن الجمهور القاتل ولا مرة مفردة "شعب" بل استخدم طوال الكتاب مفردة "جمهور".
لرسم الفكرة يبدأ برواية "القلعة" لكافكا، ويؤولها على نحو يضع من خلاله الأساس القوي لفكرته في كيفية تحول الناس إلى جمهور وكيفية تحول الجمهور إلى أن يكون قاتلا! فيرى أن السلطة لا تظهر في هذه الرواية في صورة العرش، بل في غيابه، هي ليست بناء ماديا، بل تمثيل للمركز الغائب، للسلطة التي تتجلى عبر مؤسساتها الغامضة ووكلائها الذين لا يعرفون هم أنفسهم طبيعة المهمة التي ينفذونها. فالقلعة ليست نظاما بيروقراطيا عبثيا كما شاع في قراءات الرواية، بل هي، وفق الكاتب، منظومة تنتج الطاعة، وهذه تنتج بدورها قطيعا يخدم القلعة، ليس لأنه مرغم فحسب، بل لأن وجوده ذاته ارتبط بفكرة الطاعة لمركز لا يُرى ولا يُفهم ولا يُناقش.