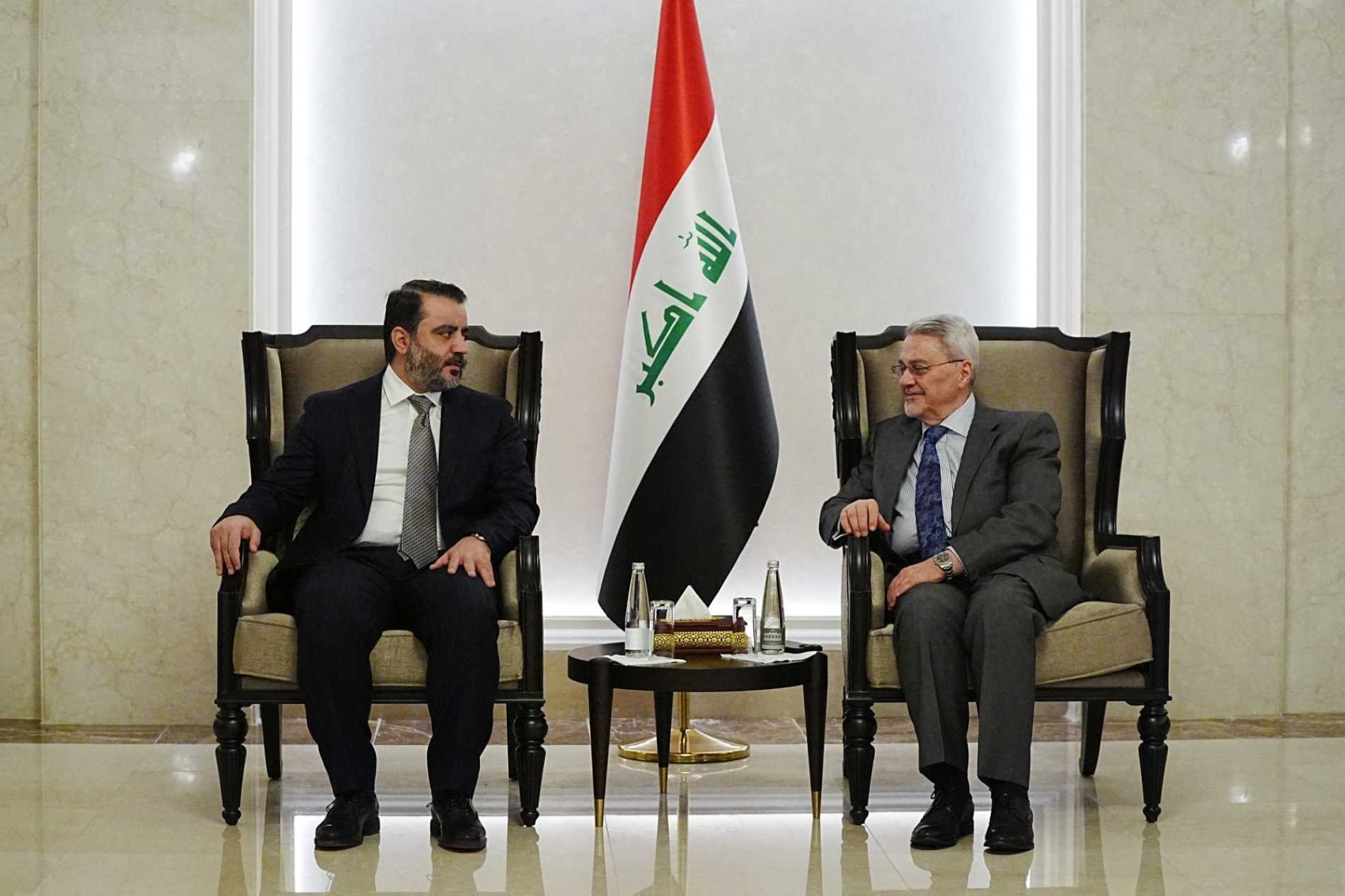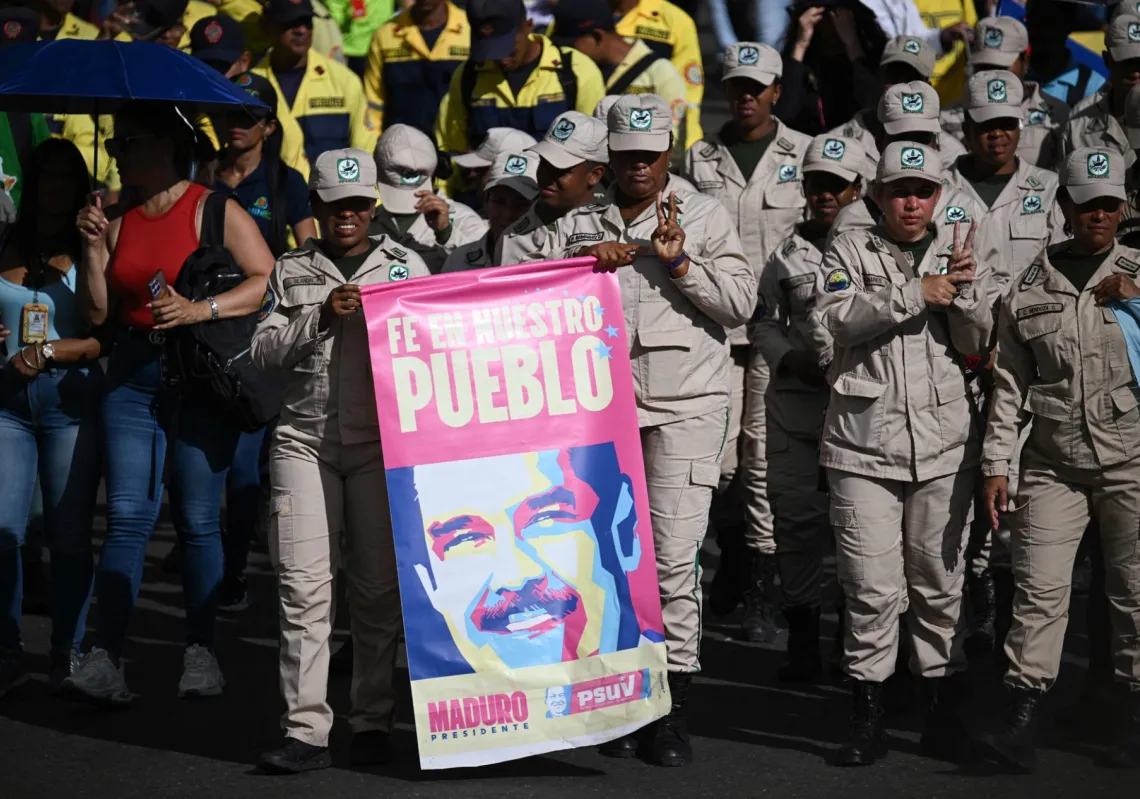لا تتمتّع التجربة العراقية، أي تجربة إعادة بناء النظام السياسي في العراق، بالجاذبية لدى السوريين، بحيث تحثّهم على التمثّل أو الاقتداء بها في إعادة بناء بلدهم، رغم حسابات الجوار الجغرافي والعلاقات والروابط التاريخية والاجتماعية والتأثيرات المتبادلة، وأيضا بالنظر لتشابه النظامين الساقطين من الجهة الأيديولوجية ومن جهة الطابع السلطوي.
أيضا، لعل ما يعزّز المقاربة السورية مع التجربة العراقية أن ثمة أوجه شبه متعددة في التجربتين، لجهة حلّ أو انهيار كل أجهزة الدولة الأمنية والخدمية والإدارية، واستئصال حزب "البعث" وأتباعه من المكونات السياسية الأخرى، وواقع التعددية الهوياتية، الدينية والطائفية والإثنية والعشائرية، ووجود جماعات ميلشياوية مع تبعيات ومداخلات إقليمية ودولية، وحال الانهيار الاقتصادي في البلدين والانطلاق من الصفر تقريبا في بناء الجمهوريتين الجديدتين في العراق وسوريا.
هكذا، ورغم كل ذلك، لا يوجد في التجربة العراقية ما يغري السوريين لاستخلاص العبر من تجربتهم، واختصار الوقت والجهد، باعتبار أن العراق تخلّص من نظام صدام حسين قبل أكثر من عقدين.
ينطبق ذلك على التجربة المصرية أيضا، بحكم وجود فوارق كبيرة بينها وبين التجربة السورية، على خلاف العراق، بإبقائها على جهاز الدولة، لا سيما الجيش والقوى الأمنية، وبذهابها للانتخابات التشريعية والرئاسية مباشرة، في حين حصل ذلك في العراق بعد عامين من إسقاط النظام، بخاصة أن تلك التجربة لم تنجح أساسا بسبب استئثار حزب واحد بالسلطة، وعدم مراعاة الشرطين الداخلي والخارجي، ما مكّن الفاعلين الآخرين من الإطاحة به.