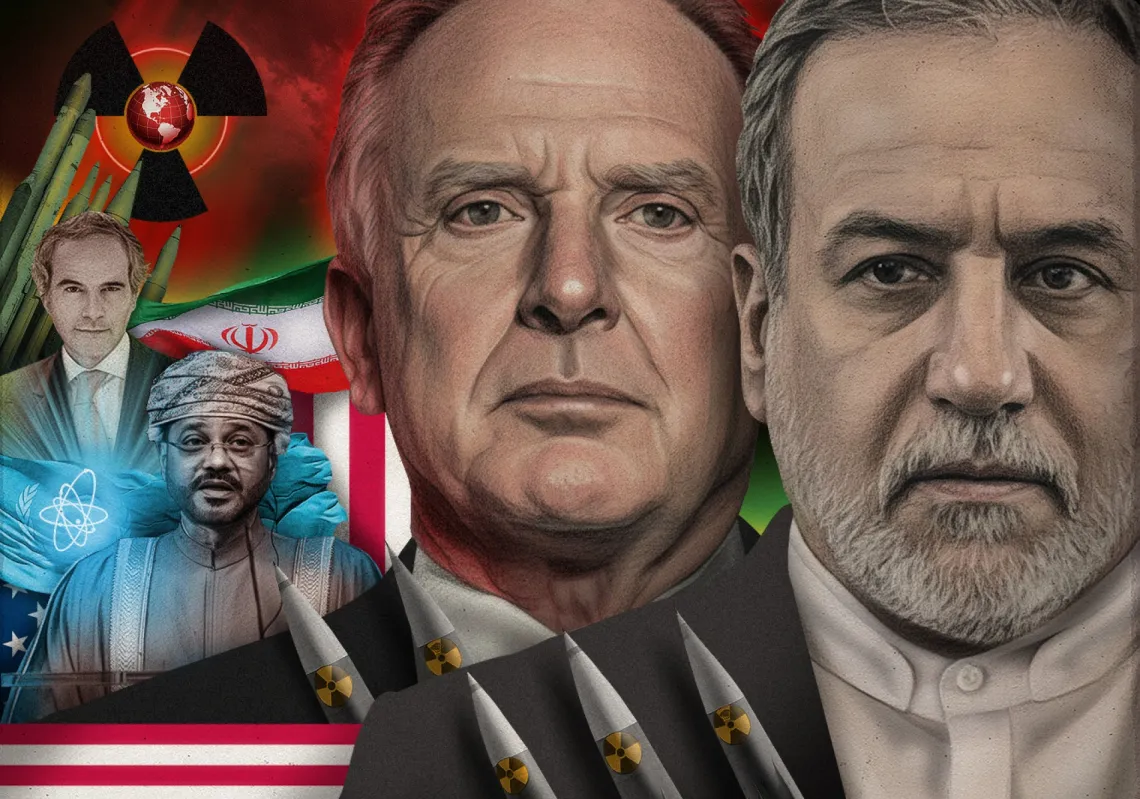من الصعب معرفة التصور المستقبلي الذي كان يكمن في أذهان قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، بخاصة المتمثلة في "فتح"، التي أطلقت تلك الحركة (1965) وقادتها، وطبعتها بطابعها وحددت خياراتها الاستراتيجية السياسية والكفاحية على مدار العقود الماضية.
بيد أن مراجعة للأفكار أو المسلمات، التي عبّرت عنها تلك القيادة في حينه، قد تقدم لنا بعضا من الإجابات على تلك المسألة، من دون إطلاق أحكام قيمية عليها وفقا لعقلية اليوم، أو تبعا لمآلات ودروس تلك التجربة الطويلة والمضنية والمؤلمة والمكلفة، رغم تأكيد مشروعيتهما بالنسبة للمستقبل.
منذ البداية كانت الفكرة المركزية، التي راودت تلك القيادات، تتعلق بتحرير فلسطين، وعودة اللاجئين، كتعبير عن رفض النكبة، وتقويض إسرائيل، التي قامت على حساب الشعب الفلسطيني.
مشكلة تلك الفكرة، على أحقيتها، أنها لم تبال بموازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، ولا بالمعطيات العربية والإقليمية والدولية، غير المواتية، وافتقاد الشعب الفلسطيني القدرة على توليد حركة وطنية مستقلة، بحكم تجزئته، وافتقاده إلى قاعدة مستقلة.
وفي العموم فقد كانت تلك نظرة إرادوية، ومتفائلة، استمدت مشروعيتها، في ذلك الزمن، من رواج حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وانقسام العالم إلى معسكرين، إمبريالي معادٍ واشتراكي مساند.
الفكرة الثانية، في إدراكات القيادات الفلسطينية، آنذاك، والتي حاولت بها استدراك ضعف حال الشعب الفلسطيني، من كل النواحي، وتاليا إضفاء نوع من "العقلانية"، على الفكرة الأولى، تمثلت بالاستناد إلى البعد العربي في تحرير فلسطين، في ذلك الزمن "القومي"، إذ إن الفلسطينيين طليعة الكفاح من أجل التحرير، وأيضا أن إسرائيل تستهدف الأمة العربية، وأن فلسطين هي القضية المركزية لتلك الأمة؛ وكلها تبينت، في التجربة، عن تبسيط، وتسرع، عدا عن أنها، حتى من الناحية النظرية، لم تكن تتمتع بحد أدنى من العقلانية، أو الواقعية.
أيضا نلاحظ هشاشة تلك الفكرة في انحسار فكرة الصراع العربي، الدولتي، ضد إسرائيل، وانفتاح مسار التطبيع معها، إذ تلاشت، عمليا، فكرة فلسطين كقضية مركزية، ومقولة إن "السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ من فلسطين".