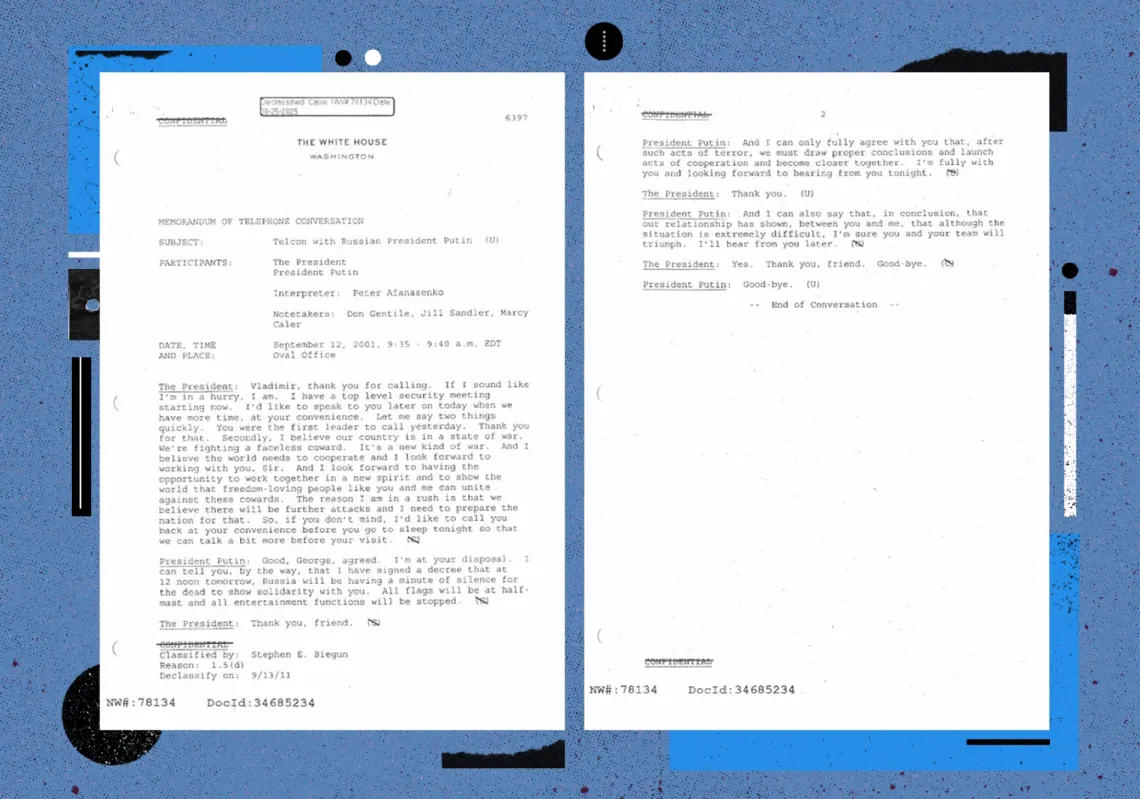في عالم لا يدفن فيه الموتى بل يعاد تأطيرهم داخل أنظمة تقنية، وتتحول الأجساد إلى إشارات، والوجوه إلى بيانات، وتعلق الآلام على شاشات مضيئة لا تنطفئ، يصبح الحزن حالة تراقب لا تجربة تعاش. بهذا التعبير المختصر يمكن تلخيص جوهر "الأكفان"، الفيلم الأحدث للكندي ديفيد كروننبرغ، الذي يحمل تجربة سينمائية امتدت عقودا في مجاهل الجسد والحضور المشوه. لكن في "الأكفان" ثمة بعض الاختلاف، فالحزن فيه يتخذ شكلا جديدا: مراقبة بلا نهاية، لصورة جثة لا تتحلل في الوعي، بل تعيد إنتاج ذاتها كل يوم.
الإنسان وصورته
تدور أحداث الفيلم بعد أربع سنوات من وفاة زوجة كارش (فنسنت كاسيل)، بيكا (ديان كروغر)، إثر إصابتها بسرطان العظام، حيث لم يتجاوز كارش خسارتها كما يتجلى لنا بوضوح في المشهد الافتتاحي الذي يظهره باكيا أثناء زيارة روتينية لطبيب الأسنان، لكن "الأكفان" ليس عملا عن التكنولوجيا أو الحداد بحد ذاته، بل عن لحظة مفصلية بين الإنسان وصورته، وتحديدا بين الجسد المادي وذاكرته، وبين موته وتمثيله، معالجا هذه المفارقة عبر حكاية رجل يبتكر وسيلة لرؤية أجساد الموتى تحت الأرض، لكنه حين يقوم بذلك، لا يجد الموتى، بل يجد نفسه وحيدا وخائفا ومرتبكا أمام هذا الحضور المبهم.
فالاختراع المركزي في الفيلم هو “الكفن الذكي”، نسيج إلكتروني يغطي الجثث المدفونة تحت الأرض ويتيح عبر عدد لا محدود من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، بثا حيا مستمرا لها. هذه الفكرة التي تبدو للوهلة الأولى أشبه بتقنية جنائزية غريبة، تصبح تدريجيا لب المشروع السينمائي ذاته. فكروننبرغ ومنذ تحفته "فيديودروم" (1983)، يتعامل مع الشاشة بوصفها جلدا ثانيا ومرآة زائفة للداخل، تلتهم الواقع وتعيده إلينا مشوها.