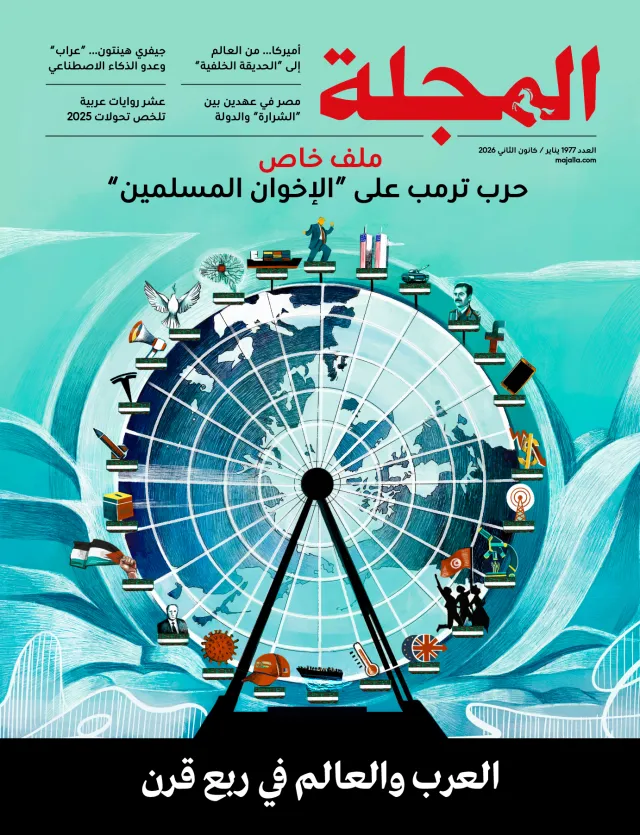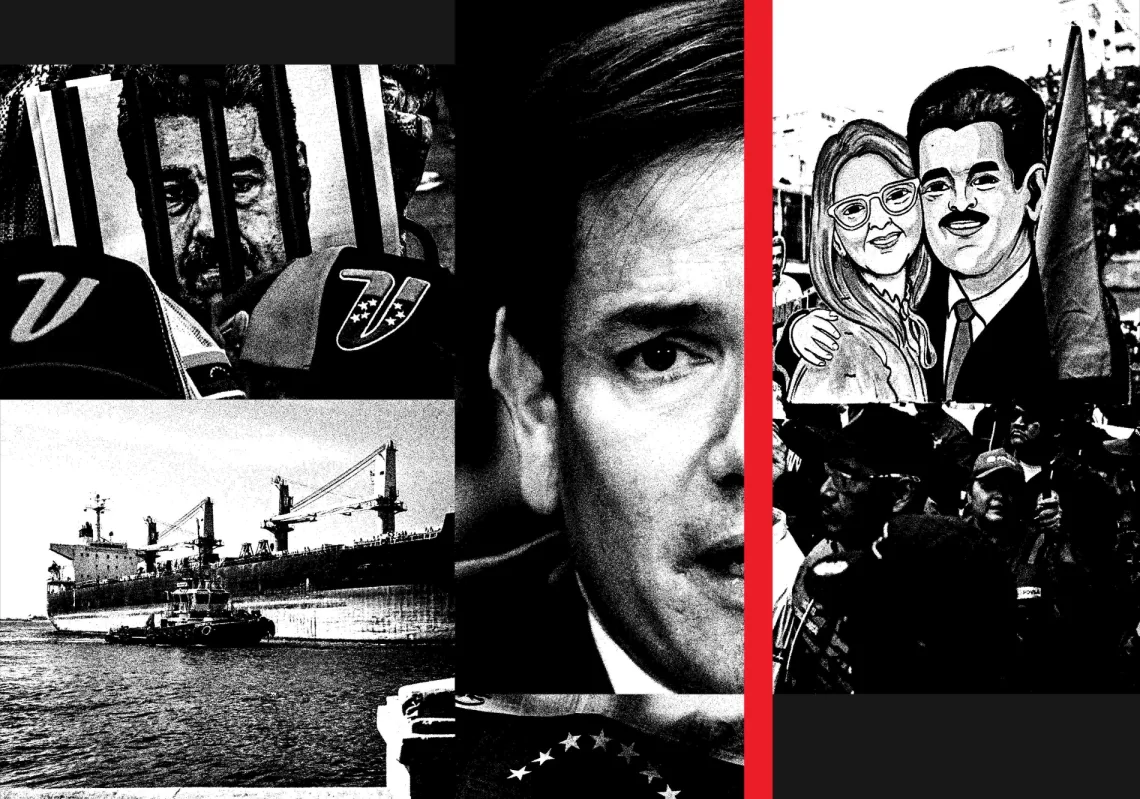لا تتناول رواية "ناي" للعراقي فخري أمين، الوقائع التاريخية من موقع الشاهد المحايد، بل هي بنية سردية، تنبني على إعادة توزيع الوعي التاريخي داخل خطاب متعدد الطبقات. قصد المؤلف أن يتماهى مشروعه السردي مع تخوم التخييل والتاريخ، بالشكل الذي لم يستدع الماضي بوصفه زمنا مغلقا، بل باعتباره فضاء مفتوحا تتقاطع فيه الأصوات والرؤى. الروائي أمين، على ما يبدو، مأخوذ بهاجس الإنصات لما يسكت عنه التاريخ الرسمي، محاولا عبر تقنية "التخييل الاستدعائي" أن يمنح المهمل والمنسي حضورا سرديا جديدا. وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال روايتيه، "أجنحة الفراشات"(2019، دار سطور) ، و"حارس المنارة"(2023، دار سنا). في روايته الأخيرة "ناي"، الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في العراق (2025)، نواجه نصا لا يعيد فقط تمثيل لحظة مأسوية من تاريخ مدينة الموصل، بل يفككها داخل فضاء سردي يشبه حقلا صوتيا متعدد الترددات.
الصوت السردي وتعدد الرؤية
في لحظة تقاطع بين التاريخ والسرد، تقف المذبحة التي وقعت عام 1933 في مدينة سميل، شمال العراق، لا بوصفها مرجعية وثائقية، بل نقطة انكسار تعيد ترتيب الزمن داخل الرواية. فالماضي لا يروى وفق خطية كرونولوجية، بل يعاد بناؤه عبر تداخل سردي يسمح لوقائع مثل قصة هروب مراد، ومأساة ماريا، أن تتوالد عبر ضمير مزدوج، هو ضمير التذكر وإعادة التمثيل معا. لأجل ذلك، يخضع فخري أمين الأصوات السردية لنظام توزيع متعدد. فالسارد يمنح الشخصيات سلطة التعبير عبر الرسائل، التي تشكل ما يسميه جينيت، "نمطا سرديا داخليا" أو intradiegetic narration، حيث تنفصل مستويات الرؤية، وتتعدد بؤر السرد (focalization). هنا ، لا تعود ماريا التي تتحول إلى راهبة، مجرد شخصية، بل تصبح صوتا تأويليا للنص، شأنها شأن حيدر، يتكشف من خلالها سؤال الهوية والاختلاف: "لأول مرة شعرت بثقل الزي الذي أرتديه، بمتطلباته ومدلولاته، ووظيفته، ونمطيته، وفاتورته التي يجب علي دفعها من ذاتي".
تقنية الرسائل التي يعتمدها أمين، تتجاوز كونها وسيلة لتدوين الحنين أو تواصل المتباعدين، لتشكل بنية سردية مستقلة، تعيد خلق الحكاية من داخلها. الرسائل تتيح لما يسميه جينيت "السرد الذاتي الزمني" (autodiegetic narrative) أن يأخذ مجراه، فنتابع من خلالها تطور العلاقة بين حيدر وماريا من جهة، وبالتوازي نعيد تأويل الحدث من وجهة نظر الداخل – الداخل الشعوري والوجودي لكل شخصية. هنا، ينقلب السرد من كونه استعراضا لما كان، إلى فعل من أفعال البوح، حيث تصبح الذات راوية ومؤولة في آن.
تقاطع الذاتي والرمزي
في "ناي"، تتجاوز الشخصيات كونها أدوات لتحريك الحبكة، وتتحول إلى فضاءات سردية داخلية، تنتج المعنى مثلما تنتجه اللغة. إذا أردنا أن نقرأ شخصية حيدر السواس من منظور "الزمن السردي"، كما صاغه جينيت، فإن لحظة دخوله إلى بيت الدعارة –تمثل ما هو أكثر من واقعة في الزمن الأول (الماضي) – فهي تشكل "لحظة سردية تأسيسية" moment fondateur، تبنى عليها بقية تأملاته وخياراته الروحية. هو ابن الوراق والصوفي، تربى في هامش المعرفة، على أطراف الكتاب. ورغم وجوده المادي في العالم، فإن مساره يتموضع داخل ما يمكن تسميته بـ"الزمن النفسي للسرد" (temps subjectif)، حيث يتقاطع الإدراك مع التجربة، والحنين مع الخوف.